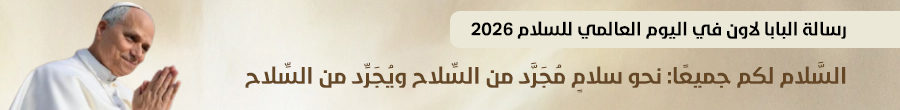موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

لقد ألمحت في المقال السابق إلى أسباب إرسال الجنود المسيحية من أوروبا إلى الأرض المقدّسة، والتي طغت عليها تسمية الحروب الصليبية وهي كانت ليس فقط إحتلال هذه الأرض من الجنود الإسلامية، بل سوء معاملة المحتل لأهل البلاد واضطهادهم بلا هوادة وإرغامهم على اعتناق الإسلام بل والأسوأ من ذلك البدء بتدنيس الأراضي المقدسة وتدميرها، كما تفعل داعش اليوم بالأماكن الأثرية التي لا تُعوّض. فتأكيدًا لمقالي أرتكز على مقال مهم للدكتور مروان المعشّر المنشور في أبونا بتاريخ أبونا 19/04/2017)
كانت كل دول الشرق قبل وصول الإسلام إليها تُدين بالديانة المسيحيّة، لكن مع وصول الجيوش "الفتوحات" الإسلاميّة فقد اختلف الوضع، بسبب الشروط الثلاثة التي فُرضت على المسيحيين وبلادهم. وهذه الشروط هي محتوى هذا المقال.
الشّرط الأوّل كان واضحًا. أَسْلِم تسْلَم. ولو أن القرآن يقول: "لا إكراه في الدّين".
يقول سيد القمني في مقال له: "في الأحداث الأخيرة، بقرية أطفيح مركز صول بشرق النيل، حدثت حالة حب بين شاب مسيحي وشابة مسلمة، وهو شأن طبيعي، فالحب لا يعرف الأديان والعناصر، فهو حالة وجدانيّة خاصة بين طرفين بالتراضي بينهما، لكنه في بلادنا يكون كارثة كونيّة تقوم بسببها الحروب وتُحرَق البلاد، فليس لدى المسلم مانعًا من ركوب مسلم لمسيحية بحسبانها سبيّة، ولأن الإسلام هو الدين الأعلى، يعلو ولا يُعلى عليه، فهو يركب ولا يُركب، وهي ثقافة الفاتح الغازي الذي يستولي على بلاد بكاملها بما عليها، ويحّول أهلها إما أتباعًا له يعتنقون عقيدته ولا يرتقوا بذلك لمستواه إنما يظلوا موالي، أي درجة من العبوديّة بين الأحرار وبين العبوديّة الكاملة، وإما عبيدًا بالمعنى الكامل في حال بقائهم على دينهم وثقافتهم المحليّة الوطنيّة، وتكون أموالهم وأعراضهم عُرضة طوال الوقت للاغتصاب بالحكم الشرعيّ".
يضيف: "ولعلّ شر أنواع الاستعمار طرأ هو الاحتلال الاستيطاني الذي يُوَطن الغزاة سادة ويجعل المواطنين الأُصلاء عبيدًا ويمحو ثقافة هذا الوطن بالتمام ويقضي على لُغَته، الوعاء الثقافي الحامل لتاريخه، ويستبدله بثقافة المستعمر لتُصبح ثقافة للوطن، ليُصبح الاستعمار ليس فقط للأرض أو الناس إنما يصل إلى الروح، وما أبشع الاستعمار الروحيّ للشعوب بين كل أنواع الاستعمار"، خاصة مقاضاتهم حسب قانونه، أي فرض الشريعة الإسلاميّة على غير المسلم وتحريم عليهم مأكولاتهم. أضف أنّه وإن قبل بإبقاء المواطن على دينه مقابل مقاضاة الجزيّة منه، لكنه لا يسمح له بممارسة دينه بحرّية... بل يُوجِد قوانينَ لصالحه هو.
فمثلاً هدم الكنيسة حسب الشريعة هو أمر سليم مئة بالمئة حسب شروط العهدة العُمَرية الشهيرة التي ذكرها ابن قيم الجوزية في كتابه "أحكام أهل الذمة"، ويحللّ لنفسه هدم ما يُستحدَث من كنائس وعدم تجديد القديم منها حتى يتهاوى ويزول مع الأيام. وفي مواقع معيّنة، خاصة في أيامنا الحاضرة، كما مع داعش والإخوان المسلمين، يرون أنهم يُقدّمون للشريعة فضلاً زائدًا بعمل لم تُقِرُّه الشريعة وهو إخلاء القرى من المسيحيين، وفرض النساء المسيحيات التحجب كمثيلاتهن المسلمات، كذلك فرض الاعتراف بتهمة تحريف الإنجيل، وكمال وصوابية القرآن، وهو ما يعني أن يُعلن الفرد إسلامه وإن ظل مسيحيًا، بإعلان سلامة القرآن واعتلال سلامة الإنجيل.
الدستور يؤكد أن الدين الإسلامي هو دين الحرية القائمة على المساواة بين الناس بالعدل حقوقًا وواجبات، دون أن يُشيروا إلينا أين نجد هذه النصوص المُقدسة، فأي دين، إسلامًا كان أم دين آخر، لا يساوي بين المؤمنين به وبين أصحاب الأديان الأخرى، وأن كل دين من الأديان الثلاثة يقسّم ويمايز في داخله ويميز بين أتباعه، وكلها تعترف وتُقر وتُقنن للقانون القديم اللإنساني بأن داخلها سادة وعبيد لا يتساويان أمام الشرائع الأرضية.
الدستور الذي يُفرق بين المواطنين على أساس الدين، ويرفع شان طائفة من مواطنيها على شأن طائفة أخرى، ويدعم دينًا من أديان مواطنيه ضد بقية الأديان، ولا يترك كل دين في الوطن يظهر بقوته الذاتية في منافسة متكافئة، هو مادة ضد كل معاني الحريات، ويغتال أساس معنى الحريات الديمقراطية التي لا تقوم إلا على المساواة المطلقة بين المواطنين، حتى أن عقيدة خاصة لمواطن واحد تستحق من الوطن كله الدفاع عنها وعنه. إن الإصرار على بقاء هذه المادة في الدستور هو هدم لكل مطالب الثورة بالحريات، وهدم لأساس أي دستور، وتكريس لعدم المساواة بين المواطنين الذي تنتفي معه فكرة المواطنة والانتماء الوطني وتُغيب لصالح ثقافة الغازي المستوطن والعبد الوطني، وفق القاعدة الأموية التي أوجدها الخليفة ردا على الوالي الذي ذهب من مصر الى دمشق يرجو تخفيف الجباية بعد أن نهكت الرعية وأفلست، أن هؤلاء ليسوا رعية و"إن هم إلا عبيدا لنا نزيد عليهم كيفما شئنا".
إنّ للارهاب والتطرف أشكال عديدة تبدأ من خطاب الكراهية للارهاب المسلح والى ارهاب السلطة وارهاب الرأي وكلها مظاهر يتوجب معالجتها بالخطة الحكومية.
الآية القرآنية: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعًا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين". البلاد ساحة للجهاد الإسلامي من أجل إعلاء كلمة الأمة الإسلاميّة وإحلال الخلافة المنتظرة والقضاء على الكفر، مع مرور الزمن. فبعيدًا عن العواطف، فقد شهد التاريخ العربي تمييزًا ضد المسيحيين، ولم تعامِل العديدُ من الممالك، خصوصًا بعد العصر العباسي، المسيحيين نفس معاملة المسلمين، ولو أن تلك المعاملة كانت أفضل بكثير مما عاملت أوروبا المسيحية المسلمين (واليهود) بعد سقوط غرناطة العام 1492 وبداية عصر محاكم التفتيش (مروان المعشر – أبونا 19/04/2017).
دروس التاريخ مهمة، لكن ممارسات الماضي تنتمي للماضي أيضًا، ننطلق منها ولا نتوقف عندها، فكما أنه مطلوب مراعاة الواقع، فإنه مطلوب أيضًا تجاوزه وتطويره. من هنا، فإن أي مستقبل مُشرق للعالم العربي لا بدّ أن يعتمد بالضرورة المواطنة والتّمسّك بالماضي والوقوف عنده هو "غباوة" وهذه الكلمة هي الصحيحة لغويًّا بدل الخطأ الشائع "غباء". المتساوية سبيلا للارتقاء بالمجتمع. هذا هو احد أعمدة الدولة المدنية الديمقراطية الرئيسية، ودون ان يدخل هذا المفهوم في صلب تشريعاتنا وأنظمتنا التعليمية كما في الممارسة على الأرض، ستبقى فئة، مهما قل عددها، تشعر انها تستطيع القيام بهذه الأعمال الهمجية (نفس المصدر). حان الوقت في الوطن العربي للعمل الحقيقي من أجل ترسيخ مواطنة متساوية في كافة الأوجه، ليس تشريعيًا فقط، وإنما ممارسة أيضًا، فذلك وحده الكفيل بإقامة شرق يليق بتنوعه وغناه.
لكن الواقع كان أليمًا، إذ فرض الفاتح شرطه الأوّل: العبور إلى الإسلام والإنضمام إلى مواطنيي الدّولة للبقاء على الحياة. فلم يجد المسيحي أو غيره خيارًا أمامه إلاّ الإستسلام وتغيير الدّين قسوة لا اقتناعًا. لا مجال للحوار ولا إمكانيّة للحريّة الدّينية (كما هي إلى اليوم في كثير من البلدان). كانت كل تلك البلاد التي احتلّها الإسلام في بداية توسّعه تدين بالنصرانية، لكن ما مضى عليها بعض الوقت إلا وعدد المسيحيين قد صار الأقليّة، من جرّاء هذا الشّرط الصّارم. هذا الأمر الإجباري دون أي جدال هو ظلم صارخ وليس تبشيرًا. التبشير بحاجة لعقول مفكّرة حرّة ينتهي إما بالقبول أو الرّفض لما يسمع من محتوى التبشير، دون معاقبة السّامع له. ففي فتوحاته لم يُعطِ الإسلام لا وقتًا للتبشير الهادئ ولا للتفكير. لذا فقد استبدل هذه الوسائل بشهر السّلاح على البلدان التي احتلّها وإرغام النّاس على الإرتداد والإعتراف الإجباري به بأسرع ما يمكن لئلا تتألّف عليه أحزاب مقاومة للوقوف بوجهه ولربما للإنتصار عليه وبالتالي التغلّب عليه وطرده. فهذا ما كان واردا في الفتوحات الأولى.
الشرط الثّاني كان الخيار بين الدّين أو دفع الجزية (بدون مبرّر) فهي عبْء على المواطن المسكين الّذي ما كان يستلم أيَّ راتب من الحكومة، بل يعيش من شغل يده فقط. وبما أنّ الحكومة ما كانت تدفع شيئًا للمواطن، لا معاش ولا تأمينات وما كان عليها له أيّ واجبات اجتماعية أخرى، فهذا يعني تجريد المواطن الأصلي من حقوقه باعتباره أجنبيًّا لا حقّ له بالعيش في مسقط رأسه كإنسان حرّ بل اعتباره مواطنًا دخيلاً لا تحق له الإقامة بدون مقابل. فمن لم يكن له وسيلة للبقاء على الحياة أسلم ومن كانت لديه موارد مادّية (كمنتوجات الفلاحة السنوية والمواشي) افتدى بها حياته وحياة أهله. ولماذا لا يجوز ذكراه؟ ففي سنين القحط والمَحْل ما كان المواطن يُعفى من الجزية بل كان جباة الحكومة يأتون إلى القرى ويقتادون أجمل الفتيات سبيًا كجزية بديلة. من هنا نشأت فكرة تدنيس عرض العائلة أو العشيرة وابتدأت مذابح الشرف وسمعة العائلة، التي لا تزال سارية المفعول إلى اليوم.
"قبل أن يبدأ مقاتلو تنظيم "داعش" حربهم الوحشية على مواطني العراق وسوريا، كان المسيحيون يعيشون لقرون طويلة إلى جانب الغالبية المسلمة في أمان وسلام، غير أن انتهاكات "داعش" التي تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعبودية الجنسية والإكراه على تغيير الدين وتجنيد الأطفال كانت واقعًا مروّعًا حمله المسيحيون الفارون من جحيم الحروب، فأصبحوا بين مطرقة "داعش" وسندان معاناة الهجرة والشتات (المطران سليم الصائغ، مسيحيّو الشرق، الجزء الثاني 1 أكتوبر 2016).
الفتوحات الاسلامية حيث كان يُقتل "المشرِكون" إذا رفضوا اعتناق الإسلام، استنادًا إلى بعض النصوص القرآنيّة كالآيتين اللتين وردتا في سورة التوبة: الآية 5: "فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم"، والآية 29: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرمه الله ولا يدينون بدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون".
يقرأ التكفيري اليوم هذه النصوص قراءة حرفيّة، بدلاً من أن يقرأها ويفسرها في سياقها التاريخي، الذي هو سياق حروب وفتوحات وغزوات. وأفصح مثال عن ذلك ما قام به "داعش" عندما احتلّ الموصل وسهل نينوى في العراق، وراح يقتّل أليزيديين على أساس أنهم مشركون، ويخيّر المسيحيين "أهل الكتاب" بين الإرتداد إلى الإسلام أو دفع الجزيّة أو الموت. وهكذا عاد إلى زمن الغزوات.
"أودّ الكلام بكل صراحة على نوع آخر من الارهاب، في معظم الدول الاسلاميّة، وهو يقوم على تهديد أي مسلم بالقتل إن أرتدّ إلى دين آخر، وذلك استنادًا إلى قراءة حرفية للحديث المشهور: "من ارتدّ منكم عن دينه فاقتلوه". في حين أن هذا الحديث يجب قراءته في سياقه التاريخي، أي أثناء الحروب بين المسلمين وأعدائهم. فالمرتدّ عن دينه كان يُعَدُّ مرتدًا إلى مخيم العدو، فيُقتل ليس بسبب تغيير دينه بل بسبب خيانة أمته. أمّا في الدين فيجب تطبيق النص القرآني الواضح: "لا إكراه في الدين"، وهذا النص يجب أن يكون أساس الحرية الدينيّة وحرية المعتقد في كل البلدان. فما الداعي اليوم إلى الحكم بالموت على من يرتد عن دينه الى دين آخر إذا رأى بموجب ضميره أنّ هذا الدين الآخر يقربه الى الله أكثر من الدين الذي ورثه من أجداده.
هؤلاء هم أرضيون فلنعطهم هذا المثل الأرضي عساه يدور في رأسهم ويبعثهم إلى التفكير المنطقي: نقول من لا يعجبه هذه الطبخة فهو لن يصوم عنها ويبقى جوعانًا بل يختار وجبة أخرى تلائم ذوقه فما يسمحه لنفسه لمَ لا يسمح به لغيره؟
وأمّا الشّرط الثّالث، الذي أرغم الكنيسة ألاّ تبقى مكتوفة الأيدي بل أجبرها لتهبّ لنجدة أبنائها فكان: أنّ من لم يقبل بالشّرطين السّابقين فكان نصيبه التنكيل به بكلِّ أنواعه وتعذيبه بل وقطع رأسه بالسّيف إلى جانب نهب النساء والصبايا، مثلما فعلت داعش في القرن الحادي والعشرين، وذلك بتزويجهن الإجباري لإنجاب بنين مسلمين ليزداد عدد المسلمين في العالم بأكثر وأسرع ما يمكن. لا تبارير دينيّة في هذه المعاملة ولا عذر. الإرغام الإجباري على اعتناق الدين هو الأسلوب البديل عن التبشير والإقناع. يمكن أنّ أضطهادات نيرون كانت أهون من هذه. صدى صراخ أمّهات الأطفال الّذين قتلهم هيرودوس في بيت لحم خوفًا على عرشه سمُع في الرّامة. وهكذا نقول صوت وبكاء شهداء الأرض المُقدّسة وصل صداه إلى روما فهبّت لنجدتهم بتلك الطريقة الإضطراريّة: النّداء إلى حرب سمّوها صليبيّة. قال العرب: ما أجبرك على شرب المرّ؟ قالوا الأمرَّ منه!
فتعاطفًا مع العالم المسيحي في الشّرق، أرسل العالم الغربي ما بين القرن الحادي عشر والثالث عشر 8 حملات عسكريّة لنجدة وحماية المسيحيين، وبالدرجة الأولى لإنقاذ الأماكن المقدّسة من الدّمار، إذ كان المحتل قد ابتدأ بتهديمها بلا تمييز لأهمّيتها، تمامًا كم فعلت داعش مع آثار التّاريخ العالمي، وبالتّالي فقد تمّ لهذه الجيوش الّتي توفي منها مئات المئات على الطّريق، جرّاء المتاعب والأمراض أو الهجومات المعاكسة، الإنتصار على الجيوش الإسلامية وتحرير الأماكن من قبضتهم.
هذه الحروب تمّت تحت راية الصّليب لذا فقد سُمَّيت بالصّليبيّة. أما حان الوقت أن نفهم أسباب قيامها؟ إننا لا نفتخر بها لكنها كانت أقلّ ضررًا لما كان سيحدث في ذلك الوقت مع الأرض المقدسة ومواطنيها وساكنيها. هذا وقد اعتذرت الكنيسة عنها مرارًا وتكرارًا، وقد قال المثل: من اعتذر عن ذنب كأنّه ما اقترفه. لكن هيهات من يُقدَّر ويفهم!
فهذا هو إذن كان هدف هذه الحروب في القرون الوسطى، المُسمّاة بالحروب الصّبيبية، الّتي يجب أن نحكم عليها بعقليّة ذلك الزّمان لا بعقليّة وقوانين اليوم، الّتي لو جرت في ظروف أو أسباب اعتياديّة لما كان يقبلها أيّ ضمير، ولكنّ النتيجة الّتي وصلت إليها، تُبرِّر التّسمية الّتي وُصمت بها، أي الحروب الصّليبية، فهي أُعلِنت باسم الصّليب لتخليص أرض المصلوب من الدّمار. لولا هذه النجدة لما بقي ذكر لا للمسيحيّة ولا للأماكن المقدّسة، فعلى نبذ الحروب التي لا يقبلها ضمير، إذا ما كان لها غاية سامية، كانت هذه الحرب إنقاذ موقف كارثي بحق المسيحيّة والمسيحيين في بلادهم. فعلى علاتها نحمد الله أنها انتهت عندما وصلت للهدف المقصود. ونفتخر بالكنيسة أنها تسلّحت بالشجاعة واعتذرت عن سيئات تلك الحرب.
للمقال تتمّة