موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
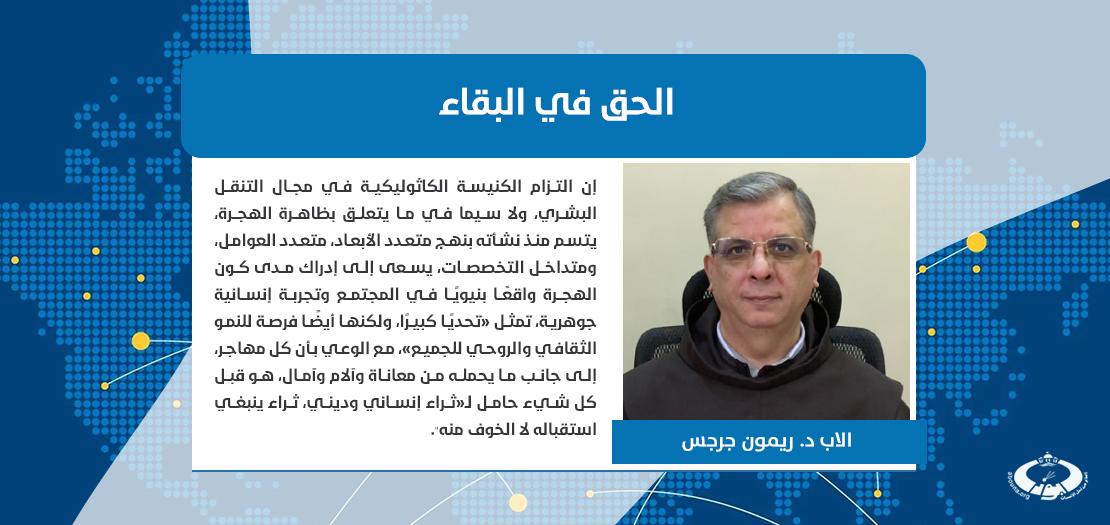
وتحتل الهجرة مكانة مهمة في اللاهوت، إذ إن المهاجرين في الكتاب المقدس يحظون بحماية خاصة داخل حدود إسرائيل، كما يُصوَّر شعب الله على أنه أمة مهاجرة. الهجرة، كما تُعرض في النصوص المقدسة، لا تُعد مجرد ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية، بل تحمل في طياتها دلالات لاهوتية عميقة. ففي الإنجيل، يتنبأ المسيح قائلًا: «سيأتي كثيرون من المشرق والغرب، ومن الشمال والجنوب، ويجلسون إلى المائدة في ملكوت الله» (لو 13، 29)، وفي سفر الرؤيا يُتأمل في «جمعٍ كثيرٍ لا يُحصى... من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان» (رؤيا 7، 9) هذه الصور الكتابية تُبرز أن الكنيسة، في مسيرتها التاريخية، تتجه نحو تحقيق هذا اللقاء النهائي، حيث تتوحد البشرية جمعاء في الله ومن خلاله. ولهذا السبب، تُعد الكنيسة الكاثوليكية صوتًا دائمًا في الدفاع عن حقوق المهاجرين.
لقد طوّرت الكنيسة الكاثوليكية، على مرّ الزمن، تأمّلاً لاهوتيًا ومبادرات عملية لصالح المهاجرين، «سواء من حيث اعتبارهم موضوعًا لأعمال المحبة بسبب أوضاعهم الخاصة من الفقر والحاجة إلى الحماية القانونية»، وبالتالي بغضّ النظر عن انتمائهم الديني، أو «وخاصةً بسبب الانعكاسات التي يتركها واقع التنقل على الحياة الدينية للأشخاص، وما يرافقه من حاجة إلى رعاية روحية خاصة»، وذلك لتفادي ما يُعرف في سياق هجرة المؤمنين الكاثوليك بـ«خطر الإيمان". وقد مكّن هذا مسار الكنيسة تدريجيًا من فهم أعمق وتفكيك أوضح لظاهرة الهجرة في ذاتها، ما أدى بدوره إلى محطات متكررة من التقييم لمجمل التوجهات، بما في ذلك الجوانب التنظيمية، والممارسات الراعوية التي تطلبت، في أكثر من مناسبة، تعديلات مناسبة وضرورية. ومن هذا المنظور، يمكن اعتبار الهجرات المعاصرة بمثابة تذكير حي وتمهيد لهذا اللقاء الإسكاتولوجي، إذ تُجسد واقعًا ملموسًا لتعدد الشعوب والثقافات، وتُحفز الكنيسة على السير نحو تحقيق الشركة الكونية، التي لا تقوم على وحدة اللغة أو الأصل، بل على عمل الروح القدس الذي يجمع الجميع في الإيمان والرجاء الواحد.
وكانت موجات الهجرة الكبرى في القرن التاسع عشر من أبرز العوامل التي تسببت في اقتلاع المهاجرين من جذورهم، ليس فقط على المستوى الإنساني والثقافي، بل أيضًا على المستوى الديني، لا سيما عندما كان الكاثوليك يهاجرون إلى بلدان ذات تقاليد دينية مختلفة، أو عندما كانوا يواجهون حالة من الارتباك نتيجة لقائهم بإكليروس وجماعات كنسية لا يشتركون معهم في اللغة أو التقاليد.
غالبًا ما ركّز اللاهوتيون، في العصر الحديث، على الحق في الهجرة ضمن أخلاقيات الهجرة الكاثوليكية. وهذا أمر مفهوم نظرًا لما يواجهه أعداد متزايدة من اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين من محن وصعوبات في أيامنا هذه. ومع ذلك، فإن القراءة المتأنية لوثائق الكنيسة في القرنين التاسع عشر والعشرين تُظهر أن "الحق في البقاء" هو الذي برز أولًا في التعليم الاجتماعي الكاثوليكي الحديث. ويعني هذا الحق أن الناس لا ينبغي أن يُجبروا على مغادرة أوطانهم.
أمّا الباباوات، فقد أبدوا اهتمامًا خاصًا بأخلاقيات الهجرة من خلال تعليمهم الاجتماعي. منهم نذكر البابا لاوون الثالث عشر (1810–1903) الذي أبدى اهتمامًا بالغًا بالقضايا الاجتماعية في عصره، وكتب عنها بإسهاب. وركّز بشكل خاص على الاضطرابات الاجتماعية الناتجة عن الثورة الصناعية، والتي أطلق عليها اسم "المسألة الاجتماعية"، مثل الفقر، والصراع الطبقي، وظهور الاشتراكية. وقد تناول العديد من هذه القضايا في الرسالة العامة"Rerum Novarum" و تعني "الأمور الجديدة".، التي تُعد نصًا تأسيسيًا للتعليم الاجتماعي الكاثوليكي الحديث. والرسالة العامة هي وثيقة يصدرها البابا موجّهة إلى جميع أساقفة الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، وتحمل وزنًا أكبر من الخطب والمواعظ البابوية نظرًا لاتساع نطاق انتشارها. فيما يتعلق بأخلاقيات الهجرة في هذه المرحلة المبكرة، لم يكن "الحق في البقاء" قد صيغ بعد بشكل صريح. لكن يمكن ملاحظة نقد البابا لأزمة الهجرة القسرية الناتجة عن التصنيع وتداعياتها المدمّرة.
فالهجرة القسرية تحدث عندما لا يكون أمام الناس خيار سوى الانتقال لضمان سبل العيش لهم ولأسرهم. وقد تنجم عن مشكلات اقتصادية، أو كوارث طبيعية، أو عنف، أو اضطهاد سياسي، أو حرب. وفي نهاية القرن التاسع عشر، كانت مجموعات كبيرة من المهاجرين تنتقل من المناطق الريفية إلى المدن. وحيثما لم تتوفر فرص العمل والسلع الأساسية، كان العديد من الأوروبيين الفقراء يهاجرون إلى الأمريكيتين بحثًا عن حياة أفضل وفرص عمل. ومن بين نتائج هذه الهجرة غير المرغوبة، يُبرز البابا غياب الرعاية الرعوية وتضرر الإيمان لدى المهاجرين. وتتناول الرسالة العامة Quam Aerumnosa تعني حرفيًا "كم هو حزين ومليء بالمشقة" لعام 1888 وضع المهاجرين الإيطاليين في أمريكا الشمالية. وتبدأ الرسالة بجملة قاتمة: "كم هو حزين ومليء بالمشقة حال أولئك الذين يهاجرون سنويًا جماعات إلى أمريكا طلبًا للعيش". أما المشكلة الأكثر خطورة التي يُحددها البابا، فهي غياب الكهنة الذين يُعزّزون الإيمان لدى المهاجرين. ويشرح البابا نطاق هذه الأزمة الرعوية قائلًا: "من بين جميع هذه الشرور، فإن أكثرها كارثية هو ذلك الذي، وسط هذا العدد الكبير من الناس، وفي بلد واسع وصعب، يجعل من غير السهل كما ينبغي الحصول على المساعدة الخلاصية من خدام الله، الذين لا يستطيعون مخاطبتهم بكلمة الحياة بلغتهم الإيطالية، أو منحهم الأسرار المقدسة، أو دعمهم بالوسائل التي ترفع النفس إلى الرغبة في الأمور السماوية، وتقوّي وتغذّي الحياة الروحية. ومن ثم، ففي أماكن كثيرة، لا يُعزّى المحتضرون بكاهن، ويُحرم الكثيرون من المعمودية عند الولادة؛ وهناك من لا يُبارك زواجهم بالطقوس الشرعية للكنيسة، ومن ثم يولد جيل جديد مثل آبائه، وفي كل مكان، بسبب نسيان الإنسان، تُقتل الأخلاق المسيحية، وتنمو الشرور بكل أشكالها". تشير معظم القضايا التي أثارها البابا إلى مهمة الكنيسة في دعم إيمان أعضائها. ويُقدَّم هذا الدعم بشكل أساسي من خلال عمل الكهنة والراهبات في الوعظ، وتعليم الإيمان، وتعميد الأطفال، والاحتفال بالقداس، وإقامة حفلات الزواج والجنازات، وتقديم الإرشاد والمشورة. وتعتبر الكنيسة هذه الأنشطة ضرورية لتغذية الحياة الروحية للمؤمنين، ومن ثم لخلاص نفوسهم.
تُشكّل هذه الأوصاف للمشكلات الروحية والمادية المرتبطة بالهجرة القسرية الأساس الذي سيُبنى عليه لاحقًا صياغة "الحق في البقاء". فإذا كانت أوضاع المهاجرين أسوأ من أوضاعهم في إيطاليا، سواء من حيث نقص وسائل العيش أو ضعف الرعاية الروحية، فإن الهجرة تبدو طريقًا غير مرغوب فيه وظالمًا. فهناك العديد من الخيرات الأساسية لازدهار هؤلاء المهاجرين تتضرر خلال عملية الهجرة، مثل الروابط الأسرية، وفرص العمل، وخاصة التغذية الروحية. ويبدو أن الناس لا ينبغي أن يُجبروا على مغادرة أرضهم في مثل هذه الظروف. وهنا تظهر بذرة "الحق في البقاء". وفي مراحل لاحقة من تطور هذا الحق، ستُصاغ هذه الأفكار بشكل صريح من قبل الباباوات، لكن في هذه المرحلة الأولى تبدأ هذه المفاهيم بالتشكّل ضمن نقد البابا لمشكلات الهجرة. وتُعرض رؤية مشابهة لمشكلات الهجرة مرة أخرى في الرسالة العامة المهمة Rerum Novarum لعام 1891. في هذه الوثيقة البابوية، يُعرب البابا عن قلقه بشأن "المسألة الاجتماعية"، أي حالة فقر العمال وانتشار الاشتراكية نتيجة لذلك. وفي الرسالة، يدافع البابا عن حق الملكية، ويدين الاشتراكية والرأسمالية غير المنضبطة، ويدعو أصحاب العمل إلى دعم عمالهم. وفي القسم الذي يتحدث فيه البابا عن أهمية حماية الملكية الخاصة وتعزيزها كسياسة عامة، يُشير إلى مشكلة الهجرة بوصفها مرتبطة بالفقر ونقص الملكية. وأثناء دفاعه عن هذا الحق في الملكية الخاصة، يُبرز ثلاث فوائد له، ثالثها أن تعزيز الملكية يمكن أن يُشجّع الناس على البقاء في أوطانهم، مما يُعزز الشعور بالانتماء والاستقرار. ويُعبّر البابا عن هذه النقطة بقوله: "سوف يتمسك الناس بالبلد الذي وُلدوا فيه، إذ لا أحد سيُبادل وطنه بأرض أجنبية إذا كانت بلاده توفر له سبل حياة كريمة وسعيدة. ومع ذلك، لا يمكن احتساب هذه الفوائد الثلاث المهمة إلا إذا لم تُستنزف وسائل الإنسان وتُستنفد بسبب الضرائب المفرطة. إن حق امتلاك الملكية الخاصة مستمد من الطبيعة، لا من الإنسان؛ وللدولة الحق في تنظيم استخدامها بما يخدم الصالح العام فقط، ولكن ليس لها بأي حال من الأحوال أن تستحوذ عليها بالكامل". يُشير البابا من خلال هذه الفقرة إلى أن الناس يُجبرون على الهجرة بسبب الضائقة الاقتصادية، إذ لا يجدون في أوطانهم الوسائل اللازمة لحياة كريمة وصحية. وتُعد هذه الحالة صحيحة بشكل خاص بسبب صعوبة الحصول على الملكية الخاصة.
لقد أصبحت ظاهرة الهجرة أكثر مأساوية في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يُعد البابا بيوس الثاني عشر أول راعٍ رأى ضرورة إصدار وثيقة تعليمية متكاملة بشأن الهجرة. وتُعتبر الدستور الرسولي Exsul Familia الصادر في 1 آب 1952 بمثابة «الوثيقة المرجعية الأساسية لفكر الكنيسة الكاثوليكية حول الهجرة». فهي أول وثيقة رسمية للكرسي الرسولي ترسم بشكل شامل ومنهجي، من منظور تاريخي وقانوني، الرعاية الراعوية للمهاجرين، وتُعد بمثابة "قانون خاص" لهذا القطاع.. والبابا بيوس الثاني عشر هو أول من صاغ "الحق في الهجرة" بشكل صريح في تاريخ التعليم الاجتماعي الكاثوليكي، مستندًا إلى استخدام البابا لاوون الثالث عشر لمفهوم "الحق في الملكية الخاصة" المستمد من القانون الطبيعي في Rerum Novarum. ويقول البابا بيوس الثاني عشر: "إن الأرض التي نسكنها، المحاطة بالمحيطات والبحار والبحيرات، والمزينة بالسهول والجبال المغطاة بالثلوج الدائمة، والمزودة بأماكن غير مزروعة ومناطق مهجورة وقاحلة، توفّر بالفعل سبلًا للحياة، وتعرض مساحات واسعة، وإن تُركت لمصيرها لتزدهر، فإنها مع ذلك تبدو ملائمة لعمل الإنسان واحتياجاته ومساعيه المدنية. وليس من النادر أن تُجبر العائلات المهاجرة هنا وهناك على البحث عن وطن جديد.
يتجاوز البابا بيوس الثاني عشر مجرد صياغة "الحق في الهجرة" استنادًا إلى مبدأ الوجهة العالمية لخيرات الأرض، إذ يُقدّم أيضًا دفاعًا ضمنيًا عن "الحق في البقاء" من خلال إدانته للهجرة القسرية ودفاعه عن حق اللاجئين والمنفيين في العودة إلى أوطانهم. ويقول البابا: "في هذه الخطب وفي أحاديثنا الإذاعية، أدنّا بشدة أفكار الدولة التوتاليتارية والإمبريالية، وكذلك النزعة القومية المفرطة. فهي من جهة تُقيّد بشكل تعسفي الحقوق الطبيعية للناس في الهجرة أو الاستيطان، ومن جهة أخرى تُجبر شعوبًا بأكملها على الهجرة إلى أراضٍ أخرى، وتُرحّل السكان ضد إرادتهم، وتُمزّق الأفراد بشكل مشين من أسرهم ومنازلهم وبلدانهم... وقد أشرنا إلى طريق آخر لتحقيق السلام، طريق يُعزز العلاقات الودية بين الأمم؛ وهو السماح للمنفيين واللاجئين بالعودة أخيرًا إلى منازلهم، والسماح للمحتاجين، الذين تفتقر أراضيهم إلى ضروريات الحياة، بالهجرة إلى دول أخرى".
ويمكن تلخيص أفكار البابا بأنها تتسم بالترويج الصريح لـ"الحق في الهجرة"، والدفاع الضمني عن "الحق في البقاء"، استنادًا إلى المبدأ اللاهوتي للوجهة العالمية لخيرات الأرض. وبينما كان البابا لاوون الثالث عشر أول من تناول مشكلات الهجرة القسرية بشكل موسّع، لا سيما في سياق الرعاية الروحية وخلاص النفوس، فإن البابا بيوس الثاني عشر بنى على ذلك من خلال تأكيده على ضرورة عدم اقتلاع الناس من منازلهم، ووجوب السماح لهم بالعودة. ولا تزال الرعاية الروحية حاضرة في كتاباته، لكن مبدأ الوجهة العالمية للثروات يكتسب أهمية أكبر مع صياغته لـ"الحق في الهجرة" وضمنيًا لـ"الحق في البقاء". في هذا السياق، تتوسع الاهتمامات لتشمل جميع المهجّرين، وليس فقط الكاثوليك
يولي البابا يوحنا الثالث والعشرون اهتمامًا خاصًا بـ«إعادة تكوين الخلايا الأسرية، التي وحدها يمكنها أن تحمي بشكل فعّال الخير الديني والأخلاقي والاقتصادي للمهاجرين أنفسهم، وذلك دون أن يخلو الأمر من فائدة للبلدان التي تستقبلهم. ويقول في هذا السياق: «لهذا الغرض، يجب على المهاجر – سواء داخل الوطن أو خارجه – أن يبذل جهدًا لتجاوز إغراء العزلة، التي قد تمنعه من التعرف على القيم الموجودة في البلد المضيف. عليه أن يقبل خصائص البلد الجديد، وأن يلتزم بالمساهمة من خلال قناعاته ونمط حياته في تطوير حياة الجميع».
وقد أكّدت التعليمات الراعوية De pastorali migratorum cura الصادرة عام 1969 على واجبات المهاجرين، حيث جاء فيها: «كل من ينتقل إلى شعب آخر، عليه أن يُقدّر تراثه، ولغته، وعاداته تقديرًا كبيرًا... لذلك، ينبغي على المهاجرين أن يتكيّفوا طواعية مع الجماعة التي تستقبلهم، وأن يسارعوا إلى تعلّم لغتها، حتى إذا ما طال مقامهم أو أصبح دائمًا، يتمكنوا من الاندماج بسهولة أكبر في المجتمع الجديد».
في سياق الحرب الباردة، يُقدّم البابا يوحنا الثالث والعشرون في رسالته العامة السلام على الأرض (Pacem in Terris) قائمة بالحقوق الإنسانية والواجبات المرتبطة بها، مستندًا إلى مبدأ كرامة الشخص البشري. ويُعرب البابا عن قلقه من الانتهاكات التي ارتكبتها الأنظمة التوتاليتارية في القرن العشرين، والتي ضحّت بأرواح الأبرياء باسم أيديولوجيات الدولة. ويُفسّر البابا كرامة الإنسان كما يلي: "إن له طبيعة مزودة بالعقل والإرادة الحرة. وبناءً على ذلك، له حقوق وواجبات، تنبع معًا كنتيجة مباشرة من طبيعته. وهذه الحقوق والواجبات عالمية وغير قابلة للانتهاك، وبالتالي لا يمكن التنازل عنها. (...) وعندما ننظر إلى كرامة الإنسان من منظور الوحي الإلهي، فإن تقديرنا لها يزداد بشكل لا يُقارن. لقد افتُدي البشر بدم يسوع المسيح. وبالنعمة أصبحوا أبناء وأصدقاء لله، وورثة للمجد الأبدي".
وبالتالي، فإن كرامة الشخص البشري في التعليم الاجتماعي الكاثوليكي تستند إلى حقائق طبيعية ومُعلنة. فالبشر عقلانيون، لديهم ذكاء وإرادة، وبالتالي هم أحرار. هذا هو العنصر الطبيعي الذي يُظهر كرامة الإنسان. ولكن هناك عنصر أعمق، وهو ما يُكشف في الوحي الإلهي، حيث نتعلم أن الرجل والمرأة خُلقا على صورة الله ومثاله، وفُديا بواسطته. فالبشر ثمينون جدًا في نظر الله، حتى أن ابنه الوحيد سفك دمه من أجلهم. وهذا هو العنصر المُعلن من كرامة الإنسان، الذي يُضفي طابعًا إلهيًا على الطبيعة البشرية. ويُشكّل هذا المفهوم لكرامة الإنسان الأساس لقائمة الحقوق والواجبات في السلام على الأرض، والتي تتراوح من الحق في الحياة إلى الحقوق السياسية. ومن بين هذه الحقوق الأساسية نجد "الحق في البقاء". ويُعبّر البابا يوحنا الثالث والعشرون عن ذلك بقوله: "لكل إنسان الحق في حرية التنقل والإقامة ضمن حدود دولته الخاصة." (يوحنا الثالث والعشرون، 1963، فقرة 25). وعلى الرغم من أن هذا التصريح واسع جدًا، إلا أن جوهره يكمن في فهم أن الناس لا ينبغي أن يُجبروا على مغادرة وطنهم الأصلي، ويجب أن يُسمح لهم بالعودة إذا غادروه. وفي جزء لاحق من نفس الرسالة العامة، يُشير البابا إلى وضع اللاجئين الذين أُجبروا على مغادرة بلادهم بسبب الأنظمة التوتاليتارية القمعية. ويُوضح البابا: "إن المشاعر العميقة من المحبة الأبوية للبشرية جمعاء، التي غرسها الله في قلبنا، تجعل من المستحيل علينا أن ننظر دون ألم شديد إلى محنة أولئك الذين نُفوا من أوطانهم لأسباب سياسية. هناك أعداد كبيرة من هؤلاء اللاجئين في الوقت الحاضر، وكثير منهم يُعاني – المعاناة التي لا تُصدّق – والتي يتعرضون لها باستمرار. وهنا، بالتأكيد، دليلنا على أنه، في تحديد نطاق الحرية العادلة التي يمكن أن يعيش فيها المواطنون حياة تليق بكرامتهم الإنسانية، فإن حكّام بعض الدول كانوا متشددين للغاية. ففي بعض هذه الدول، يُشكك في الحق ذاته في الحرية، بل يُنكر تمامًا. وهنا نجد انقلابًا كاملًا في النظام الصحيح للمجتمع، إذ إن الغاية الأساسية للسلطة العامة هي حماية مصالح الجماعة. وواجبها السيادي هو الاعتراف بالمجال النبيل للحرية وحماية حقوقه". وفي هذا المقطع أيضًا، يُدين البابا يوحنا الثالث والعشرون وضع اللاجئين والمنفيين الذين أُجبروا على مغادرة منازلهم من قبل الدول الاستبدادية. ويُعالج هذه القضية في سياق الخير العام العالمي، والحاجة إلى التضامن الفعّال بين الدول والمجتمعات الوسيطة والمواطنين. فمحنة اللاجئين تُعد تقييدًا للحق الأساسي في الحرية من قبل السلطة التي من المفترض أن تخدم وتحمي مواطنيها. ويجب أن يكون المواطنون والمجتمعات الوسيطة والدول الأخرى مستعدين للتعاون في رعاية اللاجئين، بصفتهم أعضاء في الأسرة الإنسانية العالمية. ومن المهم ملاحظة كيف يربط البابا فكرة الحرية بـ"الحق في البقاء" في الوطن، وبازدهار الإنسان ومبدأ كرامته. فالحق في عدم إجبار الإنسان على الهجرة يستند إلى كرامته الإنسانية.
وبعد تناوله "الحق في البقاء"، يُشير البابا يوحنا الثالث والعشرون أيضًا إلى "الحق في الهجرة"، ويُقدّم لأول مرة قيدًا صريحًا لهذا الحق. فبعد تأكيده على حق الإقامة داخل الدولة، يقول إن للناس الحق في الهجرة والإقامة في دول أخرى لأسباب عادلة، ويُوضح: "عندما تكون هناك أسباب عادلة لذلك، يجب السماح له بالهجرة إلى دول أخرى والإقامة فيها. إن كونه مواطنًا في دولة معينة لا يُحرمه من عضويته في الأسرة الإنسانية، ولا من مواطنته في المجتمع العالمي، أي الزمالة العالمية المشتركة للبشر... ومن بين الحقوق الشخصية للإنسان، يجب أن نُدرج حقه في دخول دولة يأمل أن يتمكن فيها من توفير حياة أكثر ملاءمة له ولمن يعولهم. وبالتالي، فإن من واجب مسؤولي الدولة قبول مثل هؤلاء المهاجرين – طالما أن خير مجتمعهم الخاص، كما يُفهم بشكل صحيح، يسمح بذلك – وتعزيز أهداف أولئك الذين يرغبون في أن يصبحوا أعضاء في مجتمع جديد". ويُظهر هذا المقطع أن "الحق في الهجرة" هو حق إنساني أساسي، لا يعتمد على المواطنة، بل على الإنسانية ذاتها. ويُسميه البابا "حقًا شخصيًا". وهو حق أساسي إلى درجة أن البابا يُؤكد أنه عندما تكون هناك أسباب عادلة، يجب على مسؤولي الدولة السماح للمواطنين بالمغادرة، كما يجب عليهم قبول المهاجرين من دول أخرى.
على خلاف البابا يوحنا الثالث والعشرون، يُقدّم البابا يوحنا بولس الثاني تفاصيل دقيقة حول "الحق في البقاء" في خطابه خلال المؤتمر العالمي للرعاية الراعوية للمهاجرين واللاجئين عام 1998. ويُبدي البابا قلقًا خاصًا إزاء الأسباب المتعددة للهجرة القسرية، ويُصرّح قائلًا: "في هذا السياق، يبدو من المناسب التأكيد على أن العيش في الوطن هو حق إنساني أساسي. غير أن هذا الحق لا يصبح فعّالًا إلا إذا تم التحكم باستمرار في العوامل التي تدفع الناس إلى الهجرة. وتشمل هذه العوامل، من بين أمور أخرى، النزاعات الأهلية، الحروب، نظام الحكم، التوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية، السياسات الزراعية غير المتسقة، التصنيع غير العقلاني، والفساد المستشري. وإذا أُريد تصحيح هذه الأوضاع، فلا بد من تشجيع التنمية الاقتصادية المتوازنة، والقضاء على التفاوتات الاجتماعية، والاحترام الدقيق للإنسان، وحسن سير الهياكل الديمقراطية. كما أنه من الضروري اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لتصحيح النظام الاقتصادي والمالي الحالي، الذي تهيمن عليه الدول الصناعية وتُديره على حساب الدول النامية" (فقرة 2). ويُوضح البابا أنه في مواجهة تعقيد ظاهرة الهجرة وتبعاتها المأساوية، يجب أن نتذكر أولًا وقبل كل شيء أن هناك "حقًا إنسانيًا أساسيًا في العيش في الوطن". ويرى البابا أن ظاهرة الهجرة المعاصرة تعاني من اختلال وظيفي كبير، إذ يُجبر العديد من المهاجرين على مغادرة بلدانهم من أجل البقاء أو لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة لهم ولأسرهم، وهو ما أطلق عليه لاحقًا "هجرة اليائسين". ولهذا السبب، كجزء من "الحق في البقاء"، ينبغي على الدول والمجتمع المدني معالجة الأسباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تُؤدي إلى الهجرة القسرية، حتى يتمكن الناس من البقاء في أماكنهم الأصلية. ولن يكون "الحق في البقاء" فعّالًا إلا إذا تم "التحكم" في الظروف التي تُجبر الناس على الهجرة. وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين لعام 2004، والتي تناول فيها العمل من أجل العدالة كوسيلة لتحقيق السلام، لا سيما في سياق أزمة الهجرة، صاغ البابا يوحنا بولس الثاني مصطلح "الحق في عدم الهجرة"، وقال: "فيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين، فإن بناء شروط السلام يعني عمليًا الالتزام الجاد بحماية الحق في عدم الهجرة، أي الحق في العيش بسلام وكرامة في الوطن. ومن خلال إدارة محلية ووطنية بعيدة النظر، وتجارة أكثر عدالة، وتعاون دولي متضامن، يمكن لكل دولة أن تضمن لشعبها، بالإضافة إلى حرية التعبير والتنقل، إمكانية تلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والرعاية الصحية، والعمل، والسكن، والتعليم؛ فحرمان الناس من هذه الاحتياجات يدفع الكثيرين إلى وضع لا يكون أمامهم فيه خيار سوى الهجرة. وبالمثل، فإن الحق في الهجرة موجود. وهذا الحق، كما يُذكّر به الطوباوي يوحنا الثالث والعشرون في الرسالة العامة Mater et Magistra، يستند إلى الوجهة العالمية لخيرات هذا العالم (راجع الفقرتين 30 و33). ومن الواضح أن من واجب الحكومات تنظيم تدفقات الهجرة مع الاحترام الكامل لكرامة الأشخاص واحتياجات أسرهم، مع مراعاة متطلبات المجتمعات المُضيفة." (فقرة 3).
وبالإضافة إلى هذه الإشارات الصريحة إلى "الحق في البقاء"، يتناول البابا يوحنا بولس الثاني جانبًا أساسيًا من هذا الحق بشكل ضمني في رسالته العامة Laborem Exercens لعام 1981، والتي تتناول كرامة العمل الإنساني، الذي له أولوية على رأس المال، ويستند إلى كرامة الإنسان. وعند حديثه عن العمال المهاجرين، يقول البابا: "أخيرًا، يجب أن نقول بضع كلمات على الأقل حول موضوع الهجرة بحثًا عن العمل. إنها ظاهرة قديمة العهد، ومع ذلك لا تزال تتكرر، ولا تزال منتشرة اليوم نتيجة لتعقيدات الحياة الحديثة. للإنسان الحق في مغادرة وطنه لأسباب متعددة – وكذلك الحق في العودة – من أجل البحث عن ظروف حياة أفضل في بلد آخر. وهذا الواقع لا يخلو من صعوبات متنوعة. وقبل كل شيء، يُشكّل ذلك عمومًا خسارة للبلد الذي يُغادره الإنسان. فهو مغادرة لشخص يُعد عضوًا في جماعة عظيمة موحّدة بالتاريخ والتقاليد والثقافة؛ ويجب على هذا الشخص أن يبدأ حياته في وسط مجتمع آخر موحّد بثقافة مختلفة، وغالبًا بلغة مختلفة. وفي هذه الحالة، فإنها خسارة لمورد بشري، كان من الممكن أن تُسهم جهوده العقلية والبدنية في الخير العام لوطنه، لكنها تُقدَّم بدلاً من ذلك لمجتمع آخر، قد لا يكون له نفس الحق فيها كما لوطنه الأصلي." (فقرة رقم 23).
يكتب البابا يوحنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للهجرة، 5 آب 1987: "تُتيح الهجرات للكنائس المحلية فرصة التحقق من كاثوليكيتها، التي لا تقتصر على استقبال الأعراق المختلفة فحسب، بل تتجلى بشكل أعمق في تحقيق الشركة بين هذه الأعراق. إن التعددية الإثنية والثقافية داخل الكنيسة لا تُعد حالة مؤقتة يجب تحملها، بل هي بُعد بنيوي من أبعادها. فالوحدة في الكنيسة لا تنبع من الأصل أو اللغة المشتركة، بل من روح العنصرة الذي، بجمعه شعوبًا من لغات وأمم مختلفة في شعب واحد، يمنح الجميع الإيمان بالرب الواحد والدعوة إلى الرجاء الواحد. وهذه الوحدة أعمق من أي وحدة أخرى تقوم على أسس مختلفة".
إن التزام الكنيسة الكاثوليكية في مجال التنقل البشري، ولا سيما في ما يتعلق بظاهرة الهجرة، يتسم منذ نشأته بنهج متعدد الأبعاد، متعدد العوامل، ومتداخل التخصصات، يسعى إلى إدراك مدى كون الهجرة واقعًا بنيويًا في المجتمع وتجربة إنسانية جوهرية، تمثل «تحديًا كبيرًا، ولكنها أيضًا فرصة للنمو الثقافي والروحي للجميع»، مع الوعي بأن كل مهاجر، إلى جانب ما يحمله من معاناة وآلام وآمال، هو قبل كل شيء حامل لـ«ثراء إنساني وديني، ثراء ينبغي استقباله لا الخوف منه". لذلك، تُعد "قضية المهاجرين" من أهم الفرص لتجسيد وتحقيق التحول العاجل في الأشخاص والبُنى الكنسية، وهو تحول يتطلب من الكنيسة الكاثوليكية ألا تكتفي بملاحقة وإدارة حالة الطوارئ المرتبطة بالهجرة، بل أن تتجه نحو حلول منهجية تشمل أيضًا القانون الكنسي، ومن ثم الرعاية الراعوية، من خلال برنامج من الإجراءات المترابطة، لخصه البابا فرنسيس مؤخرًا بأفعال: «الاستقبال، الحماية، الترويج، والاندماج»، سواء تعلق الأمر بتدخلات لصالح المؤمنين المهاجرين أو بمبادرات موجهة لغير الكاثوليك أو غير المؤمنين، بحيث تصبح مهمة الكنيسة تجاه المهاجرين تعبيرًا متزايدًا عن الكاثوليكية الحقيقية، وعن الشركة العالمية، وتُسهم في تعزيز الحوار المسكوني والديني.












