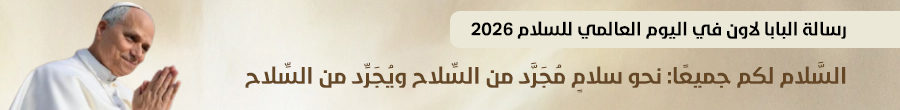موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

الأب د. عزيز حلاوة، مدير المكتب الليتورجي التابع للبطريركية اللاتينية في القدس
إنّ أوّل وثيقة رسميّة تُدرِج الاحتفال بعيد الميلاد في 25 ديسمبر في روما كان ما عُرِف باسم "كرونوغرافو فيلوكَليانو Cronografo Filocaliano"، وذلك سنة 354. وهو عبارة عن تقويم مدني-ديني يُدرِج أسماء الشهداء، وكان على رأس القائمة فيه عيد وثنيّ وهو عيد ميلاد "الشمس التي لا تُغلَب" Sol invictus فكان لا بُدّ من وضع مكان هذا العيد الوثنيّ عيدٌ مسيحيّ آخر، فاختير الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح.
وقد ظهر هذا العيد في روما منذ العام 336 في هذه الرزنامة كالتالي: "في بيت لحم اليهوديّة وُلد المسيح". ولكن هنالك نظريات معاكسة تقول إنّ عيد الميلاد بدأ في فلسطين وشمال أفريقيا، وذلك منذ منتصف القرن الثالث، في عهد القديس قبريانُس، وقد أراد الإمبراطور الوثني ماركو أورليو استبدال عيد الميلاد بعيد وثني عالمي يوحّد به الإمبراطوريّة مع عيد الشمس.
إذًا السبب في الاحتفال بهذا العيد كان لضورورة دفاعيّة لاهوتيّة ذي شقَّين:
1. التغطية على عيد وثني وهو عيد الشمس التي تُقهَر.
2. الرغبة في التأكيد على حقيقة لاهوتيّة في مواجهة الهرطقات التي طالت حقيقة تجسُّد السيد المسيح وإنسانيّته في القرنين الرابع والخامس وخاصّة هرطقات آريوس ونسطوريوس وأوطيخوس.
أوّل مصادر ليتورجيّة لكيفيّة الاحتفال بعيد الميلاد نجدها في وعظات البابا القديس لاون الكبير (440-461)، فالعشرة عِظات التي كتبها تُقدّم معلومات دقيقة عن ترتيب الاحتفالات الميلاديّة ولكن بالذات عن محتواها اللاهوتي، ونجد هذه الوعظات في كتاب القدّاس من فيرونا.

بين البابا لاون الكبير والقديس أوغسطينُس
يُقارن القديس أوغسطينُس عيد الميلاد مع عيد الفصح، ويعتبر الميلاد مجرَّد تذكار أو ذكرى سنويّة لميلاد السيد المسيح، بينما يتمتَّع عيد الفصح بالطابع الأسراريّ، أي أنّه "السرّ Sacramentum الحقيقي". لكنّ البابا لاون الكبير يصف الميلاد بأنّه "أسرار عجيبة" mirabilis sacramenti، مُعتبرًا، لارتباطه الوثيق بالفصح، أنّه عيد حقيقيّ للفداء ويدخل في إطار الحدث الشامل للخلاص.
ففي الميلاد، أي التجسُّد الإلهي، نجد نقطة الإنطلاق لما تمّ في جسد المسيح من أجل خلاصنا. لذلك نجد التعبير الأوضح للبعد الخلاصي للميلاد في الصلاة على القرابين في عشيّة العيد، وهي من القرن الخامس، والتي تقول: "نسألك أيُّها الإله ربَّنا أن نسبِقَ بأجمل خدمة في هذه العشيّة المقدَّسة إلى احتفالات الميلاد الّذي هو بَدءُ خلاصِنا."
الميلاد والسرّ الفصحي
دورة الميلاد (المجيء - الميلاد – الإبيفانيا): المبدأ والغاية إذًا يتلاقيان، بالّذي جاء في الماضي وأيضًا بالّذي سيأتي في المستقبَل. دورة الميلاد هذه هي تطوُّر لدورة الفصح وهذا يعني أنّ في البداية كان هنالك فقط الفصح، والأحد، والإفخارستيا.
ولكنّ دورة الميلاد، وهي أيضًا قديمة جدًا، هي دورة عيد عودة الربّ الثانية (الباروزيا). لذلك لا نجد في صلوات الميلاد، في بداية العصور، ذكرًا للطفل يسوع، بل فقط في العصور الوسطى صار هنالك ذكر للطفل الإلهي. فالميلاد إذًا هو بدء سرّ فدائنا الخلاصيّ، والشرط الأساسي لكي يتمّ الموت، وتتمّ القيامة فيما بعد. يدعوه البابا اللاهوتيّ بندكتس السادس عشر "سرّ البداية" وسرّ البداية هذا "كان يُنير ما سوف يلحق".
أمّا تاريخ عيد الميلاد في 25/12 فهو مرتبط أكثر بالفصح (25/3) أكثر منه كحدث تاريخي. لذلك يضع الشرقيون عيد الميلاد في 6/1 لأنّ الفصح يقع في 6/4 (حسب عِظة لمليتون السرديّ).
التبادل العجيب
ومِن العناوين الرئيسيّة التي تتردَّد في ليتورجيا الميلاد، نجد تعبير "التبادل العجيب" الّذي يُتحِفُنا به القديس أوغسطينُس، بهذا التبادل "صار الله إنسانًا لكي يصير الإنسان إلهًا". نقرأ في الصلاة الجامعة في قدّاس النهار: "امنحنا أن نشترك في لاهوت ابنك الّذي شاركنا في ناسوتنا...".
وفي المقدّمة الثالثة للميلاد والتي تعود للقرن الخامس، نقرأ ما يلي: "به سطع اليوم نورُ تبادلٍ عَجيب هو سببُ فدائنا وجَديدُ حياتِنا. فالكلمة يتَّخِذُ ضعفنا البشريّ، ويُولي طبيعَتنا الفانية شرَفًا رفيعًا خالِدًا لن يَزول. وإذ يُصبِحُ واحدًا مِنّا وفي كلِّ شيء بنا شبيهًا، فإنّما يجعلنا نحن أيضًا مِن أهلِ الخلودِ السماويين".
إذًا، يتبادل الله معنا الأدوار، وينحدر، لكي يرفع الإنسان إلى مقامه. ويقول البابا بندكتس السادس عشر في شأن ذلك: "إنّه انحدار القادر على كلّ شيء، فإن أصبح الآن في الأسفل، فهذا يعني أيضًا أن "السفليّ" صار "عُلويًّا". لقد سقط ذلك الفصل القديم بين "أعلى و"أسفل"، وتغيَّرَت صورة العالم، وأيضًا صورة الإنسان. نعم لقد تغيَّرت هذه الصورة، وذلك بفضل الإله الّذي نزلَ".
طابع كونيّ
وللميلاد طابع كونيّ، ففي تجسُّدِه، يُعيد السيد المسيح إندماج الكون بأسره واكتماله كما كان في الأصل. هذا ما توضّحه المقدّمة الثانية للميلاد:
"في سرّ هذا العيد المجيد، كلمة الله الّذي لا يُرى قد ظهرَ إنسانًا يُرى مِثلَنا. والمولودُ قبل كلِّ الدُّهور، جاء وسكَنَ بيننا، وقد تمَّ الزمان. حتى إذا جَذَبَ إليه كلَّ ما سقط، جَدَّدَ الكونَ كلَّه، وعادَ بالإنسان الهالك إلى دارِ الملكوت السماوي."
"الشمس التي لا تُغلَب"
تكلّمنا عن حلول عيد ميلاد السيد المسيح مكان عيد وثنيّ، وهو عيد "الشمس التي لا تُغلَب"، والّذي يقع في 25 ديسمبر، أي في يوم "الاعتدال الشتوي"، اليوم الّذي يبدأ النهار فيه يطول على حساب الليل. وفي الديانات الوثنيّة، يرمز هذا إلى بدء انتصار نور الشمس على الظلام.
وفي العقيدة المسيحيّة نجد فكرة انتصار النور على الظلمة، أي انتصار الحقيقة على الجهل، انتصار المسيح على العالم. وتتردَّد في نصوص الميلاد فكرة المسيح "شمس العدل الحقيقيّة"، التي تسطع لتُنير البشريّة جمعاء، بعد ليل الخطيئة. وهذا ما يُفسّر كيف أن تاريخ الميلاد يتبع النظام الشمسيّ، وبالتالي فهو عيد ثابت، على خلاف عيد الفصح، الّذي يتبع النظام القمريّ، لذلك يتغيّر.

رمزيّة 25 الشهر
كان همّ الكنيسة، ومنذ البدايات، من تحديد تاريخ عيد الميلاد في 25 ديسمبر، ليس تحديد تاريخ ميلاد السيد المسيح في الجسد، بل اهتمامها بالحقيقة القائلة إنّ تجسّده هو بداية سرّ الخلاص.
هنالك دراسة أخرى تقول إنّ الرقم 25 جاء من استنتاج تاريخ مولد المسيح من تاريخ وفاته المفترض، إذ انتشر منذ القرن الثالث الرأي القائل بأنّ السيد المسيح مات في 25 آذار (حسب ترتليانُس وهيبولتُس الروماني). وبحسب هذا الرأي فقد حصل الحَمَل بالسيد المسيح في 25 آذار أيضًا، وبالتالي حُدِّد تاريخ الميلاد بعد تسعة أشهر من هذا التاريخ. أي أنّ تاريخ الميلاد مرتبط بتاريخ الفصح.
وفي الواقع هنالك أعياد مُهمّة مرتبطة بالتاريخ 25 من الشهر، مثل: البشارة في 25 آذار، موت يسوع في 25 آذار، خلق الشمس في 25 آذار، ميلاد يوحنا المعمدان في ليلة 25 حزيران. وجميع هذه مرتبطة بالفصح لأنّها تتكلّم عن عمليّة ولادة وموت.
حسب سفر التكوين (1: 1-19) خلق الله في اليوم الأوّل النور والظلام، وفي اليوم الثاني السماء، وفي الثالث الأرض، وفي الرابع الشمس والقمر، وبعمليّة حسابية، إذا ما عرفنا أنّ اليوم 21 من كانون الثاني هو أقصر يوم من السنة (الإنقلاب الشمسي) ومن بعده يبدأ النهار يطول شيئًا فشيئًا، كأنّه خلق جديد، وفي رابع يوم، أي 21+4 يعني 25 الشهر، هو خلق الشمس، أو ميلاد الشمس Natalis invicti.

بين الميلاد والإبيفانيا
لا يمكن الفصل بين عيد الميلاد وعيد الإبيفانيا، فالأوّل ظهر أوّلًا في الغرب، ومن ثمّ انتقل شيئًا فشيئًا إلى الشرق، أمّا الإبيفانيا فظهر أوّلًا في الشرق ثمّ انتقل إلى الغرب.
في الشرق كان المسيحيّون يحتفلون أوّلًا بالإبيفانيا في 6 كانون الثاني، لأنّ الوثنيين كان يحتفلون بهذا التاريخ في عيد الشمس، فاستبدله المسيحيّون بعيد الظهور الإلهي. إذًا كان عيد الظهور هو نفسه عيد الميلاد في الشرق (أي ظهور الرّب في الجسد).
ولكن لـمّا انتقل عيد الميلاد إلى الشرق، أصبح عيد الظهور يركّز على عمّاد الرّب وليس على ميلاده، وفي الغرب على ظهور النجم للمجوس. لذلك تجمع الليتورجيا الرومانية هذه الذكريات معًا. ولكن في الكنيسة الأورشليميّة كان عيد الإبيفانيا يركّز على الميلاد فقط، وهذا هو معناه اللاهوتي الأصيل كما رأينا.
يجب ألّا ننسى أيضًا أنّ العهد الجديد يُشير بهذا التعبير "الظهور" سواء إلى ظهور الرَّبّ أو إلى مجيئه الثاني. ويدعو أوسابيوس القيصريّ تجسُّد المسيح بـ"الظهور الإلهيّ "ثيوفانيا" للرّبّ" أو "ظهوره الإلهي في الجسد".
عيد الميلاد في الشرق
تبنّته أنطاكيا سنة 375، ثمّ بيزنطا مع القديس غريغوريوس النازينزي سنة 380، ثمّ مصر سنة 431، وأخيرًا الكنيسة الأورشليمية في القرن السادس. وبقيت كنيسة وحيدة لم تتبنى عيد الميلاد وهي الكنيسة الأرمنيّة، إذ تحتفل فقط بعيد الإبيفانيا في 19 كانون الثاني.

إضاءات لاهوتية من البابا بندكتُس السادس عشر
العذراء والطفل
في عهد أوغسطُس قيصر، بعد كلّ الاضطرابات الناتجة عن الحروب، عمّت البلاد موجة أمل: بعد الآن، يجب أن يبدأ أخيرًا عهدُ سلام، يجب أن يقوم نظامٌ عالميٌّ جديد.
صورة العذراء هو جزء من جوِّ الترقُّب الجديد هذا، صورة الطهارة والاستقامة، الانطلاق مما هو "مستقيم"، وانتظار الصبيّ، من "أصل إلهيّ" هو جزء أيضًا من هذا الانتظار. وصورة العذراء وصورة الطفل هما جزء من صوَر الرجاء الإنساني الأساسيّة، التي تنبعث من أوقات الأزمة والترقُّب.
هي طاعة مريم التي تفتح الباب للرّبّ. كلام الله، روحُه، يخلق فيها الصبيّ، يخلقه من باب طاعتها. هكذا يسوع هو آدم الجديد، بداية جديدة مما هو "مستقيم" و"صَفيّ" عند العذراء، التي هي كلّيًّا في تصرُّف إرادة الله.
في تاريخ يسوع مناسبتان تدخَّلَ عَملُ الله فيهما بشكل مُباشر في العالم الماديّ: الولادة من عذراء، والقيامة من القبر. الولادة البتوليّة والقيامة الحقيقيّة من القبر هما حَجَرا مِحَكّ للإيمان. والله مِن خلال الحَبَل البتوليّ وقيامة يسوع المسيح قد دَشَّن خليقة جديدة، هكذا، لكونه الخالق، فإنّه أيضًا فادينا. لهذا السبب، إنّ الحبلَ وولادة يسوع من مريم العذراء هما عنصرٌ أساسيٌّ لإيماننا، وعلامة رجاءٍ وضّاءة.
الإبن البكر
"فولَدَتْ ابنها البِكْر" (برِه بوكرو ܒܪܗ ܒܘܟܪܐ) باليونانيّة (بروتوتوكون πρωτοτοκον) (لو 2: 7) ماذا يعني ذلك؟ يُشير هذا إلى صفة لاهوتيّة أكثر من تعداد مستمرّ، وتعود إلى سفر الخروج (13: 1-2) "قدِّس لي كلَّ بِكْر، كلَّ فاتِح رَحم مِن بني إسرائيل، من الناس والبهائم إنّه لي". الصفة اللاهوتيّة هي إنتماء يسوع إلى الله مثل أيّ بِكْر، لذلك قُدِّم يسوع إلى الهيكل.
طوَّر القديس بولس هذه الفكرة اللاهوتيّة في مرحلتَين: في الرسالة إلى الرومانيين يدعو بولسُ يسوعَ بِكْرًا لإخوة كثيرين ܒܘܟܪܐ ܕܐܚܐ ܤܓܝܐܐ (πρωτοτοκον εν πολλοις αδελφοις) (8: 29)، ولكن بالذات منذ قيامته أصبح بطريقة جديدة "المولود البِكْر". لم يعُد الأوّلَ في الكرامة فحسب، بل إنّه الّذي يُدَشِّن بشريّة جديدة.
في الرسالة إلى الكولسيّين يُدعى المسيح "بِكْرَ كلِّ خَلق" ܒܘܟܪܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ (πρωτοτοκος πασης κτισεως) (1: 15)، "البدء" (روشو) ܪܫܐ (أرخِه) αρχη و"البكْرُ مِن بين الأموات" ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ (πρωτοτοκος εκ των νεκρων) (1: 18).
إذًا، يكتسب مفهوم البِكْر أو المولود الأوّل بُعدًا كونيًّا عند مار بولس. فالمسيح، الابن المتجسِّد، هو فكرُ الله الأوّل ويسبق كلّ خليقة، وبه خلَق كلَّ شيء ܘܒܗ ܐܬܒܪܝ ܟܠܡܕܡ (εκτισθη τα παντα) (1: 16). وهو بداية ونهاية الخليقة الجديدة التي بدأت مع القيامة.
ونلقى في مذود بيت لحم الفقير هذه العظَمَة الكونيّة: هنا حلَّ بيننا بِكْرُ الكون الحقيقيّ.

بيت لحم
لماذا حصَلَت الولادة في بيت لحم؟ الإحصاء من أجل تحديد الضرائب ومن ثمّ تحصيلها، هو السبب الّذي مِن أجله ذهب يوسف ومريم الحامِل إلى بيت لحم. إنّه مكان الوَعْد الّذي سيُولَد فيه الطفل الإلهي، وكان ذلك بالصدفة، ولكن تتميمًا للنبؤة أيضًا.
بالنسبة للوقا، الإطار التاريخي العالميّ مهمّ. لأوّل مرّة يتمّ إحصاء كلّ العالم المأهول، "المسكونة" Ökumene. لأوّل مرّة توجد حكومة ومملكة تشملان الأرضَ كلّها. لأوّل مرّة يوجد مكان فسيح يسوده السلام، حيث يمكن تسجيل أملاك الجميع ووضعُها في خدمة المجتمع. عندها فقط، حيث توجد شراكة في الحقوق والأملاك على نطاق واسع، وحيث لُغةٌ عالميّة تسمح لمجتمع ثقافيّ التفاهمَ في الفكر والعمل، أمكن أن تدخُلَ العالمَ رسالةُ خلاصٍ شاملة وحاملٌ شاملٌ للخلاص: هذا بالفعل "ملءُ الزمان".
ولكن يجب ألّا ننسى أنّ سلام المسيح يتعدَّى سلام أوغسطُس، تمامًا مثلما تُسيطر السّماء على الأرض. نعم لقد قدّم الإمبراطور الروماني نوع سلام للبشريّة دام مئتين وخمسين سنة، سلام وحقوق ورفاهيّة لمواطني الإمبراطوريّة، يحلم بها اليوم العديد من البلدان، ولكن السياسة مهما علَت تبقى تَعِد بأمور لا يمكنها في النهاية إنجازها. ففي العصر الذهبي لهذا الإمبراطور لم يكن السلام والرفاهية والحقوق بعيدين عن الخطر، أو أُنجِزَت كلّيًا، ويكفي أن نُلقي نظرة على فلسطين في ذلك الوقت، كما اليوم، لمعرفة حدود السلام الروماني Pax Romana.
المهمّ هنا هو أن نعرف أنّ يسوع لـَم يولَد في "سالف الزمان" الـمُبهَم الأسطوريّ. إنّه ينتمي إلى عصر يمكن تأريخه بدقّة، وإلى وسط جغرافيّ دقيق في تحديده ، هكذا الشموليّة والواقعيّة يتلامسان. الكلمة الأزليّ صار إنسانًا، وسياق المكان والزمان هو جزء منه. والإيمان مرتبط بهذه الحقيقة الملموسة.
بيت لحم هي مدينة الملك داؤد، ويخدم هذا تحقيق وعد النبي ميخا، إذ سيُولَد راعي إسرائيل في هذه المدينة (ميخا 5: 1-3)، وبدون أن يَعلَم يُسهِم الإمبراطور في تحقيق هذا الوعد: تاريخ الإمبراطوريّة الرومانيّة، وتاريخ الخلاص الّذي بدأه الله مع شعبه يتداخلان. تاريخ الاختيار الّذي صنعه الله يدخل في رحاب العالم، في رحاب التاريخ الشامل، ويظهر الله كالمرشد الحقيقي للتاريخ كلّه.

المغارة
"لم يكن لهما موضع في النزل". يقول يوستينُس (+165) وأوريجنِّس (+نحو 254)، وكلاهما فلسطينيّان، إنّ المكان الّذي وُلد فيه يسوع كان مغارة، وكان مسيحيُّو فلسطين يدلُّون إليها، وغالبًا ما تكون المصادر المحلّيّة أكثرَ دقَّةً مِن المعلومات المكتوبة.
المذود
فسَّرَ تقليد الأيقونات، بحسب لاهوت الآباء، المذوَد والقُمط. في هذه الأيقونات يبدو الطفل ملفوفًا بشكل وثيق بالقُمط، كأنّه إشارة مسبقة لساعة موته: إنه منذ البداية الضحيّة. المذود هنا هو مذبح.
أعطى القديس أوغسطينُس تفسيرًا غريبًا للمذود، ولكنّه جميل وعميق: يقول إنّ المذود هو المكان حيث تجد الحيوانات قُوتَها، لكن يرقد الآن في المذوَد ذاك الّذي أعلَنَ عن ذاته أنّه الخبز الحقيقيُّ النازِلُ مَن السَّماء، إنّه القوت الحقيقيُّ الّذي يحتاج إليه الإنسان لكينونة شخصه البشريّ. إنّه القوتُ الّذي يُعطي الإنسان الحياة الحقيقيّة، الحياة الأبديّة. هكذا يصبح المذود تذكيرًا بمائدة الله المدعوّ إليها الإنسان ليتناول خبز الله. ففي فقر ولادة يسوع صورةٌ للواقع الكبير الّذي فيه يتحقّق، بطريقة غريبة، فداءُ البشر.
أعطى الملاك علامة للرعاة لكي يُسرِعوا في إيجاد الطفل المولود: سيجدون طفلًا ملفوفًا بقمط ومُضجعًا في مذوَد. هذه علامة تعريف. ولكن هذه العلامة ليست بعلامة، بل فقر الله هو العلامة الحقيقيّة.
الحيوانات
في الإنجيل لا حديث عن الحيوانات في المغارة، ولكن التقليد الّذي ترسمه لنا الأيقونات، يعود بنا إلى العهد القديم، إلى أشعيا 1: 3: "عرَفَ الثورُ قانيَه والحمارُ معلَفَ صاحبِهِ، لكنّ إسرائيلَ لم يَعرِف، وشعبي لم يفهم". كذلك هنالك الترجمة اليونانيّة لحبقوق 3: 2: "بين حيوانَين تُعرَف؛... عندما يَحين الأوان تَظهَر" «ἐν μέσῳ δυoĩν ζωῶν».
يُفهَم مِن هذين الحيوانَين الكروبَين الموجودَين بحسب سفر الخروج 25: 18-20، على غطاء تابوت العهد، واللذان يستُران وجودَ الله الخفيّ ويُدلّان عليه بنفس الوقت. هكذا يُصبح المذود بطريقة ما تابوت العهد، حيث الله حاضر بطريقة عجيبة، موجودًا بين البشر، وأمام هذا المذود تَحين للثور وللحمار، اللذان يرمزان للبشريّة، المؤلّفة مِن يهود وأُمَم، ساعةُ معرفة الله.
لربما أيضًا هنالك بين أشعيا وحبقوق والخروج والمذود رابط مدهش يظهر فيه الحيوانان مُمَثِّلَين لبشريّة غبيّة تبلغُ، أمام الطفل وأمام ظهور الرّبّ الوضيع في المذود، إلى المعرفة.

الرعاة
هم الشهودُ الأوّلون لهذا الحدث الكبير، وكان من الطبيعي دعوتهم بالأوّل إلى المغارة، لأنّهم كانوا الأقرَب إلى الحدَث. وإذا ما نظرنا إلى طبيعة بيت لحم وما يُحيط بها من مراعي على بُعد أقل من كيلو متر واحد، أي في بيت ساحور، نتأكّد أنّ الرعاة كانوا الأقرب لمكان الحدَث.
ولكنّ هؤلاء الرعاة كانوا يتواجدون قريبين من الحدث "داخليًا" وليس "خارجيًّا" فقط، فكانوا أكثرَ قُربًا من المذود من أهل البلدة الّذين كانوا يرقدون بهدوء في بيوتهم المغلقة. كان الرعاة قريبين لأنّهم كانوا جزءًا من الفقراء، تلك النفوس البسيطة، الّذين باركهم يسوع. و"معرفة أسرار الله تُكشَف لهم" (لوقا 10: 21).
ولكنهم كانوا القريبين وأوّل مَن عرَف بالحدث لأنّهم ببساطة كانوا ساهرين، يقِظين، كانوا في "بيت السَّهَر" أي بيت ساحور. واليوم الرهبان هم أناس يسهرون، أي يُحيون الليل بالصلاة، يبقون يقِظين في هذا العالم النائم، ساهرين داخليًّا، بالانفتاح على نداء الله مِن خلال علامات حضوره.
أخيرًا، يٍمكننا أيضًا أن نفكِّر برواية اختيار داؤد ملكًا. فعندما وَصَل صموئيل النبيّ إلى بيت لحم قادمًا من بلدته راماتئيم صوفيم (أي رامالله اليوم)، اختار الأصغر سنًا بين أبناء يَسّى، وكان راعيًا للمواشي، ومِن غير اعتبار في عائلته. إذًا جاء داؤد مِن عند الخراف التي يرعاها ونُصِّب راعيًا لشعبه (2 صموئيل 5: 2). وبعد ذلك تنبَّأ النبيّ ميخا بأن سيخرج من بيت لحم مَن سيرعى شعب الله (ميخا 5: 1-3). إذًا وُلِدَ يسوع بين الرعاة، وهو راعي البشر العظيم (الراعي بالسريانيّة مثل العربيّة (رُعيو) ܪܥܝܐ وباليونانيّة (بويمنا) ποιμενα) (1 بطرس 2: 25 ، عبرانيين 13: 20).
أسرع الرعاة لرؤية الطفل. والسؤال هنا: مَن هم المسيحيّون الّذين يسرعون اليوم، عندما يتعلّق الأمر بقضايا الله؟ إذا كان شيء يستحقّ العَجَلة، فهي حتمًا قضايا الله.
المجد لله في العُلى
يقول لوقا إنّ الملائكة تكلّمت مع الرعاة لتبشِّرهم بميلاد المخلِّص، لكن كان واضحًا منذ البداية أنّ كلام الملائكة هو ترنيم. لكن ماذا أنشدوا؟ إنّهم يضمُّون مجد الله "في أعالي السماء" إلى سلام البشر "على الأرض" (لوقا 2: 14). استعادَت الكنيسة هذه الكلمات ونظَّمَت منها نشيدًا. ولكن يجب الانتباه هنا إلى ما يلي: فمجد الله ليس شيئًا يستطيع البشر انتاجه (ليكن المجد لله). فـ"مجد" الله موجود منذ الأزل. الخير موجود. الجمال موجود. هذه الحقائق موجودة في الله بطريقة لا يمكن افناؤها.
ولكن الخلاف الأكبر هو على ترجمة القسم الثاني من نشيد الملائكة: "الناس ذوي الإرادة الحسنَة". في اليونانيّة نجد بعد كلمة الناس الكلمة (إيذوكياس) ευδοκιας والتي تعني "الإرادة الحَسَنة" أو الّذين هم في عطف الله ومحبته (كما نجدها في فلبي 1: 15). في العهد الجديد السرياني (الترجمة البسيطة) لا نجد هذه الإضافة "ذوي الإرادة الحسَنة" بل نجد الآية كالتالي: "والرجاء الصالح لبني البشر." (وصبروا طوبو لبنَي أنوشو) ܘܤܒܪܐ ܛܒܐ ܠܒܢܝ ܐܢܫܐ.
إن عُدنا إلى النصّ اليوناني وترجمته اللاتينيّة، فإننا نصطدم بالسوؤال التالي: أيّ ناس هم ذوي الإرادة الحَسَنة أو الّذين في عَطفِ الله ومحبته؟ ولماذا؟ هل يوجد مَن لا يحبّهم الله؟ ألا يُحبّهم جميعًا كخلائقه؟
في حدَث عمّاد السيد المسيح جاء صوت الآب يقول "أنت ابني الحبيب بك ارتضيتُ." (أو سُرِرتُ) (لوقا 3: 22) إنسان المسرّة أو الرضى هو يسوع المسيح، وهو كذلك لأنّه متّجه كلّيًا نحو الآب، يعيش وهو يتطلّع إليه. في شراكة إرادة معه. والناس الّذين هم أهل مسرّته ورضاه هم مَن يتّخذون نفس موقف الابن. يتماثلون والمسيح.
ولكن، ما وراء الاختلاف في الترجمات يُطرح السؤال حول نعمة الله والحرّيّة الإنسانيّة، ويمكن للبشر أن يتّخذوا موقفَين متطرِّفَين: الأوّل حول فكرة شموليّة عمل الله المطلقة، فكلّ شيء يتوقّف على قضاء الله الأبديّ؛ بينما الموقف الثاني يقول إنّ كلّ شيء يتحدّد بحسب إرادة الإنسان الحسَنة. ولكن يجب أن نقول أنّ أيًّا مِن الموقفَين المتطرِّفَين غير مقبول، بل إنّ النعمة والحرّية يتداخلان. فصحيح أن نقول بأنّ الإنسان لا يستطيع أن يُحبّ إن لم يكن قد أحبّه الله أوّلًا. فنعمة الله تسبقنا دائمًا، وتضمُّنا وتدعمنا. ولكن صحيح أيضًا أن نقول بأنّ الإنسان يجب أن يُشارك بإرادته وبحرّيته في محبة الله هذه. فهو ليس مجرّد أداة، مِن غير إرادة شخصيّة أمام قدرة الله اللامتناهيّة، بل يستطيع أن يُحبّ بالاشتراك في حبّ الله، كما أنّه يستطيع رفض هذا الحبّ.

عيد الميلاد أو الإبيفانيا في الليتورجيا الأورشليميّة القديمة
نحن هنا في القرن الرابع في فلسطين، وبالتحديد في السنوات بين 383-385، ولربما كانت آخر سنوات الأسقف كيرلُّس الأورشليمي، حنما زارت الحاجّة إيجيريا من فرنسا-إسبانيا الشرق ومكثت في فلسطين مدة ثلاث سنوات، تصف في مذكّراتها الثمينة ما تشاهده مِن احتفالات ليتورجيّة في مختلف الأماكن المقدّسة، وخاصّة في كنيسة القيامة، قلب هذه الاحتفالات النابض.
وقد وصَفَت كافة احتفالات السنة الليتورجيّة، وعندما تصل إلى احتفالات الميلاد نجد أنّ جزءًا مهمًّا من الصفحات مفقودًا مع الأسف، ولا نجد سوى المقطع الّذي يصف وصول الإكليرُس والرهبان والمؤمنين إلى المدينة المقدّسة، عائدين مِن بيت لحم. لذلك نأخذ المعلومات حول هذا العيد مِن كتاب القراءات الأرمني وكتاب القراءات الجيورجيّ. ومن هذين الكتابين يمكننا أن نُعيد بناء هيكليّة ليورجيا هذا العيد، والّذي كان يجري في ثلاث محطات في بيت لحم: الرعوات فالمغارة وكنيسة المهد، وهناك محطة رابعة في المدينة المقدّسة، في المارتيريوم، نهار العيد، وهي المركزيّة.
يبدأ الاحتفال بسهرونيّة العيد في 5 كانون الثاني، (إذًا لم يكن العيد في القرن الرابع معروفًا بعد في فلسطين على أنّه عيد الميلاد في 25 ديسمبر) وذلك كافتتاحيّة للاحتفاليّة هذه، فيجتمع الإكليروس والمؤمنون مِن المدينة المقدّسة وبيت لحم في الساعة الرابعة بعد الظهر، ويقيمون رتبة قصيرة جدًا في حقل الرعوات. وتُفتَتَح هذه الرُّتبة بالمزمور 22 الّذي يُرنَّم مع أنتيفونته، ثمّ المزمور 79، الّذي يُرنَّم مع هللويا، وأخيرًا يُتلى إنجيل القديس لوقا (2: 8-20).
وفي المحطّة الثانية، وهي مغارة الميلاد، تُقام الرتبة عينها كما في المحطّة الأولى: مزمور 2، كمزمور للدخول، ومزمور 109 مع هللويا. وتنتهي الرُّتبة بتلاوة إنجيل القديس متى، الّذي يروي الأحداث العجائبيّة المرتبطة بميلاد السيد المسيح في المحطّة الثالثة.
في المحطة الثالثة، في كنيسة المهد التي فوق المغارة، نجد الطقوس الأطول: حيث السَّهرونيّة الليليّة، والتي تُفتَتَح بالمزمور 131، وفيها إحدى عشرة قراءة من غير الإنجيل. في نهاية السَّهرونيّة يُحتَفَل بالذبيحة الإلهيّة، كما في عشيّة الفصح. ومع نهاية القدّاس، تفترِق جماعة أورشليم عن جماعة بيت لحم عائدة إلى المدينة المقدّسة وهم يرنِّمون نشيد زكريا "مبارك الرَّبُّ إلهنا". وهنا تبدأ إيجيريا، بالحديث، وذلك بعد صمت، وتقول إنّ المؤمنين لا يَصِلون إلى المدينة المقدّسة "إلّا في السَّاعة التي نبدأ فيها تمييز بعضنا عن بعض، أي عند الفجر، ولـمّا يطلع النهار بعد"، وذلك أن الرهبان الراجلين كانوا يسيرون الهوينا (25، 6).
في المحطّة الرابعة، وهي الأخيرة، التي تتمّ في المدينة المقدّسة في كنيسة الـمَرتيريون، يصل الأسقف، ومعه الجماعة الأورشليميّة، مِن بيت لحم إلى المدينة المقدّسة، فيَدخلون أولًا إلى كنيسة القيامة، وهناك يتلون مزمورًا وصلاة. ثمّ يبارك الأسقف الموعوظين أولًا، فالمؤمنين مِن بعد ذلك. بعد ذلك ينسحب الجميع، عائدين إلى منازلهم، لكي يستريحو، ما عدا الرهبان، الّذين يبقون ينشدون الترانيم حتى طلوع النهار (25، 7). ويجتمع الجميع مِن جديد، عند الساعة الثانية، للاحتفال بمراسم هذا اليوم، أي عيد الظهور الألهي، في الكنيسة الكبرى (الـمَرتيريون)، حيث تُقام الذبيحة الإلهيّة.
وتصف إيجيريا لراهباتها بهاء الكنائس الّتي كانت تتوشّح به في ذلك اليوم العظيم، في كلٍّ مِن المدينة المقدّسة وبيت لحم، ممّا يُبرز أهمّيّة هذا الاحتفال، فتقول: "إنّه لمِنَ النافل أن أصف لكنَّ زينة الكنيسة في ذلك اليوم، أفي القيامة، أم في الجلجلة أم في بيت لحم. فلا يُرى إلّا ذهبٌ وحجارةٌ كريمة وحرير: السُّجوف كلُّها مِن الحرير الموشَّى بالذَّهَب؛ والستائر أيضًا مِن حرير موشَّى بالذَّهَب؛ والأواني المقدّسة، على أنواعها، التي تُستَخدَم في ذلك اليوم، هي مِن ذَهبَ مرصَّع بالحجارة الكريمة. أمّا عدد ووزن قناديل الشمع، والشمعدانات والمصابيح وسائر الأواني المقدّسة فأنَّى لي أن أحصيها وأصفها؟ (25، 8).
وعند الفحص الدقيق للمصادر حول أصول ومعنى هذَين العيدَين، يَظهر جليًّا أنّ العيدين معًا كانا يشكِّلان احتفالًا واحدًا لنفس الذكرى: الاحتفال بسرِّ ظهور الله في المسيح يسوع، وليس لأحداث تاريخيّة معيَّنة. أمّا الحدَث فكان الوسيلة التي بواستطها يُظهر السرُّ الإلهيّ نفسه مُستخدِمًا مثل هذا السيناريو لغرض التذكار الليتورجيّ. لذلك نرى أغسطينُس لا يُضفي صفة "السرّ الإلهي" على عيد الفصح فقط، أمّا باقي الأعياد فهي ليست بدرجة السرّ بل هي فقط "تذكاريّة mémoriaux (الرسالة 55). ولكن البابا لاون الكبير كان قد وسَّع مفهوم "السر الإلهي" ليشمل أيضًا تذكارات أخرى لسرِّ ربِّنا يسوع المسيح، كما ذكرنا مسبقًا. ويقول رينو أيضًا إنّ الهدف مِن تنقِّل جماعة القدس إلى بيت لحم" فلا يمكن أن يحصل إلّا لصلة هذا العيد مع الاحتفال بسرّ المسيح“.
الاحتفال الأصيل بعيد الظهور الإلهيّ في المدينة المقدّسة كان يبدو متعلِّقًا ومرتكزًا فقط على ميلاده، على الأقل هذا ما أوصلته إلينا إيجيريا وكتاب القراءات الأرمني أيضًا. لذلك تُعتَبَر المدينة المقدّسة الوحيدة مِن بين مختلف التقاليد الشرقيّة المتعدِّدة، في القرن الخامس، التي لم تُماهي عيد الظهور الإلهي بعيد عمّاد الرَّبّ، بل بميلاده، أي بذكرى ظهوره في الجسد، وهذا بالضبط ما تعنيه الكلمة "إبيفانيّا" ἐπι?άνεια باليونانيّة. ويبدو أنّ الكنيسة الأورشليميّة كانت قد تبَّنَت عيد الميلاد الغربيّ واعتمدته في 25 ديسمبر، وذلك لفترة وجيزة، في منتصف القرن (أي بعد مجمع أفسس). ولكن، فقط مع نهاية القرن السادس (كما يشهد على ذلك كتاب القراءات الجورجيّ) تمّ إدخال هذا العيد نهائيًّا إلى رزنامة المدينة المقدّسة.
ويُقدّم أحد الرحّالة من القرن السادس، وهو كوزماس إِنديكوبلويستِس (Κοσμᾶς Ἰνδικοπλεύστης) شهادة على ذلك ويقول في عيد الميلاد في المدينة المقدّسة، إنّه في اليوم الّذي يُحتَفَل فيه، بشكل عام، بعيد الميلاد، أي في 25 ديسمبر، فإنّ الكنيسة الأورشليميّة كانت تحتفل بعيد القديسَين داؤود الملك ومار يعقوب، أخي الرّبّ. لذلك كانت صهيون تُشكِّل محطّةً في 25 ديسمبر، لأنّ هناك كان يوجد كرسيّ مار يعقوب، لا بل بيته أيضًا، كما كان يُعتَقَد.