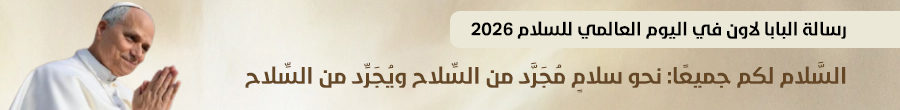موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

ترأس الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بطريرك القدس للاتين، القداس الإلهي بمناسبة الاحتفال بسبت النور (العشيّة الفصحيّة) وذلك أمام القبر الفارغ في كنيسة القيامة، بمدينة القدس، بمشاركة لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنين.
وفيما يلي النص الكامل لعظة غبطته:
أيُّها الإخوة والأخوات الأعزّاء،
ليكن سلام الرب معكم!
نفعل اليوم كما فعلت النّساء اللواتي أتين باكرًا ليدهنّ جسد يسوع. رأين أن الحجر قد دُحرج عن القبر، وأن القبر فارغ، فتساءلن عن معنى ما حدث (لو 24، 4). ونحن أيضًا نتساءل عن ذلك. نتساءل عن معنى ما جرى هنا بالضّبط، قبل ألفي عام: ما معنى قيامة يسوع بالنسبة إلينا؟ ماذا تُضيف إلى وجودنا، لا سيّما في هذا الزمن الذي يبدو فيه كلّ شيء ينطق بعكس ذلك، ينطق بالموت والظّلام؟
قراءات هذه العشية تسندنا وتُنيرنا: ينبغي أن نبحث عنها في صفحات الكتاب المقدّس، تمامًا كما دعا الملائكةُ النّساءَ إلى ذلك "تذكّرنَ كيف كَلَّمكنَّ وهو بعد في الجليل" (لو 24: 6). إنّهم يدعونهنّ إلى تذكُّر كلام يسوع، إلى استحضار الكلمة. وهذا بالضبط ما تدعونا إليه هذه العشية: أن نستحضر الكلمة، وتاريخ الخلاص الطويل الذي يقودنا إلى هذه الليلة.
لقد أصغينا إلى تاريخ وعدٍ طويل بالحياة. وعد من الله، الذي خلق العالم بهدف واضح: أن يبرم عهدًا مع الإنسان. بدأنا من الخلق، ثمّ تتبّعنا تاريخًا كاملاً دُعيَت فيه الإنسانيّة إلى قبول عطية العهد مع الله، وأن تتحمّل مسؤوليّة هذه العطيّة.
هو تاريخ مليء بالاختيارات والسّقطات، لكنه يبدأ من جديد في كلّ مرة، وله ميزة خاصة: حين يبدو أنّ كلّ شيء قد انتهى ولا مخرج بسبب قسوة قلب الإنسان، يتدخّل الله ويمنح شيئًا جديدًا: يمنح الحياة، يمنح الحرّية، يمنح الشّريعة، يُعيد ترميم العلاقة التي تحطمت. يعيد الإنسان إلى الطريق، ويُرجع له القوة والرجاء، ويمنح الناس الثقة بأنّه يسير معنا وبيننا (راجع خر 13: 21).
هذا التاريخ يبدأ، كما قلنا، مع الإنسان المخلوق على صورة الله ومثاله، المخلوق ليُشِعَّ من مجده. خُلِق بكرامة عالية جدًّا، وحرّية لا حدّ لها. "دونَ الإلٰهِ حَطَطتَه قَليلًا، بِالمَجدِ والكَرامةِ كلَّلتَه" (مز 8: 6). ومع ذلك، لم يكن هذا كافيًا. فالإنسان، بدلاً من أن يُشِعَّ المجد الذي أعطاه الله، وبدلاً من البقاء في طاعة البُنُوَّة لله –وهي مصدر الحرّية الحقيقيّة– اختار أن يتّبع أوهام إبليس، فعرف الموت وغياب الله. اختار ذاته بدلًا من الله، فانغلق داخل آفاق ضيّقة. وبالخطيئة، رفض الإنسان أن يعيش كابن، فضاع.
قراءات العشية تقودنا إلى هذه العتبة، إلى هذه اللحظة الدراميّة: لقد فقدنا القدرة على التشبه بالله، لكنّ الله وحده قادر أن يمنحنا قلبًا جديدًا قادرًا على العيش بحسب مشروع الحياة الصّالحة الذي وُضع بين أيدينا. وهكذا فإنّ آخر قراءة من العهد القديم، قراءة نبيّ حزقيال (حز 36: 26-28)، تروي قرار الله بتغير الإنسان من العمق، وشفاء قلبه، وصنع شيء جديد لا يستطيع الإنسان أن يفعله بمفرده. لكي يُعيد للإنسان القدرة على التشبه به، يجب أن يمنحه قلبًا جديدًا: لا تكفي الطهارة الخارجيّة، ولا تكفي مغفرة الخطايا، لأنّه إذا لم يتغيّر القلب، سيبتعد الإنسان من جديد وسيفقد مرّة أخرى القدرة على التشبه بالآب.
يسوع، الكلمة التي بها خلق الله العالم والإنسان، هو طبيب النّفوس، من يستطيع أن يُعيد بناء تلك الصّورة الأولى التي تلطّخت. هو الذي يستطيع أن يمنحنا قلبًا جديدًا.
ومع ذلك، قد يبدو لنا في البداية أنّ موت يسوع قد وجّه ضربة قاسية لذلك الوعد بإعادة تشكيل صورتنا على مثال الله، وكأنّه توقّف في لحظة معيّنة من التاريخ: يسوع، مُتمّم الوعد، آمين الآب، قُتل ووُضع في القبر. لقد حدث أن يسوع، الذي أتى ليُظهِر للإنسان من جديد حبّ الآب المجّاني، الذي "مَضى مِن مَكانٍ إِلى آخَر يَعمَلُ الخَيرَ ويُبرِئُ جَميعَ الَّذينَ ٱستَولى علَيهم إِبليس" (راجع أع 10: 38)، قوبل بعدم الفهم والرّفض من قِبَل خاصّته. خانوه، أنكره البعض، باعوه، سلّموه، استهزؤوا به، عذّبوه، صلبوه، قتلوه. بشريًّا، انتهت حياته بأسوأ أنواع الفشل.
لكنّنا نؤمن أنّ صباح القيامة جلب لنا حدثاً عظيمًا. النساء ذهبن إلى القبر يبحثن عن يسوع في مملكة الموت، في مكان لا يشبهه، في مكان البُعد عن الله. ولكن ذلك المكان المليء بالموت كان خاليًا. وبدلًا من جسد يسوع، وُجد رجلان بثياب برّاقة يُعلنان أنّ يسوع حيّ (لو 24: 5)، يُعلنان أنّ الإنسان الجديد قد وُلِد.
سلّم يسوع نفسه، وتركهم يقتلونه، ولم يدافع عن نفسه، ولم يخضع للحظة لمنطق العنف. ولم يفعل ذلك عن ضعف، بل عن ثقة. سلّم حياته للآب، وآمن حتّى النّهاية بأنّ الآب سيحفظها. في هذا الابن، الذي بقي متمسّكًا بالوعد وأحبّ حتّى النّهاية، رأى فيه الآب تحقيق صورته ومثاله، فقد أعادها إلى ما كانت عليه سابقًا.
هذا هو الإعلان الذي أرغب بتكراره مرّة أخرى، أوّلًا لنفسي، ثمّ لنا جميعًا هنا، وللكنيسة كلّها.
كلّ شيء هنا اليوم يبدو وكأنّه يتكلّم عن الموت والفشل، كما حصل مع يسوع. وربّما نحن أيضًا الآن مثل النساء في الإنجيل، مملوءين خوفًا، أعيُننا نحو الأرض (لو 24: 5)، ولهذا لا نستطيع أن ننظر أبعد، منغلقين على أنفسنا ومحاطين بالألم والعنف. نضيع في تحليلات وتقديرات كثيرة، وتوقّعات للحالة الدراميّة التي نعيشها. ونستمرّ في تأسيس رجائنا على اختيارات السياسة والمجتمع والحياة الدينيّة، التي تثبت كلّ مرّة عدم قدرتها. ننغلق على أنفسنا، في نفس الآفاق الضيّقة المعتادة، غير القادرة على إعطاء حياة، أو خلق جمال، لأنّ الخوف لا يستطيع أبدًا أن يعطي الحياة، فلا نور فيه، ولا يستطيع أن يخلق شيئًا جميلاً. "لماذا تطلبن الحيّ بين الأموات؟ ليس هو ههنا!" (لو 24: 5). طالما نحن منغلقون داخل مخاوفنا، سنكون مثل نساء الإنجيل، نبحث عن يسوع في غير مكانه، في قبورنا.
فلنطلب إذًا من يسوع أن يدخل مرّة أخرى إلى قبورنا هذه، ويُخرجنا منها إلى النّور، ويمنحنا تلك الحياة التي نَعطش إليها، ويمنحنا قلبًا جديدًا قادرًا على الثقة والعطاء.
فلنُحيِ في ذاكرتنا ما فعله الربّ من أجلنا، ولنرفع أنظارنا إلى ما يواصل فعله اليوم، من خلال أولئك الذين ينهضون رغم الظلمة، والذين لا يزالون، وسط هذا الليل الثقيل، قادرين على العطاء والثقة. إنهم يشعون نورًا في عتمة العالم، ويُعيدون في كلّ يوم، بصبرهم ومحبتهم، صورة الله في قلب الإنسان. فلنطلب أن يعود قلبنا إلى الخفقان من جديد، بالحياة، بالثقة، بالعطاء، وبالمحبّة.
هذا هو معنى قيامة يسوع بالنّسبة لنا، وهذا هو معنى الفصح، في كلّ زمان، حتّى اليوم، وهذا ما نحتفل به اليوم: أمانة محبّة الله، المحبّة التي تتجاوز حدود الموت، والتي تُعيد إلينا كرامة أبناء الله، أحرارًا ومحبوبين إلى الأبد.
فصح مجيد!
 البطريرك بيتسابالا في رسالة الميلاد 2025: المحبة بلا حدود هي ما يحتاجه عالمنا اليوم
البطريرك بيتسابالا في رسالة الميلاد 2025: المحبة بلا حدود هي ما يحتاجه عالمنا اليوم