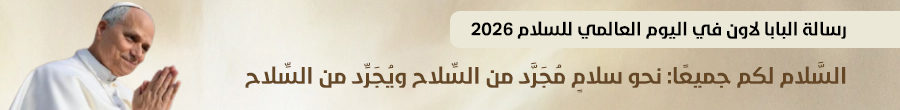موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

أصدر الأب الدكتور ريمون جرجس الفرنسيسكاني، المتخصّص في القانون الكنسيّ، كتاب جديد من جزئين بعنوان: "الزواج والعائلة"، وهو عبارة عن دراسة تحليليّة لاهوتيّة وقانونيّة على ضوء الإرشاد الرسولي لما بعد السينودس "فرح الحب"، وتقع في 1700 صفحة.
ووجّه البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي رسالة بركة رسوليّة هنأ في بدايته الأب جرجس على كتابه الجديد الذي يُضاف إلى العديد من الكتب القانونيّة والراعوية التي أصدرها سابقًا. ولفت إلى أنّ عنوان الكتاب الجديد يوضّح أبعاده ومضامينه، وقد شاءه الأب ريمون "بمناسبة السنة المكرّسة للإرشاد الرسوليّ ’فرح الحبّ‘، فاكتسى الإرشاد ثوبه الناصع البياض، وحرّرته من الشوائب التي لطّخه بها منتقدوه، فوجد فيها الصحافيّون السلبيّون مادّة دسمة لكتاباتهم. أنت بدراستك أضعفت هذه المادّة وفكفكتها".
وخاطب البطريرك الراعي الأب ريمون بالقول: "أشكرك لأنّك تقدّم لرعاة الكنيسة، أساقفة وكهنة، وللقضاة والمحامين ومعلميّ اللاهوت الأدبيّ والقانون والباحثين، دليلًا راعويًّا ولاهوتيًّا وقانونيًّا. إنّك في فصوله الإثني عشر تعالج موضوع الزواج والعائلة من كلّ الجوانب، مقتبسًا من مصادر ومراجع عديدة مختلفة ومتكاملة. أشكرك على الجهود والساعات والأيّام والأشهر التي ضحّيت بها وكرّستها لإخراج هذا الكتاب بأسلوب علميّ فأودّ أن أسمّيه "موسوعة الزواج والعائلة". كافأك الله عليها بفيض من نعمه".
أضاف: "أتمنّى أن يلقى كتابك رواجًا واسعًا هو يستحقّه تمام الإستحقاق، فيكون ليس فقط في المكتبات، بل بين أيدي الأساقفة والكهنة، لأنّه حاجة لهم راعويّة وتدبيريّة وإرشاديّة وتعليميّة؛ ويكون بين أيدي القضاة الذين يتحمّلون مسؤوليّة إجراء الأحكام باسم الله العظيم بشأن صحّة الزيجات أو بطلانها؛ وبين أيدي معلّمي القانون لأنّ في كتابك لا يوجد التعليم القانونيّ وحسب، بل توجد فيه أيضًا مصادره الكتابيّة واللاهوتيّة؛ وبين أيدي المحامين المطلوب منهم أن يدافعوا عن الحقيقة، فحقل قانون الزواج "أرض مقدّسة"، لا يحقّ لهم أن يبتكروا "حقائق" غير صحيحة وغير مستندة على الواقع، ويدافعوا عنها. إنّ من يقرأ فصول كتابك، "موسوعتك"، يشعر برهبة مقدّسة أمام مضامينه اللاهوتيّة والروحيّة والقانونيّة".

الأب د. ريمون جرجس الفرنسيسكاني
وفيما يلي النص الكامل لمقدّمة الكتاب الجديد:
تعي الكنيسة أنَّ، في هذا العالم، هناك فقدان للقيم المسيحيَّة، وهناك مشاكل بشأن كرامة الزَّواج وصعوبات تؤثر على مؤسّسة العائلة، وتفهم بأنَّها "تشوّهات" لطبيعة العائلة الحقيقيَّة. ويمكننا القول إنَّ هناك نماذج معاديَّة للزَّواج في مجتمعنا. من جهة، هناك ثقافة لمنع الحمل تحاول فرض نفسها ضد رؤية للجنس مرتبطة بالمسؤوليَّة والخصوبة؛ ووجود مفهوم الحريَّة الَّذي يتعارض جذريًّا مع إمكانيَّة الالتزامات مدى الحياة يجعل تكوين الرضى الزَّوجيّ الحقيقيّ أكثر صعوبة، في مواجهة هذه الثقافات. غالبًا ما تجد العائلة نفسها بدون أسلحة للدفاع عن حقيقتها، وبالتّالي من الضروريّ أن تبذل الكنيسة بأكملها -الرعاة والمؤمنون- جهدًا لإعادة اكتشاف حقيقة الزَّواج والعائلة.
منذ أن نشر البابا ليون الثَّالث عشر رسالته العامّة Arcanum divinae عن الزَّواج المسيحيّ في عام 1880، ظلّت القضايا المتعلقة بالجنس والعلاقات الحميميَّة والزَّواج والحياة الأسريّة تشغل بال الكنيسة الكاثوليكيَّة في كل انعكاساتها الداخليَّة وتواصلها مع العالم والثقافة المحيطين بها. كانت خصوصيَّة هذه الفترة من تاريخ الكنيسة هي أنَّ الخطاب الكنسيّ الداخليّ ينأى بنفسه، بشكل متزايد،عن الأنماط الاجتماعيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة التي بدأت تهيمن على خيارات الحياة العلائقيَّة، في المجتمعات الحديثة.
الدستور العقائديّ "فرح ورجاء" وثيقة مجمعيَّة تتعلق بعلاقات الكنيسة مع العالم، التي شهدت تغيّرات في المفاهيم حول الزَّواج والعائلة مستوحاة من تعاليم البابا يوحنَّا الثَّالث والعشرين الواردة بالفعل في Mater et Magistra، وانطلاقًا من الدستور الرعويّ "فرح ورجاء" الَّذي شهد الكنيسة تتحدث عن الإنسان في العالم المعاصر، هو بالتأكيد فرصة ثمينة لإلقاء الضوء على القيم التي تمّ تقديمها بشكل نبويّ واقتراحها "إلى العائلة البشريَّة بأكملها" (عدد2). فقد تناول وجهات نظر مختلفة، ويشكل المنظور الأنثروبولوجيّ. ويدعو تحديد "الأزمة" التي تمر بها العائلة اليوم، "أزمة النمو" (عدد 4) وإلى إعادة التأكيد على القيمة الإيجابيَّة للحبّ البشري والجنس وإعادة اكتشاف وجه الرجل / المرأة "كجسد واحد" مع التمييز الجنسيّ لشخصهما. ما تتعرض له العائلة اليوم، بسبب الهجمات الثقافيَّة والاجتماعيَّة والأيديولوجيَّة المستمرة، تقوّض أسسها. حتى إنَّ خطر فنائها ليس فرضيَّة بعيدة المنال. في المقام الأوَّل، من الممكن اكتشاف أزمة أنثروبولوجيّة حقيقيَّة ذات عواقب محددة في الحياة العاطفيَّة وفي إقامة علاقات عائليَّة مستقرة. هذا الوضع يؤدي إلى نظرة سلبيَّة ومتشائمة لمشروع العائلة، حيث غالبًا ما تفسَّر صعوبات التعايش على أنّها كسور لا يمكن إصلاحها. أمام هذا "الواقع غير الواقعيّ"، يصبح من الأولويات -كما يقترح الكاردينالCaffarra - إزالة "إعتام عدسة العين من الأيديولوجيات" من أعين القلب التي تمنعنا من إدراك "الواقع الحقيقيّ"، أي إعادة اكتشاف الأدلة الأصليَّة على الزَّواج والعائلة. تحقيقًا لهذه الغاية، يجب أنَّ نظهر العائلة بدءًا من نموذج الحبّ الزَّوجيّ وتعليم قلوب الأبناء حتى يتمكنوا من تعلم الحبّ، وهو جانب رئيسيّ من جوانب تعليم العائلة. تتطلّب مهمة مرافقة العائلات تجديد اللغة والأدوات للمساعدة في أوقات الصعوبة، وكذلك الأشخاص المستعدين بشكل كافٍ للتدخل في النزاعات، وفقًا لطبيعة العلاقات الأسريّة.
الزَّواج –كما يقول البابا بولس السادس-"ليس نتيجة تطور لقوى طبيعيَّة وتطور اجتماعيّ وثقافيّ خاضع للتغيرات" ولا إلى القوانين البيولوجيَّة وحدها، "أو وليد مصادفة أو نتيجة تنامي قوى طبيعيَّة عمياء"، "إنما هو مؤسس بشكل حكيم وبالعناية الإلهيَّة من الله الخالق ليُحقق مخطّطه المحبّة في البشريَّة، بواسطة العطاء الشخصيّ المتبادل، يهدف الزَّوجين إلى شراكة شخصيّتهما، يكتملان بشكل متبادل لكي يتعاونا مع الله في الإنجاب وتنشئة كائنات جديدة"، وهي، أيضًا، حقيقة من حقائق الخلق يندرج ضمن نظام الخلاص، فلا يعتمد على اللقاء الحُرّ بين الرجل والمرأة فقط، وإنما على الإرادة الإلهيَّة التي لم تترك للإرادة البشريَّة حريَّة حلّه أو استمراره بحسب هواهما، وإنما تركت لهما حريَّة تشكيل وتحقيق الوثاق الزَّوجيّ. فليس في إمكان أي سلطان بشري أن يعوّضه؛ وبقوة الشَّرع الإلهيّ، هذا اللقاء يجب أن يكون غير قابل للانحلال.
الزَّواج -كما يقول التعليم المسيحيّ للكنيسة الكاثوليكيَّة- "ليس مؤسسة بشريَّة بحتة؛ [...] على الرغم من أنّ كرامة هذه المؤسّسة لا تتألق في كل مكان بنفس الوضوح، إلا أنه يوجد، في جميع الثقافات، شعور معيّن بعظمة اتحاد الزَّواج". يُؤكّد أنّه، في جميع الثقافات، الاتّحاد الزَّوجيّ "يشكّل الشكل الأوّل من شركة الأشخاص". إنّه اتحاد لا يعتمد بطبيعته ومدته على إرادة الإنسان، ولا على تشريعات بشريَّة مشروطة، ولا نتاج مسار تاريخيّ، ولا ينشأ عن تطورات اجتماعيَّة أو ثقافيَّة. مؤسّسه "الله نفسه". لقد تمّ تأسيسه وتحديده وتشكيله في بنيته الثَّابتة، الصالحة لجميع الأزمنة والأماكن، الخالق، الَّذي -كما يلاحظ بولس السادس- صوّرها وأسّسها "بحكمة وعناية لتنفيذ خطته في إنسانيَّة الحبّ". هذا الرَّباط المقدس، الَّذي فكّر فيه الله، لا يعتمد على قرار الإنسان بل على مؤلف الزَّواج (الله نفسه)، الَّذي أراد أن يُمنح له خيرًا وأهدافًا خاصّة به. الله نفسه هو مؤسّسة الزَّواج. يجب البحث عن أصل الإنسان في الله، وكذلك أصل مؤسسة الزَّواج الخاصّة جدًّا. شدد المونسنيور Funghini في خطابه إلى الأب الأقدس بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2002، على أن الإنسان المعاصر يعتبر الزواج "وليدة ثقافة وحضارة".
هذه الصعوبات نفسها هي التي دفعت الكنيسة إلى التعمّق في رسالتها التي هي في صميم اتحاد العائلة: "البشرى السارة عن العائلة"، تمامًا من منطلق مخطّط الله. فعندما تكون العائلة مخلصة لنفسها، فإنّها تشهد على ديناميتها الخاصّة والأمل الَّذي تحمله. لهذا السبب، تأمل الكنيسة أن تعرف كيف تبقى "في" العالم المعاصر، وكيف تعلن نبويًّا رسالتها من منطلق مخطط الله. "تتعلق البشارة الجديدة بالعلاقة المعاصرة مع الإنجيل، في جوهره ووساتطه مع العالم، والتاريخ وحياة الرجال والنساء عصرنا". لذلك فإن عمل التمييز ضروريّ في اتجاهين: أوّلاً، يتعلق الأمر بالتجذّر في واقع السياق الاجتماعيّ والثقافيّ المعاصر، وإدراك التحولات الجارية وإبراز هشاشة وقوة التجربة الإنسانيَّة المعاصرة. إنّه جهد تفسير "علامات العصر" (متى 16: 3)، ليس فقط بالتحليلات الأكثر وفرة وتفصيلاً للعلوم الإنسانيَّة، ولكن بعيون الإيمان، "في نور الإنجيل والخبرة البشريَّة، أي مع النظرة الهادفة إلى "اعتراض شروط الوصول إلى الإيمان بالإنسان"، تحت طائلة عدم القدرة على إيصال إنجيل يسوع وبالتالي نقل إيمان. ثانيًا، يجب على الكنيسة أن تجدّد نفسها بإعلان الإنجيل بطريقة تتناسب مع احتياجات الوقت الحاضر، حتى يتألق مركز البشارة المسيحيَّة بشكل أوضح: "الله محبّة" (1يو 4، 16).
إنَّ مهمّة الكنيسة هي إعلان كلمة الله باسمها وبسلطتها وتحديد معناها عندما تصبح ضروريَّة. والتفكير حول عمل الكنيسة هو، بالتأكيد، انعكاس لرسالة الكنيسة، باعتبارها استمرارًا لرسالة المسيح. ولكنّ هذه المهمة دائمًا ما يتمّ تحديدها تاريخيًا وثقافيًا. بتعبير أدقّ، يمكننا أن نقول إنَّ الكنيسة تتلقى تفويضها من المسيح، ولكن، في نفس الوقت، أيضاً ضمن السياقيْن الثقافيّ والتاريخيّ الَّلذين توجد فيهما. فالجهود التي تبذلها الكنيسة في سبيل مواكبة الواقع المعاصر لها جذور تاريخها الحديث، فهي "تقاسم الأفراح والآمال والأحزان والقلق، خصوصًا في إشارة إلى الفقراء وإلى أولئك الَّذين يعانون (رقم1). وبالتّالي، "من واجب الكنيسة الدائم أن تفحص علامات العصر وتفسرّها في ضوء الإنجيل [...] من الضروريّ بالفعل معرفة وفهم العالم الَّذي نحن نعيش فيه (رقم 4).
في الواقع، تعي الكنيسة أنَّ من واجبها "أنجلة الثقافات وانثقاف بلاغ الإيمان، من خلال دعوتها أوّلاً إلى اللقاء مع الله-والإنسان معاً لكي يستطيع الإنسان اكتشاف حقيقة ذاته وإيجاد الأسس لإعادة وضع القواعد الأنثروبولوجيّة الإيجابيَّة، وأنّ ما يضعه الإنسان بحق في الزَّواج والعائلة من آمال لا يتحقق إلا بقبول الإنجيل". ولكن كيف يمكننا إعلان "الإنجيل" للرجال والنساء الَّذين يبدو أنّهم يبتعدون أكثر فأكثر عمّا يقترحه الإنجيل؟ ما هي المعايير التي يجب أن توجّه تصرفات الكنيسة في ما يتعلق بفشل الزَّواج، وبشكل أعمّ إلى حالة الهشاشة التي يمر بها نسيج العائلة؟ يُفهم أنَّ هذا تحدٍّ حقيقيّ من خلال اختيار البابا بنديكتوس السادس عشر تأسيس المجلس الحبريّ لتعزيز التبشير الجديد، في 21 أيلول 2010، "في خدمة الكنائس الخاصّة، ولا سيما في مناطق التقليد المسيحيّ. حيث تتجلّى ظاهرة العلمنة". وفي الرسالة الأخيرة الصادرة في ختام الجمعيَّة العامّة الثَّالثة عشرة للسينودس، في 26 تشرين الأول 2012، خصّص البابا، بالفعل، قسمًا كاملاً لموضوع العائلة، قال: "إنَّ التبشير الجديد لا يمكن التفكير فيه بدون الشعور بالمسؤوليَّة الدقيقة تجاه إعلان الإنجيل للعائلات وبدون دعمهم في المهمة التربويَّة". وأكّد الأساقفة أنّه، على الكنيسة، في ضوء التبشير الجديد، أن تسعى، برعاية الوالديَّة والروح الإنجيليَّة، إلى حلول مناسبة للمشاكل الراعويَّة التي يثيرها وضع المطلّقين والمتزوجين وأطفالهم، والأزواج المهجورين والمتساكنين، وبشكل أعمّ، ميل مجتمعنا إلى إعادة تعريف الزَّواج. ينبغي على الكنيسة، برعاية الأم والروح الإنجيلية، أن تبحث عن استجابات مناسبة لهذه المواقف، باعتبارها جانبًا مهمًا من جوانب التبشير الجديد".
من بين الهبات التي منحها المسيح لكنيسته، هبة التعليم: «فاذهَبوا وتَلمِذوا جَميعَ الأُمَم، وعَمِّدوهم بِاسْمِ الآبِ والابْنِ والرُّوحَ القُدُس، وعَلِّموهم أَن يَحفَظوا كُلَّ ما أَوصَيتُكُم به، وهاءنذا معَكم طَوالَ الأَيَّامِ إِلى نِهايةِ العالَم" (متى 28، 19-20). لطالما كانت الكنيسة مدركة أنَّ عليها واجب نقل الحقيقة التي تلقّتها من الله والتي لم ينتجها بحثها. ولهذا السبب، كان التأمل والدراسة يرافقان دائمًا تاريخها الَّذي يعود إلى نصف الألفيَّة، وليس لوضع تفاصيل تطوريَّة جديدة للإنجيل، ولكن لتحسين الفهم باستمرار. إنَّ مساعدة الروح القدس ووجود المسيح، الحقيقة الوحيدة (يوحنَّا 14: 6)، تضمن أن يتمتّع تعليم الكنيسة بموهبة معينة من الحقيقة التي تم استكشاف قيمتها،بشكل أفضل، خلال المجمع الفاتيكانيّ الثَّاني، الَّذي خصّص مساحة واسعة لمهمة التعليم للكنيسة بأكملها ومكوناتها المختلفة. فبعد المجمع الفاتيكانيّ الثَّانيّ، تطور لاهوت الزَّواج بشكل كبير ولاهوت العائلة، ونذكر بشكل خاصّ الإرشاد الرَّسوليّ الرعويّ "في وظائف العائلة المسيحيَّة في العالم" الَّذي يُعتبر شرعيًّا وثيقة للعائلة. فأحدث العديد من التحولات، وتطورت العناية الرعويَّة بالعائلة، وكذلك التفكير اللاهوتيّ في الزَّواج والحياة، وفقًا لإرشادات السُّلطة التعليميَّة وتنوّع حركات الروحانيَّة الزَّوجيَّة.
في 3 شباط 1983، بمناسبة خطاب التقديم الرسميّ للقانون الكنسيّ الجديد، عبر الأب الأقدس يوحنَّا بولس الثَّاني عن نفسه بهذه العبارات: "في الختام، أوَّد أنَّ أوجّه أمامكم، كمؤشر وتذكير، المثل المثلث المثاليّ: في الأعلى هناك الكتاب المقدّس، من جانب هناك أعمال المجمع الفاتيكاني الثَّاني، ومن جانب آخر هناك الشَّرع الكنسيّ الجديد. وللصعود من هذين الكتابين، اللذين أعدّتهما الكنيسة في القرن العشرين، إلى تلك القمة العليا، سيكون من الضروريّ المرور على جانبَي هذا المثلث، بدون إهمال ولا إلغاء، مع احترام الروابط الضروريَّة: السُّلطة التعليميَّة الكنسيَّة بأكملها - أعني المجامع المسكونيَّة السابقة وأيضًا (مع إلغاء بالطبع، الأنظمة الملغاة) إرث الحكمة القانونيَّة، التي تنتمي إلى الكنيسة". عند الكشف عن الموضوع المعهود إليّ، تذكّرت، على الأقلّ في الخطوط العريضة، المثلّث الَّذي تحدّث عنه البابا يوحنَّا بولس الثَّاني في الخطاب أعلاه. علاوة على ذلك، في ما يتعلق بالزَّواج والعائلة، يجمع بين العلوم اللاهوتيَّة والقانونيَّة في مرجعيتها الأساسيَّة إلى الكتاب المقدّس، الكنيسة، وهي تستمع إلى كلام ربّها وعريسها وسيّدها، الَّذي يخصّها بكلمات متى الإنجيليّ: "اذهبوا وعلّموا جميع الأمم، وعمّدوهم وعلّموهم أنيحفظوا كل ما أوصيتكم به (مت 28، 19-20)".
تمرّ هيكليَّة العائلة اليوم بمتغيرات كبيرة جدًّا في مفهومها وتشكيلها. فسهولة الحصول على الطلاق، وزيادة عدد الزَّواجات الحرة والأمر الواقع وتحديد النسل والرضى على المثليين، قد غيّرت، بشكل كبير، مفهوم حقيقة مؤسّسة العائلة. وحيث تظهر عدة أشكال الحياة الأسريّة بشكل متنوع في مختلف البلدان الأوروبيَّة.ومع ذلك، يظهر الانتقال من نموذج الزَّوجين مع الطفل إلى نموذج الوالد مع الطفل. ونجد العلاقة الأبويَّة، التي هي العلاقة بين الوالدين والطفل، أكثر حضورًا وبشكل مستقل عن العلاقة الزَّوجيَّة، الزوج والزوجة، التي في كثير من الأحيان، غير مستقرة تمامًا ولا تدوم كثيرًا. وبالتّالي، أصبحت العائلة مؤسّسة في المقام الأوَّل في خدمة البنين، الَّذين يمكنهم، مع ذلك، أن يولدوا خارج علاقة الزَّوجين، ومن خلال استخدام الطرق المتعددة للتخصيب الاصطناعيّ، علاوة على ذلك، تريد المرأة أن تكون أمًّا حتى خارج حدود فترة الخصوبة. وأصبح الابن، الَّذي هو ثمرة حبّ الزَّوجين، حقًّا لا يمكن أن تطالب به المرأة العازبة فحسب، بل أيضاً زوجان مثليّان. ويعتقد أنَّ الحقّ بالبنين يجب أن يتحقق بأي وسيلة، بدون المسار الطبيّعيّ بالحمل ضمن الزَّوجين وبزوجة واحدة، وبالتّالي، أيضًا من دون صورة الأب الطبيّعيّ. ويبدو أنَّ الحياة المدنيَّة والسياسيَّة والاجتماعيَّة تتطور في ضوء القانون الفرديّ، الَّذي بموجبه لكل شخص الحقّ في إنشاء اتحاد زواج كما يشاء، وإنجاب الأبناء كما يشاء، ولوضع حدّ لحياته عندما يقرر، وفرض على المشرّع إعطاء صيغة لهذا الحقّ. ننسى أنَّ القانون الفرديّ ليس مسألة ضمير شخصيّ فقط، بل هو في الأساس فعل عام يجب أن يكون محدودًا ومنظّمًا بقوة العقل، العدالة، المقارنة مع غيرها من متطلبات الدينيَّة الموجودة في الإقليم، والتعايش المشترك. إنّها خبرة عامّة تتمثل في أي بنية أساسيَّة لكل مجتمع المكوّن من عائلة متباينة الجنس. استقرارها وصلابتها هما ضمان لاستقرار وثبات جميع المؤسّسات الاجتماعيَّة الأخرى. وحيثما تكون مؤسّسة العائلة صلبة، فإنّ الأنظمة القانونيَّة الأخرى، الكنسيَّة والاقتصاديّة والسياسيّة تكون صلبة أيضًا. وحيثما تكون هذه المؤسّسة ضعيفة، فالأشكال الأخرى للتعايش المدنيّ تفقد العمق الاجتماعيّ وتصبح غير مستقرة.
في السنوات 35 التي تفصلنا عن اتحاد الإرشاد الرَّسوليّ الرعويّ "في وظائف العائلة المسيحيَّة في العالم، تعرضت العائلة للهجوم وتفريغها من العناصر المكوّنة لها، إلى درجة أنّها ترُكت بلا شكل وتكاد تكون خالية من الهويَّة. وندّد البابا فرنسيس بمحاولة "الاستعمار الإيديولوجيّ" التي روَّجت لها أيديولوجيَّة "النوع البشريّ" التي تحاول تدمير العائلة. العنصر الثَّاني المدمّر القوي هو اضعاف الروابط الأسريّة. في الوضع الحاليّ، يتم اختيار الروابط الزَّوجيَّة والأسريَّة بطرق عديدة. "ظهور ثقافة تمجد الفردانيَّة النرجسيَّة، ومفهوم الحريَّة المنفصل عن المسؤوليَّة تجاه الآخر، وتنامي اللامبالاة تجاه الصالح العام، وفرض الأيديولوجيات التي تهاجم بشكل مباشر مشروع العائلة، وكذلك، إنَّ نمو الفقر الَّذي يهدد مستقبل العديد من العائلات هو نفس الأسباب التي أدّت إلى أزمة العائلة المعاصرة". في مواجهة هذه المواقف الجديدة التي تتكاثر، نحن مدعوون لمواجهة التحديات والمشاكل الجديدة بروح جديدة وأن نبذل جهدًا كبيرًا لتعميق معرفة بجمال وعظمة واقع الزَّواج والعائلة. وهو جهد تلقّى دفعة كبيرة مع الدعوة البابا فرنسيس من السينودسين حول العائلة في ضوء الوحي في المسيح، لكل المؤمنين والمجتمع بأسره.
عبّر الأب الأقدس فرنسيس منذ بداية حبريّته، عن قلقه تجاه العائلة كأولويَّة رعويَّة، مدركًا دورها الأساسيّ في الكنيسة.ودعا إلى إعادة اكتشافها كموضوع أساسيّ للتبشير الجديد، فطالب مرارًا وتكرارًا بضرورة إصلاح النهج الرعويّ والقانونيّ، الَّذي تتطلبه أزمة العائلة الحاليَّة. وأن تجد في الزَّواج، باعتباره الاتّحاد الوحيد والحقيقيّ بين الرجل والمرأة إلى الأبد، أساسه المباشر والأساسيّ، وأن تقوم على أساس وعي حيّ لكلمة يسوع: "ما جمعه الله، لا يفرقنَّاه الإنسان" (متى 19: 6).
دافع الحبر الأعظم البابا فرنسيس عن حقيقة ليست أفكارًا، أو مفاهيم مجردة، أو مؤسسات باردة، بل هي أوّلاً شخص: المسيح، الَّذي هو الطريق والحقّ والحياة. وهذا، كما يبدو لي، مفتاح أساسيّ لفهم الإرشاد "فرح الحبّ"بكل معانيه. فقط في ضوء المسيح، يمكننا أن نجد إجابات حقيقيَّة للتحديات التي يواجهها كل شخص وكل موقف للرعاة وجميع المؤمنين.
طوّر البابا فرنسيس، في جميع أنحاء الوثيقة، بعمق كبير، الواقعيَّة الحقيقيَّة للراعي الصالح الَّذي يعتني بخرافه. الوحيد الَّذي يؤدي إلى السعادة الحقيقيَّة. هذه السعادة، أيضًا، دائمًا ما تكون مصحوبة بالصليب، بالارتداد الَّذي نحتاجه جميعًا والَّذي لا يغلقه الله أبدًا. ولكنّنا، نحن البشر، من ناحية أخرى، يمكننا أن ننغلق على أنفسنا. ما يقوله البابا فرنسيس، بشكل عامّ، عن المسيحيَّة وعقيدتها صالح للزَّواج والعائلة: "المسيحيَّة نفسها، بقاؤها وفيَّة لهويتها ولكنز الحقيقة الَّذي نالته من يسوع المسيح، تعيد التفكير دائمًا والتعبير عنها في الحوار مع المواقف التاريخيَّة الجديدة، فتترك حداثتها الدائمة تتفتّح". لا تغيير بل "تقدم" في عقيدة الزَّواج، كما لاحظ البابا فرنسيس، فيقول نحن لسنا في عصر التغيير، لكننا في عصر تغيير العصر.
شجّع البابا فرنسيس على عدم "وضع خلاص النفوس في مآزق النزعة القانونيَّة"، بينما يجب أن تكون وظيفة القانون موجهة إلى خلاص النفوس، لإثبات الحقيقة في لحظة الرضى، حتى لو كان عدد كبير من المؤمنين في حالة غير قانونيَّة، وكان للعقليَّة الدنيويَّة الواسعة الانتشار في تاريخهم تأثير قوي". لا يمكننا الاستسلام لوجهة نظر تشاؤميَّة للغاية حول تأثير الأفكار الخاطئة في إرادة المتعاقدين. لذلك،فإنّ مهمة القضاة الكنسّيين هي التأكد من الإرادة الحقيقيَّة (الزَّوجيَّة أو غير ذلك) للأطراف المتعاقدة في وقت الزَّواج. على حدّ تعبير يوحنَّا بولس الثَّاني، فإنّ الصلة بين العلمنة وأزمة الزَّواج والعائلة واضحة تمامًا. لقد حلت الأزمة على معنى الله وعلى الإحساس بالخير والشر في الأخلاق تحجب معرفة ركائز الزَّواج نفسه والعائلة التي يقوم عليها. تستلزم هذه الحقيقة الافتقار إلى الإحساس المسيحيّ بالحياة والعلاقات الإنسانيَّة، ممّا يؤدي غالبًا إلى رؤية مشوهة للزَّواج والعائلة كما هي مستمدة من البداية في المخطّط الإلهيّ، يتساءل البابا فرنسيس إلى أيّ مدى يتمتّع أولئك المنغمسون في هذا السياق الثقافيّ العالميّ تقريبًا بمعرفة كافية عن الزَّواج. وهكذا، فإنّ القضاة الكنسيّين، في موازنة صحة الرضى، عليهم -من بين أمور أخرى– أن يأخذوا في الحسبان سياق القيم والإيمان –أو غيابهما أو نقصانهما- الَّذي تشكلت فيه نيَّة الزَّواج". يريد البابا فرنسيس، تحديدًا، أن يؤكد الخطر المتمثل في أنه في حالة عدم وجود تمسك صارم بحقائق الإيمان، سيكون هناك انحراف عن الفهم الصحيح لماهيَّة الزَّواج. لكنّ فحص صحة الزَّواج أو عدمه يجب ألا يركز على درجة إيمان الطرفين، ولكن على الموضوع الحقيقيّ لرضاهما. هذا الشيء، في الواقع، وبالتحديد بسبب نقص الإيمان، يمكن أن يكون في بعض الحالات معيبًا بشكل جذريّ، مما يسبّب البطلان، في هذه الحالات، ليس إيمانه، بل إنسانيّته مدمرة إلى درجة أنّه لم يعد قادرًا على الزَّواج.
ادعائي هو أنَّ البابا قد وجد لغة ومنهجيَّة ورؤية لاهوتيَّة قد تفتح طريقًا للمضي قدمًا للرسالة المسيحيَّة في مجال حسّاس مثل الزَّواج وأخلاق العائلة، مع إعادة الاتصال واستعادة عناصر التقليد التي أُهمِلتْ من أجَل طويل جدًّا. ولأوّل مرة، الوثيقة التعليميَّة عن الزَّواج والحياة الأسرّيَّة لا تثير هامشًا أخلاقيًّا: فهي لا تهدف إلى إدانة أو حظر أي سلوك أخلاقيّ ولا تندد بأي ممارسات رعويَّة باعتبارها متساهلة للغاية أو تتعارض مع عقيدة الكنيسة.
يشرّفني أن أقدّم هذا الكتاب حول الزَّواج والعائلة بمناسبة السنة المكرَّسة للإرشاد الرَّسوليّ "فرح الحبّ" الَّذي يُظهر رغبة البابا فرنسيس بتصدي بمسؤوليَّة للأوضاع التي تتعرّض لها العائلات المسيحيَّة اليوم كي تكون قادرة على إثارة وعي جديد برسالتها في الكنيسة وفي العالم. ليس من قبيل المصادفة أن تكون مواضيع الارشاد الرَّسوليّ "فرح الحبّ" قد أثارت نقاشًا واسعًا، داخل الكنيسة وخارجها. من هنا،ينطلق اهتمامنا بأنّنا لا نعالج موضوع يخصّ الكنيسة فقط، ولكن البشريَّة جمعاء.
يمكننا القول إنَّ الإرشاد الرَّسوليّ "فرح الحبّ" قادر على الاستجابة لصعوبات الإنسان المعاصر، ليس فقط بمقاومة الأخطاء المعاصرة، ولكن قبل كل شيء من خلال تقديم طريق جديد للفكر الأنثروبولوجيّ في خدمة بناء الثقافة. وبالرغم من أنَّ البابا فرنسيس تحدّث عن الكنيسة كـ"مستشفى ميداني"، فإنَّ أداة المخاض التي شكّلت الخطوط العريضة لهذه المشاورات تشير الى أنَّ أحد التغيرات المنتظرة من السينودس يتمثّل في إحداث تغيّر في الاتجاه، بحيث يعود الأزواج المسيحيون لبناء الثقة مع الرعاة، وجعل الكنيسة ترى كطبيب رحيم يهتمّ بصحة المريض، وليس فقط حريصة على الحفاظ على بيئة معقمة. لهذا السبب، يوضع السينودس في بعده الرعويّ، مع الأخذ في الاعتبار الأسس العقائديَّة والأنثروبولوجيّة.