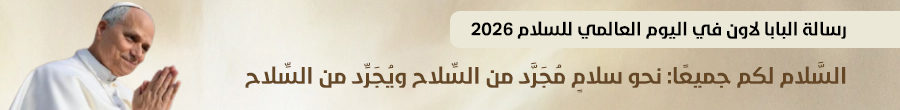موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

تقديم
أبناءَنا المحبوبين بالرب،
أبناءَ الكرسيّ الأنطاكيّ المقدّس إكليروساً وشعباً،
بناءً على قرار المجمع الأنطاكيّ المقدّس، الذي انعقدَ في البلمند ما بين الثالث والعاشر من شهر تشرين الأول 2019، وترجمةً لتداوُلِه موضوع "مفهوم العائلة وواقعها وحاجاتها" كهاجسٍ أساسيّ، بسبب ما يحوطُ بالعائلات ويعصف بها اليوم من همومٍ وصعوباتٍ وتحدّيات، نتوجّه بهذه الرسالة الرعائيّة إلى جميع أبنائنا في الكرسيّ الأنطاكيّ المقدّس، في الوطن وبلاد الانتشار، ناشدين تحصينهم، أفراداً وعائلاتٍ، بمقاربة الكنيسة لمخاطر هذه التحدّيات وسبُل تفادي تداعياتها على استقامة حياتهم في المسيح واستقرار عائلاتهم، بالاعتماد على فكر الانجيل وتعليم الكنيسة والآباء القدّيسين.
إنَّ قرارَ آباءِ المجمعِ الأنطاكيّ المقدّس إيلاء العائلة أولويّة البحث والاهتمام، ينبع من كونها نواة المجتمع، وقلبَه وضميرَه، على الرغم ممّا يطرحه عِلمُ الاجتماع الحديث من تساؤلات حول مكانتها. كما أنّ صونَ العائلة وترسيخَ فرح حضورِ الربّ في حياتها هو جلُّ اهتمام الكنيسة، لأنَّ ما نشهده من استهدافٍ لها ولاستقرارِ حياتها، في عالمنا اليوم، يهدّد ركيزةً أساسيّةً من ركائز الحياة المسيحيّة. ولهذا تضع كنيستُنا المقدَّسة في طليعة أولويّاتها مساعدة الإنسان ليحقّق مشيئة الله في عائلته، موطِّداً إيّاها في الإيمان القويم وعيش القيَم المسيحيّة والثبات في الفرح والرجاء. فتكون "كنيسةً صغيرةً"، شاهدةً حيّةً للمسيح، وسراجاً مضيئاً في العالم.
تمهيداً لمقاربتنا الموجزة لعناوين هذه الرسالة، ننوّه بأنّ لاهوتنا الأرثوذكسيّ يتميّز بكونه لاهوتاً شفائيّاً يتعهّد الإنسانَ بكلّيته ويُعنى بخلاصه. وهذا يقتضي أوّلاً تشخيصَ المرضِ وأسبابِه، ومخاطرِ استمراريّتِه، وتداعياتِ استفحالِه، ومِن ثَـمّ تحديدَ وسائل العلاج الناجعة. يعتمد العلاجُ، كما أساليب الوقاية، على خبرةِ الكنيسة وتقليدِها، ويستفيد ممّا يتوصّل إليه العلمُ الحديثُ في البحث عن سُبل المداواة وضرورة التزام المريض بها. فالكنيسةُ مَشفًى يعالج الناسَ بقدرة الله وقوَّته، وترتبط معالجتها لأبنائها أيضاً بالأبوّة الروحيّة، وبرعاية الجماعة الإفخارستيّة "للـمَرضى" من خلال المحبّة والدعوة إلى الاتّكال على الله وروحه القدّوس لمواجهة الصعاب. إلى ذلك، تستلهم الكنيسة الميراث الآبائيّ والطقسيّ في سائر برامج التوعية والعلاج، لما فيه من حوافز اليقظة الروحيّة والتفتّح والنموّ.
ولِكَونِ صَونِ استقرارِ العائلةِ أَوّلَ مُقتضيات الثبات المنشود إزاء الأزمات الاقتصاديّة، تؤكِّد كنيستنا المقدَّسة على أولويّة سَعيِها إلى تفعيل كلّ الطاقات والإمكانات لدعم واقع العائلة، وتدعو أبناءها إلى الانخراط البنّاء في هذا المسعى إلى أَنْسَنَةِ المجتمعات والعمل على جعلِ بُناها أكثر عدالة.
يبقى أنَ هذه الرسالة تطرح مسائلَ حياتيّةً جوهريّةً تتعلّق بالعائلة، ويبقى لكلِّ أبرشيةٍ تفعيلُ الأفكار المطروحة حسب ظروفها وأوضاعها والمجتمع الذي توجد فيه، وأن تعملَ وَفْقَ أنظمته وقوانينه. وهكذا، فإنَّ مهمّةَ التنفيذِ تُلقى علينا جميعاً، رُعاةً وشعباً؛ لأنّ كلَّ مؤمنٍ مسؤولٌ بما أعطاه الله من معرفةٍ ومواهب.
ألا قوَّانا الله لكيما بنعمته ننمو، وبخدمتنا نسمو، فيتناسق بالمحبّة البنيان، وتزهر عائلاتنا في فرح الحياة.
← القسم الأول: الأُسس اللاهوتيّة لمفهوم الزواج المسيحيّ
الإنسانُ، هيكلُ الله الحيّ
1. أحبَّ اللهُ الإنسانَ فخلقَه من العدَم، على "صورته ومثاله"، واهباً إيّاه الحياةَ والإرادة والحريّة، وطالباً منه أن يُحسنَ استعمالها. في القرن الثاني الميلاديّ، أجاب القدّيس ثيوفيلوس أسقف أنطاكية، عن طلبِ أحدهم أن يُريَه إلهَه قائلاً: "أرِني إنسانَك فأُريك إلهي" (إلى أوتوكليتوس، الكتاب الأول، PG 6: 1028). هذا يعني أنّ الإنسان بإمكانه أن يعكس الإله الخفيّ ويُظهر محبّته ومجده للكون. وهذا ما يوضح عظمتنا ومسؤوليّتنا في حياتنا الشخصيّة والعائليّة.
2. تتجلّى الرؤية الأرثوذكسيّة للإنسان في مقاربةٍ تَشمل الإنسان بكليَّته جسداً ونفساً وروحاً. فالنفس تحيي الجسد، والروح تجعل من الإنسان كلّه كياناً روحيّاً. والغاية أن يسهر الإنسان على نفسه وجسده، في مسيرته على هذه الأرض، ويجعلهما شفّافَين وخاضعَين للروح. فالإنسان كيانٌ موحّدٌ مدعوٌّ لأن يصير "شريك الطبيعة الإلهيّة" (2 بطرس 1: 4)، إلهاً بالنعمة. وفي المقابل، يمكنُ للإنسان أن "يُطفئ الروح" (1 تسالونيكي 5: 19)، فيهدِّدُ وحدةَ كيانه ويُسكِت النفسَ فيه ويجعلُها أسيرة الجسد. هذا حين يتمرَّد الإنسان على مشيئة خالقه ويتخلّى عنه، فاصلاً ذاته عن مصدر الحياة. أمّا الخالق فلم يتخلَّ أبداً عن الإنسان، بل فتَح له طريقاً للتوبة والتغلّب على الموت بواسطة الحياة في المسيح، الذي أبطل الفساد والموت بموته المحيي على الصليب وبقيامته. وقد قدّس الربُّ طبيعةَ الإنسان بفعل تجسّده وموته وقيامته وصعوده بالجسد إلى السماء، أعطى الإنسان أن يستعيد فاعليّة خَلقِه على صورة الله، وينال القدرة على التغلّب على الموت، والسير مجدّداً في طريق التألّه، عبرَ ضبط الشهوات واقتناء الفضائل ومعرفة الكتاب المقدّس والتزام حياة الكنيسة، وممارسة أسرارها، وملاقاة المسيح وخدمته في كلّ إنسان.
3. يضبط الإنسان نفسه بإرادته الواعية والحرّة، متّخذاً شعاراً لمسيرته قولَ الرسول بولس: "كلُّ شيءٍ يحلُّ لي ولكن ليسَ كلُّ شيءٍ يوافق" (1 كورنثوس 6: 12). هذا ما يختبره الإنسان المسيحيّ في الحياة الكنسيّة. فالأسرار الكنسية تَبُثُّ الحياةَ الإلهيّة فينا، والكتابُ المقدّس يقوّينا بالربّ ويدعونا للتمثّل به، والصومُ يُحصّننا إزاء المغرِيات والشهوات، والنسكُ يقودنا بعيداً عن الأهواء. إنّ الشركة الزوجيّة، في رحاب الحياة الكنسيّة، تسهّل على الزوجَين سلوك هذا الطريق "الضيّق" والبهيّ، بجهادهما في المسيح معاً وتمثّلهما به وتوقهما المشترك إلى القداسة. فيحقّقان بذلك كمالهما، ويؤلّفان بسكنى الروح القدس فيهما نواة ًكنسيّةً، "هيكلاً لله" (2 كورنثوس 9: 6)، شركة انفتاحٍ بسرّ الزواج، على الله والأبناء والآخرين.
الزواج سرّ الفرح
4. شرّع الله سرّ الزواج منذ البدء حين قال: "يتْرُكُ الرَّجلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصقُ بامْرَأَتِه فَيَصِيرانِ كلاهما جسَداً وَاحِداً" (مرقس 10: 7). بقوله هذا "جسداً واحداً" قَصَدَ الربّ اتحاد الزوجَين كيانيّاً بشكلٍ دائمٍ ، أي ليس فقط بحسب العواطف، بل أيضاً في الجسد والفكر والروح وكلّ الحياة. الزوجان، في اتّحادهما الكيانيّ هذا، هما أيقونةٌ حيّةٌ لله الثالوث، شخصان متّصلان ومنفصلان في آنٍ، يجمعهما الله في وحدةٍ تَرتجي الكمال.
5. وقد جدّدَ المسيحُ مفهومَ حضورِ اللهِ في الزّواج حين خصّصَ أوَّل آيةٍ له في عرسِ قانا الجليلِ (يوحنّا 2 :1-11)، معطياً الزواجَ بُعداً جديداً لا يقتصرُ على الهدفِ البشريِّ القديمِ أي التَّناسل، أو على المفهومِ الرومانيّ القانونيّ له كعقدٍ اجتماعيّ. صار "كلّ شيءٍ جديداً" (رؤيا 21: 5) في الزواج بحضور المسيح. فبات الزّواج المسيحيّ سرّاً مقدّساً يملأ الزوجَين بنعمةِ الروح القدس، ويؤهّلهما لـ "بهجة الخلاص" بالمسيح (مزمور 50: 14).
6. إنَّ تحقيق الخلاص واقتناء الفرح ليسا بالأمر السحريّ. فالرّوح القدس لا يفرض نعمته على الإنسان متخطّياً حرّيته، بل ينتظر منه أن يفعّلَها بملء إرادته، بسعيه إلى التحرّر من نير الخطيئة والنموّ إلى "ملء قامة المسيح" (أفسس 4: 13). رجاءُ الكنيسة أن يعيَ الزوجان هذه النعمة الموهوبة لهما فيفعّلانها بالصلاة اليومية، وبالتخلّي عن الأنانية وعن حبّ الذات ليمتلئا من حبّ الربّ والقريب، لكي يَفعل الرّوح القدس فيهما ويصير زواجهما مسيرة عبورٍ من الانقسام إلى الاتّحاد، ومن جسدَين إلى "جسد واحد"، مسيرةً تلخّص مفهوم العيش على "مثال الله" (تكوين 1: 26)، في عيش الحبّ الإلهيّ الذي للآب والابن والروح القدس.
الزَّواج سرّ المحبّة
7. يَصِف الكتابُ المقدّسُ الربَّ يسوعَ بأنّه المسيح الختن، أي العريس، والكنيسة هي العروس. ويقول بولس الرسول في زواج الرجل والمرأة "إنّ هذا السرَّ لعظيمٌ هو" (أفسس 5: 32)، إذ يُشبّهه بسرّ زواج المسيح والكنيسة، الذي هو إذاً صورةٌ لهذا الحبّ الإلهيّ الذي استُعلِن في التجسّد والصليب. الزّواج اتّحادٌ فريدٌ بين شخصَين لا يربطهما الحبّ المتبادل وحسب، بل اتّحادُهما في المسيح أيضاً. يتمّ التّكليل على اسم الثّالوث الأقدس، لأنّ حبّ العروسَين لبعضهما، وكلَّ حبٍّ، ينبع من محبّة الله للبشر والمحبّة التي في الثّالوث القدّوس التي هي عطاءٌ كامل. يُظهر الزوجان هذا العطاء لبعضهما ولأولادهما وأقربائهما وإخوتهما في الرعيّة والعالم. كُلُّ عطاءٍ يَفترضُ بذلاً للذات ومحبّةً معطاءً للآخرين.
8. إنّ ما يبدو جليّاً في خدمة سرّ الزّواج، أو الإكليل، هو المكانة المحوريّة للصليب. فالصليب، من حيث هو استعلان محبّة الله ببذلِ ابنه الحبيب، موضوعٌ مع الإنجيل على المائدة أمام العروسَين ليذكّرهما بقول الربّ: "من لا يحملُ صليبه ويتبعني فلا يستحقّني" (متى 10: 38). "حملُ الصليب" هو القبول الطوعيّ لمصاعب الحياة والاستعداد للتعبير عن المحبّة ببذل الذات والخدمة، لأنّ هذا هو الطريق إلى الفرح الحقيقيّ إذ "بالصليب قد أتى الفرح لكلّ العالم" (صلاة سواعي الفصح).
9. الحياة المسيحيّة كلُّها مبنيّةٌ على كيفيّة عيش هذا الحبّ مع الله والقريب والخليقة، وبالأخصّ بين الزوج والزوجة، فالحياة الزوجيّة ليست سوى مختبَرٍ للتدرّب على هذا الحبّ الذي ينبغي أن يحمل سمات المحبّة كما يصفها بولس الرسول، أي الصبر والأمانة، ونبذ الغيرةِ والتبجّح، والتحلّي باللطف والسلام الداخليّ، والغفران والتضحية، والثقة بالآخر والرجاء بالله، وتحمّل كلّ شيء (1كورنثوس 13). ينمو هذا الحبّ بالجهاد الروحيّ، وقطع الإرادة وضبط الأهواء، وبمحاولةٍ مستمرّةٍ لإفراغ الذات من أمّ الشرور، أي محبّة الذات/ الأنانيّة، وبممارسة الفضائل أي "كلّ ما هو حقٌّ، كلّ ما هو جليلٌ، كلُّ ما هو عادلٌ، كلُّ ما هو طاهرٌ، كلُّ ما هو مُسِرٌّ، كلُّ ما صيته حسنٌ" (فيلبي 4: 8). ولا بدّ في هذا الصدد من التنبيه على نبذ كلّ شكلٍ من أشكال العنف المنزليّ الذي يقوضّ أسس العلاقة السويّة.
الزواج سرّ الشركة
10. يعيش الزوج والزوجة في علاقة شركة، يتّخذان كلّ قرارٍ برضىً متبادل، ويحقّقان مثال المسيح فيهما عبر سعيهما، بإرادتهما الحرّة، للاتّحاد به "شاكرين الله الآب كلّ حينٍ، على كلّ شيءٍ، باسم ربّنا يسوع المسيح، وخاضعين بعضهما لبعض بمخافة الله" (أفسس 5: 20-21). لذا، يسعى الزوج والزوجة إلى تغذية محبّتهما لتنمو مع الوقت، وإلى تحقيق أكبر قدرٍ من التناغم بين التنوّع والأحاديّة، وبين الحرّيّة الشخصيّة والقرار المشترك.
11. تكتمل وحدة الزوجين بالمحبّة في الطاعة، والطاعة في المحبّة. بطاعتهما المتبادلة يحقّق كلٌّ من الزوج والزوجة دورَه ودعوتَه في العائلة. ليست الطاعة خضوعاً لشخصٍ أكثر قوّةً أو تسلّطاً، بل هي بذل الذات في انتظار الله، والإصغاء إليه، وفتح الأذن والقلب لكلماته. فالإصغاء هو تعبيرٌ عن الحبّ إذ يعكُس انتباهَ الشريكِ إلى شريكهِ ومبادرته للحوار معه والفرح بمشاركته. وعبارة "الرجل رأس المرأة"، من جهةٍ أخرى، لا تشير إلى مرتبةٍ أعلى، فالمسيح هو رأس الكنيسة، وهذا لا يجعله في موضع السيطرة، بل في موضع القيادة، بمعنى الخدمة من خلال إفراغ الذات (فيلبي 2: 7-8) حبّاً بالآخر وفداءً له وعملاً على نموّه (مرقس 10: 45).
12. إنَّ دخول العروسَين إلى الكنيسة هو دخولٌ إلى ملكوت المسيح. العهد هو بينهما من جهةٍ، وبينهما وبين المسيح من جهةٍ أخرى. إنّ اتّحاد الرجل والمرأة في المسيح يؤلّف كنيسةً صغيرةً، "الكنيسة التي في البيت" (رومية 16: 5). الشرط المسبق للزّواج المسيحيّ هو الإيمان الواحد بيسوع المسيح، الذي يجب أن يكون مشترَكاً بين العروسين. لذلك كان الزواج في الكنيسة في القرون الأولى يتمّ خلال القدّاس الإلهيّ فيتّحد الزوجان بالمسيح في الافخارستيّا، أي بجسد المسيح ودمه الكريمين، الذي يُرمَز اليوم إليه بتجرّع العروسين الخمرة من كأسٍ واحدة. باشتراك الزوجين بالافخارستيّا معاً، يأخذ حبّهما البشري بُعداً جديداً له طَعم الأبديّة، ويُعطيهما القدرة لأن يُصبحا شاهدَينِ لمحبّة الله. فيُصبح حبّهما البشريّ أميناً صادقاً، لا فراق أو طلاق فيه، لأنّه "قويّ كالموت" (نشيد الأنشاد 8: 6)، وباكورة سرّ الملكوت. لذا من المستحبّ أن يتناول الخطيبان معاً قبل زواجهما ليحظى زواجُهما بختم جسد الرب ودمة الكريمين.
13. تسعى العائلة إلى عيش سرّ الملكوت هذا منذ الآن، وأن تصبح "كنيسةً بيتيّةً" (رومية 16: 5، 1 كورنثوس 16: 19، كولوسي 4: 15، فليمون 2)، لأنّ حياة العائلة بالمسيح ليست مجرّد حياةٍ بشريّةٍ، بل هي صورةٌ مصغّرةٌ للملكوت، وخبرةٌ مُعاشَةٌ له. لذا يقول القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم: "عندما يتّحد الرجل والمرأة بسرّ الزّواج يتخطّيان صورة ما هو أرضيٌّ، ويُصبحان على صورة الله السماويّ نفسه" (الرسالة إلى كولوسي، عظة 12، PG 62:387). لذا، يجهد الرجل وزوجته للرسوخ في هذه الصورة الملكوتيّة، فلا يَخضعان لمغريات الدنيا وتحدّياتها الاستهلاكيّة الكُبرى ولكلّ ما يُعيق نموّ حياتهما في المسيح معاً.
14. أمّا الإنجاب فهو تبِعةٌ طبيعيةٌ من تبِعات الزواج. هو ثمرةُ الاتّحاد الزوجيّ وتعبيرٌ عن المشاركة مع الله في عمليّة الخلق. فالإنجاب ليس الهدف الأساسيّ الوحيد للزواج وغايته، وإنّما سبيل من السُبل المساعِدة على الكمالِ الروحيّ للزوجين. به تكبر العائلة ويكبر معها انفتاح الزوجين على سموّ الحياة، ودورهما فيها، وتجاوزِ ذواتهما بمزيدٍ من الولوج في العطاء والتضحية المجانيّة. يخلق الإنجاب في حياة الوالدين مزيداً من الآفاق والواحات الشركويّة التي تتجلّى فيها المحبّة، مما يرسّخ مسيرة اتحّادهما بالمسيح.
← القسم الثاني: التحدّيات المعاصرة للعائلة
15. من المجدي أن نقف عند التحدّيات التي نتجَت عن التبدّلات المتسارعة في حياة الإنسان في عالم الحداثة وما بعد الحداثة من أجل تقييم تأثيراتها والنظر في سبل مقاربتها.
العقليّة الدهريّة
16. يتعارض منطق الدهريّة الذي ينادي بأنّ كلّ شيءٍ في هذا العالم، بما فيه الإنسان، هو من هذا العالم وينتهي إليه، مع دعوة المسيحيّة إلى الموت عن العالم، والمقصود تحديداً هو الموت عن شهوات العالم (متى 16: 25) والشخوص إلى الحياة الأبديّة. إنّ عدم تبنّي الدهريّة لمخلوقيّة الإنسان على صورة الله ومثاله، أدّى أيضاً إلى خلق مركزيّةٍ إنسانيّةٍ منحرفة. أصبحت حياة الإنسان تتمحور حول ذاتها لا حول الله. فلا حديث عن الضمير ولا عن الخطيئة أو الأهواء أو الشيطان المعتبر من الخرافات، وتأثيرات هذه في النفس البشريّة. لا ترى الدهريّة أنّ النفس تفقد صحّتها بفقدان سلامها مع الله، وهذا بدوره قد يؤدّي إلى عطب الجسد. ولا تقرّ بمبدأ استرجاع السلام مع الله من خلال سرّ التوبة.
17. الدهريّة في العمق هي توكيدٌ على الفرديّةِ على حسابِ الانفتاح والشركة. يمسي الفردُ "الإلهَ الأعلى". وهذا يفتح الباب أمام حريّةٍ لا مسؤولةٍ تقود إلى عدم احترام الآخرين والتعاطي معهم بمنطقِ الكسبِ والانقطاع عن كلّ شركة، وذلك تحت شعار "الحريّة الشخصيّة". إنسان اليوم يجنح الى التعاطي مع الآخر من باب التملّك، ما ينتج عنه عزلة قاتلة تنعكس على كلّ مستويات الحياة، بينما الحاجة الحقيقيّة هي إلى الصدق والوفاء والتضحية المجانيّة والأمانة والشجاعة والكرم والشهامة.
18. من السماتِ الأساسيّةِ للدهريّة إضعافُ علاقة الإنسان مع الله، وإفسادُ علاقته مع نفسه، الأمر الذي يقودُه بعيداً عن استقامة سائر علاقاته، وبالأخص بين الرجل والمرأة المتزوجين. وتظهر أحياناً هذه التأثيرات على البنين في النَّزعة إلى التمرّد وعدم الاعتبار للمرجعيّة الوالديّة أو الاطمئنان إليها.
19. لقد سادت عقليّةٌ تدعو إلى مساءلة القيم التقليديّة والشكِّ في العادات القديمة. فيما عظَّم التقدّم العلميّ التطبيقيّ والتكنولوجيّ، وما يقدّمه من تسهيلاتٍ، اعتدادَ الإنسان بقدراته وبمواهبه وبتفوّقه، وعزّز رغبته بالسيادة والسيطرة على العالم. فصار الإنسان يثق بقدراته وتقدّمه أكثر بكثير من ثقته بالخبرات الروحيّة والإنسانيّة المتراكمة على مدى العصور، والتي تبلورت قيماً وعاداتٍ وتقاليدَ وأعرافاً. من هنا تعاني التربية من تشويش نتيجة التشكيك بالمعايير والمرجعيّات والقيم الأخلاقيّة، سواء الإيمانيّة-الإنجيليّة أو تلك التي بنتها خبرة الإنسان. هذا التشكيك يتنكَّر لدور هذه الخبرات في تقدّم المجتمعات الإنسانية، ويُعلي، ما بين العلم وإنجازاته الخادمة للإنسان وبين الإيمان، سدوداً مصطنعةً ترفُضها الكنيسة، رغم أنّ العلم قد أسهم في بعض الحالات والظروف في تنقية بعض المفاهيم والاعتقادات والأعراف السائدة.
20. لا يخفى على أحدٍ أنّ إيقاع الحياة اليوم يدفع بأفراد العائلة إلى التشتّت اليوميّ وانخفاض المساندة العاطفيّة والاحتضان والمحبّة بينهم. فالأب والأم يعملان لأوقاتٍ متأخّرةٍ والطفل خارج حضانتهما لفترةٍ لا يُستهان بها من الوقت. لم يعد الوالدان المرجعيّة بالنسبة إلى الأولاد، مما يولِّد لدى هؤلاء فراغاً عاطفيّاً يزيد من خطر انحرافهم السلوكي في المستقبل. يكمُن الحلُّ إذاً في تعزيز الاحتضان العائليّ للأطفال، فتصير المحبّة التي يقتات منها الطفل في عائلته أولى سبله إلى محبّة الله. حينئذٍ يدرك أن الله هو أبٌ له، والكنيسة أمُّه.
الاقتصاد وعجلة الاستهلاك
21. يحوِّل مجتمعُ الاستهلاك مَن يخضع لأحكامه من البشر إلى أشباه آلاتٍ في خدمة المال والسلطة والسَّعي خلفَ الرفاهية. ويؤدّي الغرق في الاستهلاك إلى فقدان التمييز لدى الفرد بين الضروريّ واللازم لعيشٍ كريمٍ وبين الكماليّات، وإلى تفوّق فرح الأخذ والتملّك واكتساب المزيد على روح التضحية والعطاء المجانيّ. كما يؤول بالإنسان إلى أن يكون أسيرَ "أناه" فيدور في حلقةٍ مُفرَغةٍ بهاجس الرغبة الدائمة في اقتناء الأحدث واستهلاك الأكثر، ما يجعله في غربةٍ عن نفسه وعن أخيه ويُفرِغُ وجوده من معناه.
العولمة ووسائل التواصل الاجتماعيّ والعالم الافتراضيّ
22. إنّ الثورة التي أحدثتها تكنولوجيا المعلوماتيّة بدّلت بشكل دراماتيكيّ الكثير من الطرق التربويّة التقليديّة والقديمة. فالإنترنت منبرٌ حرٌّ للتعبير بشكلٍ مطلقٍ، سريعٍ وآنيٍّ، عالميّ، لا مركزيّ، متفاعل، واسع الانتشار وممتدّ بلا حدود، بل قابلٌ للتكيّف مع كل موضوع. أصبحت هذه التكنولوجيا الحديثة جزءاً أساسيّاً من حياة الملايين من البشر، وواقعاً لا مفرّ من التعامل معه والتحكّم به، قبل أن يتحكّم هو بنا. والكنيسة دخلت كلّ ميادين المجتمع لتعلن كلمة الحقّ وتحافظ على كرامة الإنسان والعائلة. وها هي اليوم، في مجتمعاتٍ قِيَمُها ضبابيّةٌ، تسعى بجهدٍ إلى مَسحَنة الإنترنت عن طريق إظهار الحقّ والقيم التي تُرجع البشريّة إلى مكانتها الأولى في الخَلق، وبالتالي إلى الإنسان الحقّ. ومع خبرة القرن الحادي والعشرين في عالم المعلوماتيّة، يتبيّن أنّ هذا العالم إذا وُجّه نحو الخير والإفادة، يكون أداةً مباركةً للبشارة والتعليم والتواصل: "إذهبوا وتلمذوا جميع الأمم" (متّى 28: 19). إنّ الدورَ الأهمّ للكنيسة، في العالم هو البشارة والشهادة والتعليم وإرشاد الإنسان إلى الخلاص في زمنٍ يكثُر فيه ما يُبعده عن خلاصه. هذا الارتقاء بالثورة التكنولوجيّة عبر جعلها في خدمة بشارة الإنجيل والسموّ بالإنسان وإحياء القِيم في المجتمعات، هو ما تشخص إليه الكنيسة.
23. بالمقابل، خلَقَ التقدّم التكنولوجيّ السريع والثورة الرقميّة عالماً جديداً، نجحت الميديا من خلاله في تقريب المسافات بين البشر، ولكنَّها وسّعت المسافات وأقامت الحواجز المعنويّة بينهم. وبما أنَّ عالم الميديا متخَمٌ بكلّ ما تشتهيه العيون، من علومٍ وفنونٍ وترفيهٍ وأديانٍ وغيرها، أصبح الإنسان يَنشدُّ إليه ويجد فيه عوالمه الخاصّة بعيداً عن عالم الواقع، فيكتفي بها مستبدلاً الرغبة في التعارف والتواصل مع الآخرين بحالةٍ من الاكتفاء الذاتيّ والانكفاء الاجتماعيّ. هذه الحالة تهدّد العائلة اليوم بخطرٍ أصبح ملموساً، وهو أن ينعزل أعضاؤها عن بعضهم في عوالم افتراضية مستقلّةٍ تحت شعارات الخصوصيّة والحريّة الشخصيّة، ما من شأنه أن يدفع إلى مزيدٍ من المشاكل الزوجيّة والأزمات العائليّة. والكنيسة، إذ تنبّه من هذه العزلة، تدعو العائلات إلى تكثيف التواصل الشركويّ الحيّ، في حياتها اليوميّة والثبات فيه، وتلفت الأهل إلى ضرورة ومحوريّة إشرافهم التربويّ على تعاطي أبنائهم مع العالم الافتراضيّ المنفتح بدون حدودٍ، وضبط هذا التعاطيّ كمّاً ونوعاً، وتوجيهه نحوَ ما يُغني فكرهم وينمّي ثقافتهم ويصبّ في خدمة استقامة تربيتهم وصقل شخصيّتهم الإنسانيّة على الصُعد كافّةً.
24. لقد استحال العالم الافتراضيّ نطاقاً وميداناً جديداً للتعارف، ونجح في تسهيل التواصل بين الناس، إلاّ أنّه أدخل خللاً كبيراً إلى مجتمعاتنا. يكمن تحدّي العالم الافتراضيّ في اختزال كيان الإنسان بنطاق الصورة، وتحديداً الصورة الخارجيّة الجذّابة. فيمكن للإنسان أن يجد نفسه في نزاعٍ داخليٍّ بين ما هو عليه، وبين ما يشتهي أن يكون عليه أو ما يجب أن يكون عليه.
← القسم الثالث: مسائل أخلاقيّات الحياة
25. الحياة هبةٌ مقدّسةٌ من الله. لذا، تعتبر الكنيسة مسائل أخلاقيّات الحياة حقولاً تحمل قِيماً إلهيّةً سامية. ولا تحصر حياة الكائن البشريّ بالصحّة البيولوجيّة والنفسيّة والاجتماعيّة وحدها، دون إمكانية النموّ الروحيّ والانفتاح على النعمة الإلهيّة. لذلك تساعد الكنيسة العائلات المؤمنة على تلمُّس مشيئة الله وأحكامه في مواجهة صعوباتها الجسديّة والنفسيّة، وعلى التمسّك "بالرجاء الذي لا يُخزي" (رومية 5: 5)، والاتّكال على الله أمام الآلام المتنوعة. من هنا يأتي اهتمام الكنيسة بمسائل أخلاقيّات علوم الحياة المطروحة في المجتمع المعاصر من منطلق تأكيدها على قدسيّة الحياة ووجوب احترامها، مع انفتاحها على التقدّم العلميّ والعمل السياسيّ وشرعة حقوق الإنسان.
مسائل بداية الحياة
26. لا بدّ لنا من معرفة التحدّيات التي تطرحها التقنيّات المساعِدة على الإنجاب، إضافةً إلى معرفة عواقبها الاجتماعيّة والقانونيّة، لا سيما ما يختصُّ بوسائل منع الحمل ومعضلات التشخيص التي ترافق الحمل، واختيار جنس المولود، وغير ذلك.
27. الجنين والإجهاض: تنظر الكنيسة إلى الجَنين كشخص حاملٍ للحياة وُجِدَ وانضمَّ إلى عائلته الصُغرى منذ اللحظة الأولى لتكوينه الذي حَصل "بعناية الله" وتآزر والديه (القديس يوحنا الذهبيّ الفم، عظة 49 في سفر التكوين، PG 54: 445). فلا تقلّ مَكانته، في رؤيتها، عن مكانةِ الإنسان "المخلوق على صورة الله ومثاله" (التكوين 1: 26). لذلك تشدّد الكنيسة على الحاجة إلى حمايةِ الجنين وتنميته أيّاً كانت صعوبات العائلة وأحوالها، وترفض الإجهاض في أيّ مرحلةٍ من مراحل تكوينه. وفي حال فرضت ظروفٌ صحيّةٌ مُلزٍمَةٌ للغاية ما يقتضي غير ذلك، كالتهديد لصحة الأمِّ وحقّها في الحياة، وبعد تشخيصٍ طبيّ واضحٍ وقاطع، تدعو الكنيسة الوالدين إلى الاسترشاد فيها من أجل الاحتكام إلى القرار المسؤول أمام الله العادل.
28. الإخصاب الصناعيّ: إنّ الإنجاب عملٌ مباركٌ من الله الذي منح الإنسان الرغبة الطبيعيّة بأن يلد بنينَ وبناتٍ. وتماماً كما الحاجة إلى الأمومة هناك حاجةٌ أيضاً إلى الأبوّة. لذا، يمكن لحالة العقم أن تكون صعبة الاحتمال أو أن تؤدّي إلى ضيقةٍ نفسيٍّة ونتائج سلبيّةٍ على الزوجين، ما قد يحدث تضعضعاً في الحياة الزوجيّة وخللاً في العلاقة بين الرجل وزوجته.
29. ساعد التقدّم التكنولوجيّ على إيجاد حلٍّ لبعض حالات عدم الإنجاب وعلى شفاء بعض الأمراض التي تمنع الإخصاب ما ساعدَ الزوجين في تحقيق رغبتهما بأن يكونا أباً وأمّاً. إلّا أنّه من جهةٍ أخرى، وضعَ المؤمنَ أمامَ تحدّياتٍ نفسيّةٍ وأخلاقيّةٍ، طبيّةٍ وقانونيّةٍ، واجتماعيّة.
30. أدّت التقنيّات الحديثة في الإخصاب الصناعيّ بالإنسان المؤمنَ إلى نوعٍ من الارتباك والتردّد حيال اتّخاذ بعض القرارات. ومن الأمور التي تسبّب هذا الإحراج، مثلاً معضلة الإخصاب من واهبٍ غير الزوج؛ ومسألة التصرّف بالبويضات الملقّحة التي تَزيد عن الحاجة وما إذا كان يجوز إتلافُها أو وهبها أو بيعها، وكذلك خبرة الأُمّ البديلة لحمْل بويضةٍ ملقّحةٍ من زوجَين.
31. تنظر الكنيسة بقلقٍ بالغٍ إلى مسألة البويضات الملقّحة والمجمَّدة. في العادة، يتمّ تلقيحُ بويضاتٍ عدَّة وإنتاجُ أجنَّةٍ عدَّة. يُزرعُ بعضُها في رَحمِ الأمّ، ويُحفظُ ما تبقَّى مِنها مُجلَّداً في خزائنَ مُخصَّصةٍ لها إمّا بهدف إعطائها لأمَّهاتٍ أخرياتٍ يرغَبنَ في إنجابِ الأطفال، أو لاستعمالها في بحوثٍ علميّة. وفي أحوالٍ أخرى تُقتَل. والأجنَّةُ التي تُزرعُ في الرَّحم تُختزلُ هيَ أيضاً انتقائياً. يتلازمُ مع هذا كلّه خطرُ انتقاء أفضل بويضاتٍ مُلقَّحَةٍ واختيارُ جِنسها وإتلاف ما تبقى منها، إذ إنّ إتلافها والمحافظة عليها إلى فترةٍ غير محدودةٍ أمران يناقضان الأخلاق المسيحيّة. كما أنَّ فحوصاتِ ما قبلَ الولادة، رغمَ حلّها لبعض المشاكل العلاجيّة، إلا أنها تطرح، في بعض حالاتٍ أخرى مُعضلاتٍ إيمانيةً أخلاقيّة. فبعض الأمراضِ الَّتي تُكشَفُ بعد الحبلِ وقبل الولادة، والتي لا يمكنُ علاجُها، أقلّه إلى يومنا هذا، كثيراً ما تدفَع بالزوجين إلى خيارِ الإجهاض، الأمر الذي ترفضه الكنيسة قطعاً.
32. تنظر الكنيسة بريبةٍ إلى حَبَل المرأة العزباء بواسطة الإخصاب الصناعيّ، كونه يؤدّي إلى ولادة طفل بدون أب. وهذا ينطبق على استعمال النطفة المجمّدة من رجلٍ متوفًّـى، أو استعمال بويضة مجمّدة من امرأة متوفّاة. وترفض الكنيسة لجوء الأشخاص المثليّين إلى الإخصاب الصناعيّ لانعكاساته السلبيّة النفسيّة والاجتماعيّة والروحيّة على الطفل والمربكة له.
33. وسائل منع الحمل: بغية تنظيم حياة الأسرة، تقبل الكنيسة استخدام وسائل منع الحمل الوقائية غير المـُجهِضة وغير المؤذية للخصوبة. وفي هذا السياق تذكّر بأنّ المحبّة الزوجيّة لا تُستعلن حصراً بالممارسة الجسديّة، بل بالحبّ والاحترام المتبادلين يوميّاً وببذل الذات الذي يشمل ويطال كلّ أصعدة الحياة ووجوهها ويُضفي عليها رونقها البهيّ. ومع تشجيع الكنيسة أبناءَها على التكاثر والإنجاب، إلاّ أنّها تميِّز بين "تنظيم النسل" و"تحديد النسل". فالتحديد يشير إلى إنقاص عبثي، أمّا التنظيم فيعني أن تتخذ كلّ أسرةٍ قرارها الخاص في صلاة، وبالتشاور مع الأب الروحي للعائلة أو كاهن الرعيّة، وذلك بناءً على ظروفها الروحيّة والصحيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
34. التبنّي: يعاني الكثير من الأزواج من عدم إنجاب الأطفال بسبب عقمٍ لدى المرأة أو الرجل. وهذا يؤدّي في بعض الأحيان إلى حياةٍ ملؤها الملل وعدم الاستقرار، إذ يشعر الزوجان بحنينٍ وشوقٍ إلى الأبوّة والأمومة، ويتمنّيان أن يكون لهما أبناءٌ يملؤون حياتهم. هنا يبرز التبني كأيقونةٍ مقدّسةٍ لإحسان كلمة الله إلى طبيعة البشر الحاصل بسرّ التجسد الإلهي. التبنّي مدعاةٌ لفرحٍ لا حدود له، فرحِ من يُنعم الله عليهم ببنين بعد حرمانٍ، أو فرح السامري الشفوق، الذي يجد معنى حياته في أخذ الآخر على عاتقه، ومداواةِ جراحِه، وجعلِه بالمحبة المعطاءةِ "قريبي" (لوقا 10: 30). هو تعهُّدٌ ملتزمٌ للآخر وتشبّهٌ كبيرٌ بعطاء المسيح المتحنّن. ونجد في الكتاب المقدّس أفعال تبنٍّ متفرّقة (خروج 10:2، 1 ملوك 20:11 ، أستير 2: 15،7). لذا، تبارك الكنيسة مبادرة الزوجَين اللذَين يعانيان من مشاكل صحيّة تمنعهما من الإنجاب إلى خيار التبنّي، دون أن تحصر هذا الفعل الشريف بمن لا أبناء لهم. وفي هذا السياق، وفي البلاد التي تغيب فيها تلك القوانين، تطالب الكنيسة بتشريعات تسهّل عمليّة التبني ضمن أطر أنظمة الأحوال الشخصيّة المحليّة، وذلك تفادياً للجوء الأهل إلى سبلٍ غير قانونيّةٍ للتبني، وأيضاً من أجل الحفاظ على حقوق الأطفال ومنع الاتّجار بهم.
مسائل نهاية الحياة
35. الموت الرحيم: الحياة عطيّةٌ صالحةٌ من لدن الخالق، فلا يحقّ لأحدٍ انتزاعُها أو التطاولُ عليها أو التفريطُ فيها. إنَّ الألمَ، الذي ينبّه الإنسان إلى محدوديّته، والذي ينبغي تخفيفه بكلّ الوسائل المشروعة طبيّاً، لا يبرّر الموت الرحيم. فالكنيسة تشدّد على معنى الحياة كزمنٍ للرجوع إلى الله والتنقيةٍ الداخليّة يعيشه الإنسان المسيحيّ بالتوبة والمصالحة مع الله ومع سائر الناس، ومع الذات أيضاً. لهذا نرفع الصلاة "لتكونَ أواخرُ حياتنا مسيحيّةً سلاميّةً بلا خزيٍ" (الطلبة التَّكميلية في الخدم اليوميّة).
36. تؤمن الكنيسة أنّ الإنسان يرقد عند موته ولا ينتهي وجوده، بل يكون الموت معبراً إلى الحياة الأبديّة. وعند المجيء الثاني للمسيح سيقومُ الإنسان بجسدٍ روحيّ (1كورنثوس 15: 43-44). لذا، تطلب الكنيسة من الأطبّاء أن يحافظوا على أكبر قَدْرٍ من الوعي لدى الإنسان المريض بأقلّ مقدارٍ من الألم، مع إيداع حياته في عهدة الله الرحيم.
37. أدّى التطوُّر في استعمال تقنيَّات حفظ الحياة والتكنولوجيا التي تطيلُها إلى خلق إشكاليَّةَ الموت الرَّحيم. فقد أصبح من الممكن مع الطبّ المعاصر أن تُصان الحياة البشريّة باستخدام أجهزةٍ صناعيّةٍ، حتّى في غياب أيّ أملٍ في شفاء المريض. هذه الوضعيّة ليست إلاّ تمديداً قسريّاً لطور نزاع الموت. وأمَّا إنهاء الحياة الإراديّ، من أجل تجنّب الألم وحسْب، فلا يتوافق والرجاء بالله. من هنا تبدو مواجهة نهاية الحياة من دون اللجوء إلى الماكينات الطبّيّة أبسط وأكثر طبيعيةً، فيترك المرء الأمور تسري وفقاً للمشيئة الإلهيّة، دون أن يلجأ إلى أجهزةٍ طبيّةٍ لإطالة عمر المريض. برأي الكنيسة، العلمُ مفيدٌ حين يساعدُ الناسَ على إعطاءِ معنًى لحياتهم، وعلى التوبة، والعيش مع الله، وحين يساعدهم على مواجهة نهاية الحياة بطريقةٍ مسيحيَّةٍ في يقين الإيمان وفي يقظةٍ روحية.
38. تتفّهم الكنيسة أنَّ قوّة الألم الجسديّ يمكن أن تقود الإنسان إلى حالةٍ من الغضب واليأس والاكتئاب والتمرّد التي تبلغ به أحياناً حدّ طلب الموت الرحيم. إلا أنّها تعتبر، فيما تُشاركه ألمه، أنّ قبول الألم بإيمانٍ واتّكال على الله يُنتج صبراً وتعزية، ويؤدّي إلى الشكران ورجاء الخلاص والشفاء الداخليّ، كما يقول الرسول بولس: "عالمينَ أنَّ الضيقَ يُنشئُ صبراً، والصبرُ تعزيةً، والتعزيةُ رجاءً، والرجاءُ لا يُخزي" (رومية 5: 3-5). وتشدّد الكنيسة على دور الجماعة الكنسيّة في مرافقة المريض وإظهار محبّتها واحتضانها له، والصلاة من أجله وذكره في القدّاس الإلهيّ، مساعدةً إيّاه على الثبات والصبر.
39. العناية بالمرضى في مراحل حياتهم الأخيرة: تهدف هذه العناية إلى تشديد المريض وجعل هذه المرحلة الصعبة قابلةً للاحتمال بواسطة تقديم أساليب الراحة والعناية له وصولاً إلى نهايةٍ سلاميّة، من غير اللجوء إلى وسائل طبيَّةٍ مضنيةٍ للمريض. تتطلّب هذه العناية التلطيفيّة تأمين الخدمة اليوميّة للمريض ومرافقةً مُحبّةً وإرشاداً وصلاة.
40. وهب الأعضاء: تقبلُ الكنيسة بوهبِ الأعضاء كعملِ محبّةٍ يوصي به الواهب بكلّ حرّية، شرط ألّا يؤذي الإنسانُ نفسَه. أمّا في حالات الوفاة المفاجئة فيعود القرار للوصيّ على الميت. وتحذّر الكنيسة من الروح النفعيّة والتجاريّة التي يمكن أن تستغلّ معايير طبيّة بهدف نزع أعضاء إنسانٍ حيٍّ، لبيعها لسواه، إذ لا يجوز، في أيّ حال، أن تُصبح الأعضاء سلعةً تجاريّةً.
قضايا أخلاقيّة وحيويّة أخرى
41. العزوف عن الزواج: تنظر الكنيسة بألمٍ إلى هذه الظاهرة، وإلى انتشار ظواهر أخرى كالعزوف عن الزواج الكنسي والاكتفاء بالزواج المدني، أو المساكنة بدون زواج، وظهور ما يسمّى "أنماطاً جديدةً" للحياة الزوجيّة،كزواج المثليّين ولجوئهم إلى وسائل مختلفةٍ لجلب الأولاد. كلّ هذا أدّى إلى تشوّهاتٍ مختلفةٍ، مخالفةٍ لشكل العائلة المألوف، وتناقضٍ مع رؤية الكنيسة للإنجاب باعتباره ثمرة حبٍّ واتّحادٍ بين الزوجين. صرنا نشهد وجود أبناءٍ لا يعرفون آباءهم أو أمّهاتهم، أو لديهم أبوان أو أمّان، أو أمّهاتٍ يحيون مع أبنائهنّ في غيابٍ كاملٍ للأب، أو آباءٍ يحيون مع أبنائهم في غياب الأمّ، أو مجمَّعاتِ مساكنةٍ جماعيّةٍ حيث ينشأ الطفل "محتضَناً" في بيئةٍ لا تعترف بالحاجة إلى دور الأمّ ولا بضرورة وجود الأب.
42. المساكنة: يشدّد إيماننا المسيحيّ، إزاء تفشّي ظاهرة المساكنة بين شخصَين غير مرتبطين بزواجٍ شرعيٍ على أنّ حياة الشركة الزوجيّة مباركةٌ من الله، إذ إنّ الزواج سرٌّ من أسرار الكنيسة، وليس مجرّد عقدٍ أو عهدٍ. وهذا السرّ يتمّمه الربّ يسوع المسيح داعياً العروسَين إلى الاتّحاد به، "فيصيران كلاهما جسداً واحداً"، ويكون الزواج بذلك مسكناً للربّ. فإن المساكنة بين الرجل والمرأة لا تؤدي إلى حياةٍ زوجيّةٍ مستقرّةٍ ومتناغمة، رغم كون هذه الظاهرة قد أصبحت مقبولةً في بعض الدول والمجتمعات. لقد دعا الربّ يسوع المرأة السامريّة التي كانت تُساكِن رجلاً إلى التوبة والتنقية، قبل أن تتمكّن من المشاركة في "الماء الحيّ" (يوحنّا 4: 10). هذه المشاركة، التي هي السبيل إلى الفرح الثابت، هي ما ترجوه الكنيسة لأبنائها.
43. المثليّة الجنسيّة: خلقَ اللهُ الإنسانَ على صورته ومثاله، ذكراً وأُنثى (تكوين 1 و2، متَّى 19: 4-6). لهذا تعتبر الكنيسة استناداً إلى الكتاب المقدّس، وإلى خبرتها، أنّ المثليَّة تُعارض الترتيب الإلهيّ منذ البدء في التمايز الجنسيّ لدى الإنسان بين ذكرٍ وأنثى، وتخالف سرّ الزواج المقدّس بمفهومه الكنسيّ. وهي بالتالي لا تتوافق مع الـمسار الطَّبيعيّ للحياة الزّوجيَّة الَتي أرادها الله للإنسان (التكوين 19: 4-8، اللاويين 18: 22 و20: 13، رومية 1: 24 16-27، 1 كورنثوس 6: 9، 1 تيموثاوس 1: 10). ولَئِن أصدرتِ الدُّول قوانين تقبل فيها الزواج المثليّ، فهذا لا يثبت شرعيَّته من الناحية الكنسيّة. هذا عدا عن الظواهر المعاصرة غير المألوفة التي تتناول مسألة "الجندرة (تغيير الجنس)"، وما يشيع في مجتمعات اليوم من ظواهر تحويل الجنس أو التلاعب بالجينات. الكنيسة ترحّب بالتقدم العلميّ، لا سيما الطبّي، لكنّها تتحفّظ عليه حين يجرّد البشر من إنسانيّتهم.
44. تدعو الكنيسة المؤمنين إلى احترام ومحبة كلّ البشر، وتحثّهم على السعي لتحقيق ملء قامتهم الإنسانيّة بواسطة الحياة في المسيح التي تتحقق باقتناء الروح القدس. يقتضي عيش هذه الحياة أن يسعى المؤمن من كلّ قلبه ونفسه وفكره وقدرته نحو التوبة، متسلِّحاً بإيمانه بالمسيح وصلاتِه ومطالعته للكتب المقدّسة، مجاهدًا وضابطاً نفسَه وأهواءَه (1 كورنثوس 9: 25). يُعطي الربُّ، بمحبته التي لا تُحدّ، الإنسانَ التائب نعمَةً كي يحمِلَ صليبَهُ ويعبرَ إلى ميناءِ الخلاص. وهكذا يستطيع الإنسان بإرادته، وبمعونة الله، أن يعودَ إلى الممارسة الصَّحيحة، وإن عانى في البداية من الألم وغصب النَّفس.
45. تشدّد الكنيسة، مع متابعتها لنتائج البحوث الطبّية المختلفة المتعلّقة بالمثليّة، على ضرورة مرافقة الأب الروحيّ لهؤلاء الأشخاص وإرشادهم، بمحبّةٍ ومن دون إدانةٍ، بمساعدة الأهل وصلوات الجميع لتفعيل نعمة الله في نفوسهم كي يَسْلُكُوا طُرُقاً مناسِبَةً تقودهم إلى ممارسةٍ سَوِيَّة. يَتَطَلَّبُ الأمر صبراً طويلاً ومحبَّةً كبيرةً من المرشدين والعائلة، وتعاوناً وثيقاً ومستمِرّاً بين الشخص المعنيّ والأب الرُّوحيِّ والطَّبيب والأهل.
46. الإدمان: هو عبارةٌ عن حالةٍ نفسيّةٍ وسلوكيّةٍ يمرّ بها الإنسان نتيجة تأزّماتٍ وشعورٍ بالغربة عن الذات وعن البيئة الحاضنة له بامتياز، أي العائلة. الإدمان ليس عاملاً وراثيّاً، بل نتاجُ سلسلةٍ من الأسباب تتفاقم، منها اشتداد صعوبات الحياة العائليّة والفراغ العاطفيّ والتربية الخاطئة، وما قد تؤدّي إليه هذه الأسباب من اكتئابٍ وعزلةٍ تستأسر بالإنسان. فيلجأ الشخص إلى العزلة والإدمان على ما يُفرِّج عن تأزّمه الشخصيّ، ويُلبّي مزاجه، ويُريح أعصابه من مخدّراتٍ أو جنسٍ أو عنفٍ أو وسائل إلكترونية أو أيّ شكلٍ من أشكال السلوكيّات المبالغ فيها.
47. إنّ المخرج من الاكتئاب الذي يدفع الإنسان إلى الإدمان، يكمنُ في العمل على تفعيل نعمة المعموديّة بالعودة إلى الالتزام في حياة الكنيسة، والالتصاق بكلّ ما هو صالح، بالإضافة إلى المتابعة الطبّية الضروريّة. الله يفتح دائماً باب التوبة، وبدء التوبة أن يعرف الإنسان أنّه محبوبٌ من الله، فيتغيّر. ولئن كان ترك الإدمان أمراً لا يسهُل على الإنسان، إلّا أنّه مستطاعٌ لدى الله، إن طلب المدمن معونته. تلفت الكنيسة ههنا إلى أهميّة مرافقة الكاهن أو المرشد للمدمن في شركة الكنيسة، وإلى ضرورة الاستعانة بالبيوت التأهيليّة على رجاء انتقاله من فراغ فضاءٍ افتراضيٍ عقيمٍ إلى مراعٍ خضرٍ (مزمور 23).
48. التحرّش بالأطفال والأحداث: يتعرّض بعض الأطفال أحياناً في المجتمع إلى تجارب قاسيةٍ ليس التحرّش الجنسيّ إلّا إحدى ظواهرها الأشدّ خطورة. تدين الكنيسة التحرّشَ الجنسيَّ بالأطفال بمختلف أشكاله، أيّاً كان مُرتَكِبُه. وتعتبره انتهاكاً لبراءتهم، وجُرماً يقتضي ملاحقة المرتكب ومعاقبته. وتطالب كلّ المعنيّين، من الرعاة والأهل، باتّخاذ ما يقتضي من إجراءاتٍ لوقاية الأطفال من أيّ تحرّشٍ، ولتأمين بيئةٍ سليمةٍ حاضنةٍ لهم. كما تطالب الأهلَ بمتابَعةٍ تربويّةٍ تساهم في توعيةِ أولادِهم وتنميةِ فضيلةِ التمييز لديهم وما يلزم من تربيةٍ جنسيّةٍ، دحضاً لأيّ استغلالٍ لهم أو احتيالٍ عليهم سواء بواسطة الميديا ووسائل التواصل الاجتماعيّ أم بشكلٍ جسديّ مباشر.
49. تشجّع الكنيسة الأهل على تربية الأطفال على الحسّ النقديّ الذي يساعدهم على تقصّي الحقيقة والصواب عندما يشاهدون التلفاز أو يتعاطون وسائل التواصل الاجتماعيّ وسواها. فالتربية الجنسيّة في البيت مهمّةٌ أيضاً لأنّها تحصِّن الأطفال ضدّ مخاطر الإباحيّة أو السلوك الجنسيّ الخاطئ.
← القسم الرابع: دور العائلة في حياة الكنيسة
50. يدعو القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم الزوج والزوجة لأن يجعلا بيتهما كنيسةً صغيرةً: "ليكن بيتكم كلّه كنيسة" (أعمال الرسل، عظة 26،PG 60:201-204). هذا يتحقّق بصَلاتهما وصومهما ومشاركتهما كلاهما في حياة الكنيسة، واحترام كلٍّ منهما للآخر، وبتشديد بعضهما البعض في فعل المحبّة وعيش الفضائل، فيكونان مثالاً لعائلتهما.
51. إنّ مثال حياة الأهل اليوميّة هو الطريقة الفضلى لتشرّب الأبناء الحياة في المسيح، ويكون ذلك بالتعليم المجسَّد أفعالاً وتصرّفاتٍ والذي يؤثّر بفاعلية كبرى في الأولاد ويعطيهم مثالاً مُعاشاً في الحياة. يقول القدّيس بورفيريوس الرائي في كلماته: "إنّ ما يقدّس الأولاد ويجعلهم صالحين هو حياة الوالدين في المنزل. ينبغي على الآباء أن يعطوا ذواتهم لمحبّة الله، وأن يصبحوا مثل القدّيسين بالقرب من أولادهم، بوداعتهم وصبرهم ومحبّتهم لهم" (الشيخ بورفيريوس الرائي: سيرة وأقوال، ترجمة راهبات دير السيّدة، بلمانا، 2005، ص. 370). فقداسة الوالدَين عبر عيشِهما حياة التوبة والغفران هي أفضل طريقة لتربية الأطفال في الربّ. إذ ذاك يُصبح المنزل مدرسةً للحبّ والتضحية اللذَين هما الضمانة الفاعلة في مواجهة العائلة لسائر التحدّيات المجتمعيّة.
52. يُولي بعضُهم اهتماماً زائداً بعلم أولادهم وصحّتهم ومستقبلهم الاجتماعيّ على حساب البعد الإيمانيّ. تنصح الكنيسة المرأة الحامل بأن تبدأ بالصلاة من أجل جنينها معتنيةً بالعطيّة الإلهيّة التي تنمو في جسدها. ويؤكّد القدّيس بورفيريوس أنّ التربية تبدأ من لحظة الحمْل بالجنين (الشيخ بورفيريوس الرائي: سيرة وأقوال ص. 369). وكخطوةٍ أولى في طريق التدرّب على حياة القداسة، تنصح الكنيسة الأهل بالعودة إلى التقليد الأرثوذكسيّ القديم والمبارك، أي اعتماد أحد القدّيسين شفيعاً لمولودهم الجديد والتفاعل الصلاتيّ معه، الأمر الذي يوطّد علاقة العائلة بالقدّيسين ويعود بالمنفعة الروحيّة على الأهل والأولاد معاً.
53. يذكّر آباء الكنيسة الأهل بأنّهم "يربّون إنساناً مجاهداً ومواطناً في السماء" (القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم "مقالة في المجد الباطل وتربية الأولاد"،SC 188: 104). لذا، عليهم نحت أولادهم بمهارةٍ وفنٍّ كبيرين. هذا يقتضي الانتباه، كما سبق الذكر، إلى ما تتطلّبه هذه التربية من إحاطةٍ وتفرّغٍ لحضور الأهل في أوجه حياة أولادهم اليوميّة. إنَّ ما يعكسه غياب الأهل المكثَّف عن هذا الحضور والاستقالة من مسؤوليتهم التربويّة، في كثيرٍ من الأحيان، وترك الأمر على عاتقِ معاونيهم المنزليّين أو لدور الحضانة، يولّد عند الولد قلقاً يطبع سلوكيّاته المستقبليّة. إنّ التربيةَ عملٌ مقدّس ومباركٌ وهي شأنُ الأمّ والأب، ومسؤوليّتهما معاً. وتبقى المسؤوليّة كبيرةً أيضاً على جميع الرعاة والإخوة في الكنيسة لرفد العائلات بما يبسّط تعقيداتِ الحياة اليوميّة ويقدّم لهم التعزيات الآتية من الله، فينشأ الأبناء على ما يصقل شخصيّتهم من القيم الإنسانيّة، لاسيما المحبة الأخوية والشركة مع الآخر، وينمّيهم في الحريّة الخادمة لخلاصهم بحيث يمتلكون الوعي والآفاق الواسعة والقدرة على تبنّي الخيارات الحياتية المسؤولة.
54. ينصح الآباءُ القدّيسون أن يصير كلّ بيتٍ مسيحيٍّ مكانَ صلاةٍ يُشارك فيها جميع أعضاء العائلة، إضافةً الى الصّلاة الفرديّة لكلّ عضوٍ من أعضائها. كما أنَّ القراءة اليوميّة للكتاب المقدّس في البيت تغذّي الروح وتنير العقل، وهي حاجةٌ أساسيّةٌ لجميع أفراد الأسرة وميناءٌ للطمأنينة وسطَ دوّامة الحياة والانشغالات الكثيرة. يقول القدّيس يوحنّا الذهبيّ الفم: "اقتنوا كتباً تكون بمثابة أدويةٍ للنفس. اقرأوا أسفار الإنجيل وأعمال الرسل على الأقلّ لتتعلّموا منها" (الرسالة الى أفسس، عظة 21، PG 62: 151). وتذكّر الكنيسة بما للمشاركة العائليّة في الخدم الليتورجيّة من أهميةٍ في حياة العائلة ودورٍ في نهوضها الروحيّ.
55. تُعتَبَر العائلة مختبر عيش الفضائل، ومصنع الإيمان، ومشتل النموّ بالمحبّة. يتدرّب الإنسان في الأسرة على عيش المحبّة بكلّ أبعادها بدون حسابٍ، رغم تعدُّد وجهات النظر بين أعضائها. إنّ اختبار فضيلة المسامحة والغفران، مع التدرُّب على الإصغاء والحوار وقبول الآخر، يصقل الفرد ليصير ناضجاً في علاقاته المجتمعيّة.
56. ينمو المرء ضمن العائلة في روحٍ من المسؤوليّة والشركة والتعاضد بحيث يكون لكلّ عضوٍ من أعضائها دورٌ يتمّمه، واضعاً خير العائلة فوق مصالحه الشخصيّة، ومدركاً أنّ الحاجات الفرديّة لا تُلبّى إلّا ضمن نطاق عيش الحياة العائليّة التي ترتكز على روح التضامن بين أفرادها على سائر المستويات، حينئذٍ يصير خيره من خير العائلة ككلّ، ومتطلّباته الحياتيّة الشخصيّة جزءاً من متطلّبات الكلّ.
57. إنّ نموذج "الكنيسة العائلة" النامية في الإيمان وعيش حياة الصلاة، وقراءة الكتاب المقدّس، والمشاركة في الليتورجيا، يوحّد العائلات المنتشرة في أقاصي المسكونة، مهما تباعدت جغرافيّاً، ويضمّها معاً إلى عائلة الله الكُبرى. الإيمان الواحد هو ما يجمع وما يجب تنميته. والسلوك بالمحبّة والشركة الناتجة عن وحدة الإيمان والليتورجيا والإفخارستيّا هي الترجمة الجامعة التي تنمّي إحساس أعضاء العائلات ومشاركتهم لما يصيب الإخوة في العائلة الكُبرى وأقرباءهم في الإنسانيّة.
← القسم الخامس: توصيات رعائيّة
58. الرعاية المتخصّصة: إزاء المشاكل والتحدّيات العديدة المستجدّة، تزيد الحاجة إلى الرعاية المتخصّصة عبر تفعيل دور المؤمنين المؤهَّلين في هذه الخدمة. باتت الاستعانة بالموهوبين وبأصحاب الاختصاص من المؤمنين، إلى جانب الكهنة، حاجةً مُلحَّةً ومطلوبةً تساعد الكاهن في القيام بمهامّه الرعائيّة بالشكل المطلوب أمام تعقيد المشاكل وتطوّر العلوم، لا سيما الإنسانيّة، والضرورة التي تستدعي الكنيسة إلى رعاية جميع شرائح المؤمنين، من الأولاد إلى الشيوخ، فضلاً عن المرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة والأيتام والأرامل...إلخ.
59. دوائر خدمة العائلة: تتجسّد خدمة العائلة في العمل الرعائيّ في الأبرشيّات والرعايا من خلال القيام باجتماعاتٍ دوريّةٍ للعائلات وبرامج للإعداد الزوجيّ، وأنشطةٍ رعائيةٍ ورياضاتٍ روحيةٍ تشارك فيها العائلة كلّها (الوالدان والأبناء)، بالإضافة إلى ورش عملٍ تُعرَض فيها دراساتٌ آبائيّةٌ وعلميّةٌ تتناول وضع الأسرة في مختلف المجتمعات. يتبع ذلك إنشاء دوائر متخصّصة لدعم العلاقة الزوجيّة والإرشاد العائليّ، والمساعدة الاجتماعيّة، تُسهم في حلّ الخلافات والنزاعات الزوجيّة. ثمّة خبراتٌ متفرّقةٌ في الأبرشيّات تجدر الاستفادة منها.
60. التدريب المستمرّ على الرعاية: تبرز حاجة ملحّة إلى كهنة وعلمانيّين مدرَّبين على إسداء الإرشاد الروحيّ والاستشارات القانونيّة والطبيّة، وإقامةِ وُرش عملٍ حول فنّ الإصغاء والمصالحة وحلّ النزاعات. ولا بدّ من أن تحرص الكنيسة على تلبية هذه الحاجة عبر برامج إعدادٍ ودوراتٍ تدريبيّةٍ مختصّة.
61. الدور الروحيّ للكاهن: وعي الكاهن لدوره الروحيّ هو الأساس لتنشئة العائلات التي يخدمها على الحياة في المسيح، وذلك عبر السعي إلى إقامة الاجتماعات والسهرات الروحيّة لها، وتحفيز أعضائها على تحسّس معنى الحياة الليتورجيّة وقيمة الاشتراك في القدّاس الإلهيّ وتناول القدسات، وممارسة سرِّ التوبة والاعتراف، ومساعدتِها على تنمية حياة الصلاة، بخاصّةٍ على الصعيد العائليّ. ويبقى للكاهن مجالاتٌ واسعةٌ أخرى في خلق مبادراتٍ رعائيّةٍ لتقوية الحياة في المسيح عند الزوجَين.
62. التنشئة المسيحيّة: للتنشئة المسيحيّة والبشارة أهمّيّةٌ مركزيّةٌ في حياة العائلة والكنيسة. فقد كان الربُّ يسوع هو المعلّم الأول، وأمضى السنوات الأخيرة من حياته على الأرض يعلِّم ويبشِّر. الرسول بولس يقول: "ويلٌ لي إن كنتُ لا أبشِّر" (1كورنثوس 9: 16). لذا، فإنّ التعليم المسيحيّ له دورٌ أساسيّ في تنشئة الأولاد والأهل ووالدِيهم على حدٍّ سواء، ممّا يساهم في تأسيس عائلاتٍ مسيحيّة. من هذا المنطلق، تستخدم الكنيسة كلّ الوسائل النافعة للبشارة، المطبوعة منها أم السمعيّة أم البصريّة، أم المحاضرات والندوات والاجتماعات، أم اللقاءات والأنشطة وسواها. هذه من شأنها أن تولّد روحاً سلاميّةً تسود جوّ العائلة، وفكراً مستوحىً من تعاليم الكتاب المقدَّس ومن خبرة الكنيسة تتسلَّح به العائلة لمواجهة فكر الاستهلاك السائد في أوساط المجتمع الحديث.
63. ثقافة المرافقة: تستعين الكنيسة بالاختصاصات لمرافقة بعض الحالات، كالمقبلين على الموت وذوي الاحتياجات الخاصّة والأزواج المتنازعين...إلخ. فالمرافقة تتطلّب معرفةً جدّيةً وعميقةً بمقاربة الإنسان المعنيّ وحالته. من جهة أخرى، تحتاج الكنيسة إلى تنمية هذه الثقافة بشكل منهجيّ ومدروس، ونشرها بين العاملين في المجال الرعائيّ، لا لكونها جديدة فحسب، بل لأنّها حسّاسةٌ ودقيقةٌ بسبب خصوصيّة كلّ فردٍ، وهي دربٌ لا بدّ منه لمخاطبة الإنسان المعاصر ومساعدته على اكتشاف وجه المسيح المخلّص الذي مات وقام لكي يعطيه الحياة.
64. التشجيع على الإنجاب: إنّ وجود الأبناء في العائلة الواحدة له فوائدٌ جمَّةٌ على الزوجين وعلى الأولاد، فهو يُكِّرس الحياة الشركويّة بين أفراد العائلة الواحدة، كما وينمّي فيما بينهم حسّ المسؤوليّة والعطاء والخدمة. فالعائلة الكبيرة لا تفسح في المجال للوالدَين أن يُفكّرا بنفسيهما بأنانية، إذ إنّ جُلّ اهتمامهما ينصبّ على أبنائهما، فيتوطّد اتّحادهما معاً أكثر في عمليّة التربية التي يتقاسمانها. العائلة الكبيرة مع إخوةٍ وأنسباء وأقارب تجعل الأبناء يترعرعون في أجواءٍ جميلةٍ من المحبّة والاحتضان. وتنمّي فيهم الحسّ الاجتماعيّ في الانتماء والتواصل والمشاركة والتفاعل والتمرّس على روح العطاء.
← الخاتمة
65. تأتي هذه الرسالة حول "العائلة" في زمنٍ يشهد تبدّلاتٍ مجتمعيّةً جمّةً، وانفتاحاً عالميّاً كبيراً، وتطوّراً علميّاً متسارعاً، الأمر الذي يفرض معه واقعاً جديداً وطرائقَ تفكيرٍ وعيشٍ مختلفةٍ لها تأثيراتٌ كُبرى على العائلة. إن العائلة أصبحَت تعيش اليوم خطرَ ضياع بنيتها وهويّتها، مع ظهور أنماطٍ جديدةٍ من العائلات وأشكالٍ جديدةٍ من الأزواج وأنواعٍ مختلفةٍ من الزيجات، أدَّت إلى مشاكل جمَّة لم تعهدها من قبل. لذلك شاءَ آباء المجمَع المقدَّس، وسط كلّ هذه التحدّيات، تذكير أبناء الكنيسة أنَّ اقتناء المفهوم المسيحيّ للعائلة، وعيشَه، بدءاً من تأسيس الزواج على الإيمان بالمسيح، يبقى هو السلاح الذي به تتحصَّنُ العائلة ممّا يهدّدها، وبه تصون ذاتها من الأذى، أكانَ بالأمس أم اليوم أو غداً.
66. رغم أنّ معالجة موضوع العائلة، بتشعبّاته الكثيفة اليوم، لا يمكن الإحاطة به في صفحاتٍ كهذه، فإن كنيستنا المقدَّسة تطلق هذه الرسالة كإطلالةٍ أولى على هذه الشجون، شاخصةً إلى إطلاق حلقاتٍ لكلّ عنوانٍ من عناوينها، يُشارك فيها مؤمنون بغايةِ التعمّق في بحثِها، والوصول إلى مزيدٍ من السبل الناجعة للوقاية منها ومواجهتها.
67. "العائلة هي كنيسة المسيح الصغيرة"، ومنها تتشكّل الكنيسة الجامعة. كلُّ إنسانٍ هو نتاج عائلته، ينهلُ المسيحَ من والديه وأجداده على رجاء أن يُقدّمه للعالم. وكنيستنا تمتلئ بنماذج القداسة المولودة من التربية العائليّة. فالقدّيسان يواكيم وحنّة جدَّا المسيح الإله، قدّما للعالم والدةَ الإله الفائقة القداسة التي أعطت الفرح لكلّ العالم. والزوجان المباركان القدّيس باسيليوس الشيخ والقدّيسة إميليا، أهديا الكنيسة القدّيسِين: باسيليوس الكبير، وبطرس أُسقف سبسطيا، وغريغوريوس أُسقف نيصص، وبنكراتيوس الناسك، ومكرينا البارّة الحكيمة. هذه العائلة المثال مدَّت الكنيسة والعالم بنورٍ من نورٍ لا يغيب، وعلمٍ يفوق كلّ العلوم.
68. رجاء الكنيسة أن تبقى "العائلةُ فرح الحياة" وأن يظهرَ سرّ الفرح فيها كشركة حياةٍ وحبٍّ ومصالحةٍ، وكصورة لملكوت الله. هذا كلّه على أمل أن تُهدي عائلاتنا الكنيسة والعالم أقمارَ إيمانٍ ومحبّةٍ وسلام.