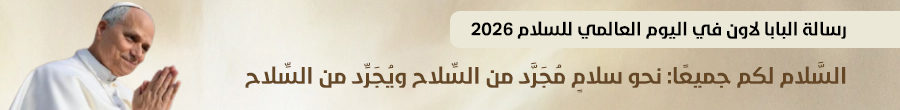موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
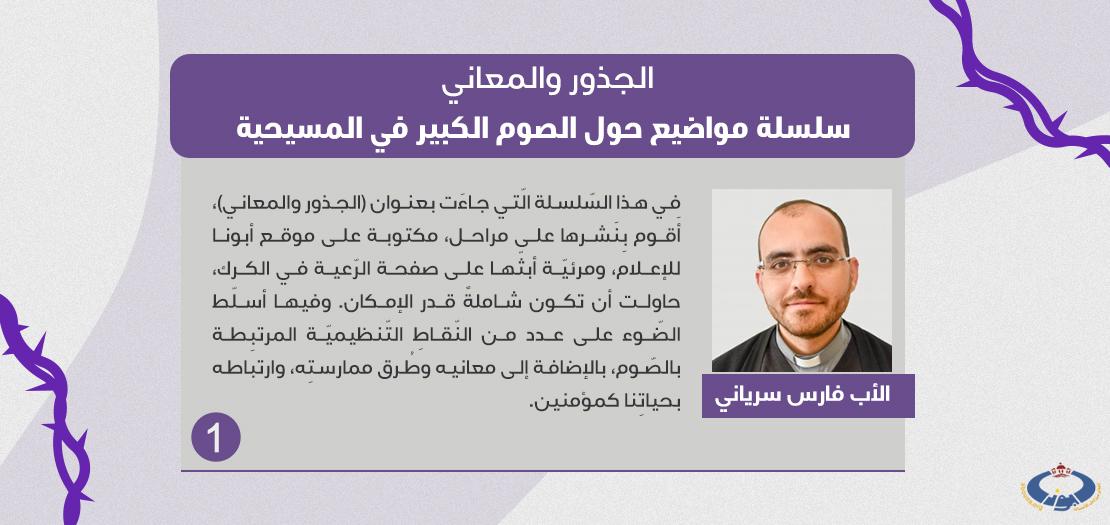
الأب فارس سرياني، راعي كنيسة "سيدة الوردية" للاتين في الكرك - الأردن
مقدمة
بَدَأنا زمنَ الصّوم المبارك قبل نحو أسبوعَين. ولِهذا الزّمنِ معانٍ إيمانيّة عَظيمة وأهدافٍ روحيّة سامية. بالإضافة إلى ما يزخرُ به من الطّقوسِ والصّلوات والعبادات، دون أن نَنسى أعمال الرّحمة بأنواعِها، وخصوصًا واجب الصَّدقة وإغاثة الفقير والمعوز. كلّ هذه الأمور وأكثر، تُعطي هذا الزّمن طابِعَه الجميل والمميّز، والّتي عليها سارَ المسيحيّون منذ النّشأة والتّكوين، وحتّى يومِنا هذا.
في هذا السّلسلة الّتي جاءَت بعنوان (الجذور والمعاني)، أَقوم بِنَشرها على مراحل، مكتوبة على موقع أبونا للإعلام، ومرئيّة أبثّها على صفحة الرّعية في الكرك، حاولت أن تكون شاملةً قدر الإمكان. وفيها أسلّط الضّوء على عدد من النّقاطِ التّنظيميّة المرتبِطة بالصّوم، بالإضافة إلى معانيه وطُرق ممارستِه، وارتباطه بحياتِنا كمؤمنين.
بالإضافة إلى أنّني قد استَقيتُ قسمًا من المعلومات المتعلّقة بالشّق التّاريخي، من مقالة للدّكتور Nicholas V. Russo، بعنوان (The Early History of Lent/ التّاريخ المبكّر للصّوم). والدّكتور روسّو هو مساعد عميد كلّية الآداب في جامعة نوتردام الكاثوليكيّة، في ولاية إنديانا الأمريكية، ويحمل درجة الدكتوراه في الفلسفة وفي تاريخ الّليتورجيّة. حيث تبحث مقالته في النّشأة التّاريخيّة لهذا الزّمن. وأيضًا سأتطرّقُ إلى قضيّة جواز أكل السّمك خلال هذا الزّمن، محاولًا توضيحها من وجهة نظر الكنيسة الكاثوليكية. راجين أن تحملَ هذه السّلسة الفائدة المرجوّة، للقارئين الأعزّاء والمشاهدين الأحبّاء.
المرحلة الأوّلى: نقاط عامّة إيضاحيّة

1) معنى الصّوم وأصوله
الصّومُ لغة هو مصدرٌ، يُفيد الإمساكَ عن الْمُفطِراتِ بأنواعِها، والامتناع التّام عن كلّ أكلٍ أو شربٍ، وأيضًا عن عادةٍ وعملٍ مُعيّن. فَصِيامك عن عادةِ التّدخين، يعني التّوقّف الْمُطلَق عن الدّخان بكافّة أشكالِه، ربّما لِفَترة مؤقّتة، وربّما انقطاعًا مدى العمر. وقد يكون الصّوم واجبًا أو فرضًا دينيًّا، أو قَد يكون وسيلة خاصّة لبلوغِ غايةٍ مُعيّنة.
والصّوم عادةٌ عَرَفَتها الحضاراتُ القديمة منذُ آلافِ السّنين، وَفريضةٌ مارَستها الشّعوب الغَابرة، لأسبابٍ دينيّة واجتماعيّة، وأيضًا لِدواعٍ صحّيةٍ واسْتِطبَابيّة. حتّى أنّنا في أقوالِنا المأثورة، نقول: (إن أوجَعك راسَك اِكرمه، وإنْ أوجَعك بطنَك اِحرمه). فَلِكُلِّ ثقافةٍ وديانة، أنَماطُها وأهدافُها الخاصّة من الصّوم. ومنها ما يتقاطعُ ويَتلاقى، ومنها ما يختلِف ويتوازى. ولكنَّ نمط الفعل يبقى واحد، ألا وهو الامتناعُ والإمساكُ عَن.
فالفراعنةُ الِمصريّون عَرفوا الصّومَ قبلَ نحوِ ثلاثةِ آلافِ عام. حتّى أنَّ كلمةَ صوم العربية، اِشتُقّت مِن الكلمةِ الهيروغليفيّة "صَاوّ"، والّتي تَعني كَبَحَ أو امْتَنَعَ عن. إذْ كانَ الفراعنةُ، يَصومونَ في مواسمَ وأوقاتٍ مُعيّنة خلالَ العام، فَيَمتنعونَ عن الأكلِ والشُّربِ خلالَ النّهارِ، منَ الشّروقِ حتّى الغروب. وكانَ صومُهم بِهَدفِ التّقرُّبِ من الآلهةِ، والحصولِ على البَرَكة، وَتَطهيرًا مِنَ الْمُخالفات الْمُرتَكبَة، وتقرُّبًا من أموَاتِهم، وَحِفَاظًا على صِحّة أَجسادِهم.
أمّا عِنَدَ اليهود فهناكَ صوم (يوم كيبور)، أو ما يُعرف بيوم التّكفير. حيثُ يبدأُ من غروبِ اليوم السّابق، ولمدة 24 ساعة تقريبًا. فَيُمضون ساعات طويلة من الصّلاة المكثّفة في المعابِد، مُنقطعين عن كلّ طعام وشراب، وغيرِه من الأعمال الّتي يُمنع القيام بها. بهدف التوبة والاستغفارِ والاغتسالِ من الآثام.
وفي الإسلام، الصّوم أحد الأركان الخمسة، وفريضة أساسيّة وَجب القيام بها. وشهر الصّوم هو شهر رمضان. إذ يبدأ كلّ يوم صيام، من فجر اليوم إلى غروب شمسِه، وتزدادُ مُدّتُه بازدياد عدد ساعات النّهار، في فصلي الرّبيع والصّيف.
أمّا المسيحيةُ، فهي أكثرُ الدّيانات والأتباع ممارسة للصّوم. على سبيل المثال لا الحصر، يَكفي أن تنظر إلى الكنيسة القبطية، لِتَرى عدد الأيام الّتي تصوم فيها خلال العَام. وهذا يدلّ على جوهرية ومركزية الصّوم في المسيحية ولدى المسيحيّين.
فالمسيحُ لَهُ المجد، بَدَءَ رِسالَته بالصّوم في برّية يهوذا 40 يوم وليلة، وأوصى بِه سبيلًا لقهر الشّر وغَلبة الشّرير. أضف إلى ذلك، أنَّ المسيح قد أَعطى الصّوم معناه السّامي. فَهو ليسَ غاية في ذاته، إنّما وسيلة لبلوغ الغاية. وهو ليسَ جوعًا لأجلِ الجوع، فالصّوم الْمُقتصِرُ على الجوع، هو حطٌّ من كرامة الصّوم وتبخيسٌ لِقيمتِه.
فالصّوم في المسيحيّة، لَم يَعُد يَعني فقط اِمتناعًا عن الطّعام، بل صار أيضًا إماتة للذّات (Mortification). فهو وسيلة للتّضحية بالخير الزّمني الفاني، في سبيل التّمتّع بالخير الأبدي الباقي: "إكليلًا من المجد لا يزول" (1قور 25:9). فبالصّوم نموت عن خيراتٍ مادّية، في سبيل الحصول على الخير الأعظم، الّذي هو الله نفسه. الصّوم ترفّعٌ عن المادّة، بهدف الارتقاء الحرّ صوبَ الله، دون غُلٍّ أو قيد.
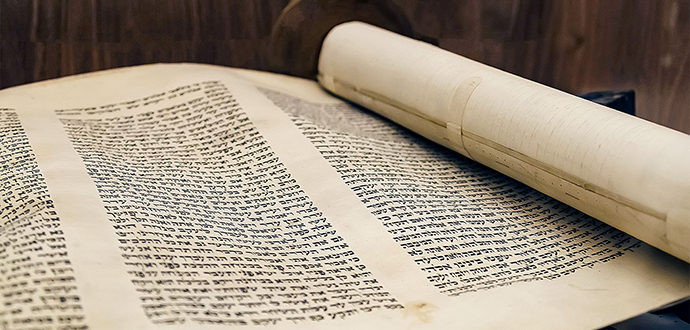
2) الصوم شريعة مقدّسة
لَقد اِنتشرَ صوم الأربعين في الكنيسة، منذ القرون الأولى. وَإِنْ كان ذلك، بعدَ بضعة قرون من صعود المسيح ونشأة الكنيسة. ولَم يقع الاختيار على هذا الرّقم (40)، على سبيل الصّدفة، بل نظرًا للأهمية الكتابيّة الّتي يحملها هذا الرّقم، وارتباطه بأحداثٍ كُبرى في الكتاب المقدّس.
فالطوّفان أيام نوح استمرّ 40 يومًا وليلة (تكوين 4:7، 12). ومراسم تحنيط يعقوب بعد وفاته في مصر دامَت 40 يوم (تكوين 3:50). ومدّة إقامة موسى في جبل سيناء لَمّا استلمَ الشّريعة، استمرّت 40 يوم وليلة (خروج 18:24). وجال الإسرائيليون في البرّية بعد خروجهم من مصر، 40 عام، يقوتهم الربّ ويُغذّيهم بالمن (خروج 35:16)، قبل دخولِهم الأرض الّتي تدّر لبنًا وعسلًا. ولذلك نجد أنّ بعض الجماعات المسيحية الأولى، قد حافظت على عادة تقديم الّلبنِ والعسل، مع القربان الأقدس، إلى المعمّدين الجُدد.
وفي العهدِ الجديد يستمرُّ الرّقم 40 في حَملِ هذه الأهمية، فهو إلى جانب كونِه الفترة الّتي أَمضَاها يسوع في البرية صائِمًا، فهو أيضًا المدّة الّتي قَضاها يسوعُ مع تلاميذه بعد القيامة وقبلَ الصّعود (أعمال الرّسل 3:1).
وحسب مُفسّري الكتاب المقدّس، فالرقم 40 يُشيرُ إلى مِلئِ حياتِنا الأرضية. كما يُشير إلى أنَّ خلاص المسيح يشمل أقاصي الأرض. فهو حاصل ضرب الرقم 10: أي عدد الوصايا الإلهية لجميعِ بني البشر، في الرّقم 4: أي الاتجاهات الأربعة، شمالًا جنوبًا، غربًا وشرقًا. وأيضًا يدلّ على فصول السّنة الأربعة. فخلاص المسيح يشمل كل البشر، في كل زمان وفي كلّ مكان.
ثمّ أنّ الصّوم نفسه هو شريعة مقدّسة أوصى الله بها، ومَارَسها الأنبياء والأصفياء، استعدَادًا لرسالة ومهمّة. واختَبَرَته الشّعوب تعبيرًا عن توبتِها وندامتِها، ورجوعِها لله طالبة الرّحمة والغُفران. حيث كانت المدّة المألوفة للصّوم في الكتاب المقدّس، هي 40 يوم.
← فموسى النّبيّ صامَ مرّتين 40 يوم وليلة على طور سيناء: مرّة عند استلامه الشريعة (خروج 28:34)، ومرّة أخرى عندما اكتشف عدم أمانه شعب إسرائيل لله ربّهم، وصُنعِهم لعجل ذهبي عبدوه دون الله، فصام عنهم تكفيرًا عن خطيئتهم وخيانتِهم (تثنية الاشتراع 18:9-19).
← وإيليّا النّبيّ سار مسيرة 40 يوم وليلة صائِمًا، حتّى بَلغَ جبل الله حوريب (1ملوك 7:19-8).
← وأهل نينوى صاموا 40 يوم، بعد إنذارهم على لسان يونان، استمطارَا منهم لرحمة الله (يونان 4:3، 7).
← والصّوم دعوةٌ مباشرة من الرب، ووسيلة للتّوبةِ والرّجوعِ إليه: "اِرجعوا إليَّ بكلِّ قلوبِكم، بالصّوم والبُكاءِ والانتحاب" (يوئيل 12:2).
وفي العهدِ الجديد، نجدُ المثالَ الأسمى، عندما انطَلَق المسيح صائِمًا في البرّية أربعينَ يومًا وليلة، (متّى 1:4-2)، بعد أن اعتمدَ عن يدِ يوحنّا المعمدان في مياه الأردن. وليس ذلك فحسب، بل أنّ المسيح شدّدَ، بِمِثالِه وتَعالِيمِهِ، على أهميّة الصّوم:
فَبِصَومِه انتصرَ على تجارب ابليس، وبِذلِك يُعلّمنا أنّ الصّوم يُعطي الإنسان مِنعةً أمام التجارب، ويُعطيه فرصة للغَلبة (متّى 1:4-11).
والصّوم وسيلة فعّالة لِلجهاد ضد الشّرير. "فهذا الجِنسُ من الشيطان لا يخرج إلّا بالصّلاةِ والصّوم" (متّى 21:17).
وفي الوقتِ عَينه، حَذّرنا يسوع من (الصّوم الاستعراضي) أمام النّاس، حيث انتقدَ بشدّة الصّوم الّذي هو مجرّد (نِفاق). "وإذا صمتم فلا تعبسوا كالمرائين فإنهم يكلحون وجوهم ليظهر للناس أنهم صائمون. أما أنت فإذا صمت فادهن رأسك واغسل وجهك كيلا يظهر للناس أنّك صائم بل لأبيك الذي يرى في الخفية". (متّى 16:6-18)

3) معنى الصوم والانقطاع
الصّوم والانقطاع حسب المعنى المسيحي، عنصران مترادفان مُكمّلان لبعضهما. لذلك التّمييز بينَهما عبارة عن (شَعرَة) ليس أكثر.
← الصوم: يَعني حرمان الذات من الطّعام، والامتناعُ عن تناول أيّ شيء، لِفَترة مُعيّنة من الزّمن. ومن ثمَّ تناول شيء من الطعام النّباتي الصَّرف، الخالي من أيّة صبغة حيوانية. والجميلُ في الأمر، أنّ المسيح لم يَضع قوانين تحدّد ساعات الصّوم، أو قوائِم الإفطار والإمساك. ولذلك اجتهدت الكنيسة، بِمجامِعها وأساقِفتها، وأديرتِها وَرَهباناتِها وَرُهبانِها، وبحكمتها وخبرتها المتراكمة طوال قرون، أن تشدّدَ على أهمّية الصّوم الانقطاعي، عن كل ما هو حيواني (زَفَر)، أو يمتّ له بصلة. وفي نفس الوقت أعطته صبغة من المرونة، بِوَضعها مجموعة من الأنظمة، الّتي تلائم الأشخاص وتراعي ظروفهم.
هذا لا يعني أنّ الصّوم في المسيحية شيء سهل وبسيط! فَمن اختبرَ الانقطاع الكلّي الكامل، عن كل ما هو حيواني، طوال ال 40 يوم، وأكثر لدى الكنائس الأرثوذكسية، لاختبرَ مستوى الضّعف والوهن الجسدي، الّذي يصل إليه الإنسان عند نهاية الصّوم.
أمّا الصّوم فله أشكال عدّة، نورِد أهمّها:
- البعض يصوم مِن شروق الشمس إلى غروبها، ثمّ يتناول النَّزْر اليسير/ القليل من الطّعام النّباتي والشّراب.
- البعض يصوم مِن 12 ليلًا إلى 12 ظهرًا، أو ما يساوي 12 ساعة متواصلة، ثمّ يكتفي بالقليل من الطّعام النّباتي.
- والبعض يمارسون تقشّفاتٍ شخصيّة قاسية وصعبة، فبعضُهم يصوم أيّامًا متواصِلة، ويكتفي بالماء والأملاح.
أمّا الكنيسةُ الكاثوليكيّة الّلاتينيّة، كأمٍّ ومعلّمة، فإنّها تعتمد أسلوبًا تربويًّا. فنراها قَد أَعطَت مُؤمنيها هامشًا من الحرّية، لاختيار ما يُناسبهم من أشكال الصّوم وطرائِقه، بقناعة ورضى، وَبِما يفيد نموّهم الرّوحي والإيماني. واشتَرَطت الحدّ الأدنى، دون أن يعني ذلك تكاسلا أو إهمالًا في باقي الفترة.
أمّا مَن يُنادي بفرض الصّوم كرهًا وقسرًا، بالقوّة والإجبار، فَصدّقني يا عزيزي، سَيَجد النّاس عشرات المخارج والمخابئ، لكسر شريعة الصّوم في الخفية، إن فُرِضت عنوة لا مُورِسَت قناعة. وفي نفس الوقت تُراعي الكنيسة الحالة الصّحية والبّدنيّة والمرضية للمؤمن، فليس مجبرًا بالصّوم كل مَن هو مُلزم بتناول أنواع مُعيّنة من الأطعمة، لدواعٍ وأسباب صحّية وعلاجيّة.
← الانقطاع: يعني الامتناع عن أنواعٍ من الأطعمة، إمّا خلال الفترة كاملة، وإمّا أيام الجمعة والأربعاء من كلّ أسبوع، خلال فترة الصّوم. ووفقاً للتقاليد المتوارثة التي سار عليها أوائل المسيحيين، يشمل الانقطاع الإمساك عن تناول اللحوم ومشتقاتها، من ألبانٍ وبيضٍ وأجبان. كما يُنصح بشدّة التّوقف عن التدخين والكحول والحلويات. بكلمات أخرى، الانقطاع يعني منح هذا الزمن طابعًا يحمل مظاهر التّجرّد والزّهد والتّقشّف، وخاليًا من أشكال التّرفِ والرّخاءِ والمتعة المعتادة.
وبحسب مجموعة الحقّ القانوني للكنيسة الكاثوليكية الّلاتينية (الأرقام 1251-1252)، على المؤمن أن يُراعي الانقطاع عن أكل الّلحم جميع أيّام الجُمع من السّنة، ما لَم يقع فيها أعياد احتفاليّة. كَما يجب مراعاة الانقطاع والصّوم، يوميّ أربعاء الرّماد والجمعة العظيمة، وهذا ما يقصد به (الحدّ الأدنى)، وتحت طائلة الخطيئة المميتة، الواجب الإفصاح عنها في سر الاعتراف.
وبالنّسبة لقانون الصوم، فَهو ملزمٌ لكلِّ مؤمن بلغَ سنَّ الرّشد (18 سنة) وحتّى بداية السّتين. وأمّا قانون الانقطاع فَيُلزِمُ كلَّ مَن أتمّ سن الرّابعة عشرة.
يتبع...