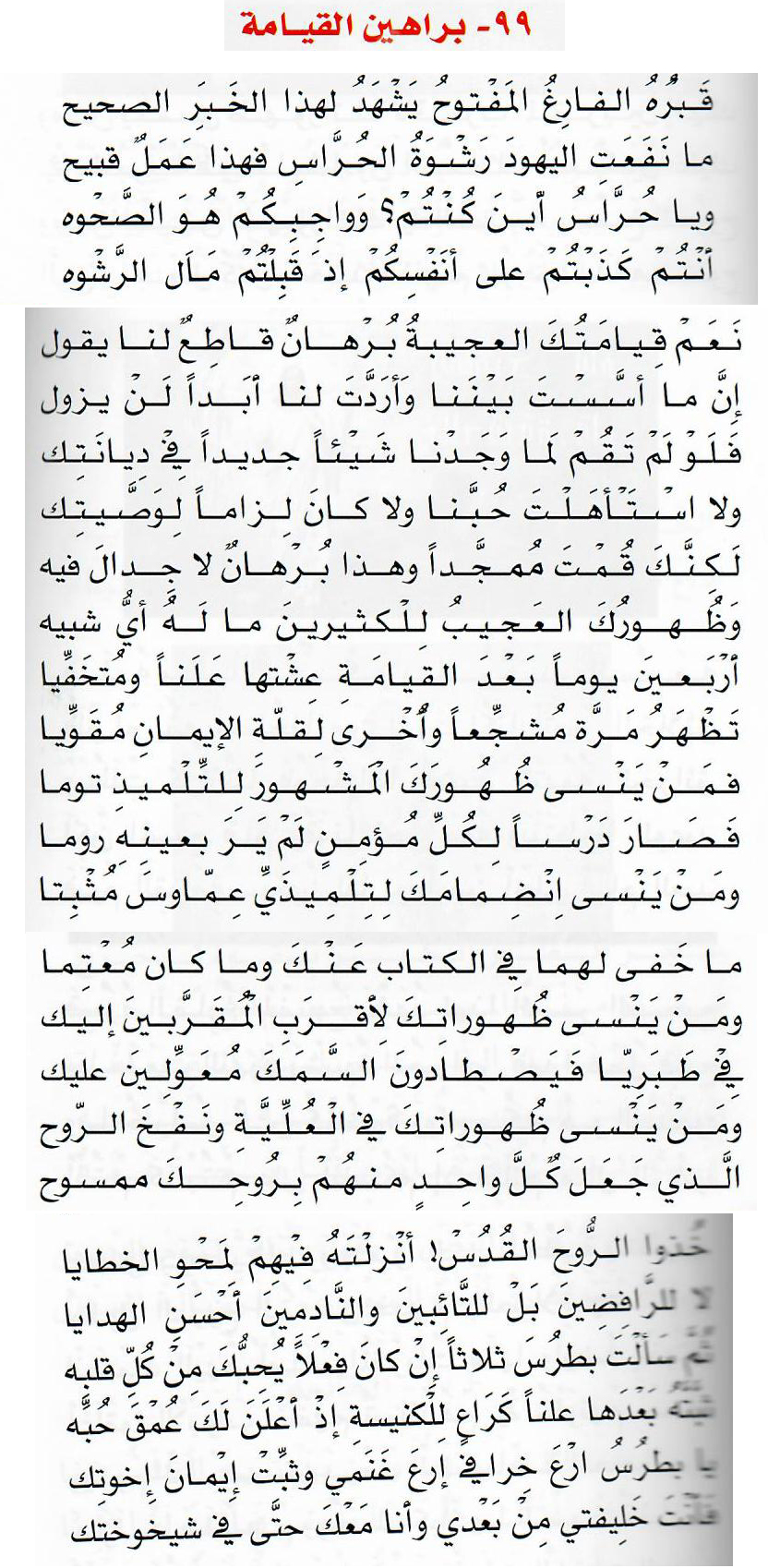موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
أحد القيامة الثاني

الأب منويل بدر - الأردن
لقد رأينا الرّب! (الإنجيل يو 20: 19-31)
كلمة قيامة هي في حدِّ ذاتها، بشارة فرح، لأنَّ عيد القيامة الّذي نحتفل به، هو أكبر عيد فرح تعرفه الكنيسة، لذا فهو بشارة مهمّة للعالم، ليعرف أنَّ يسوع قد قام من الموت. فكل ما نبشّر به بل كلُّ ما نُؤمن به، له قيمته ومكانته في حياتنا، فقط لأن القيامة خبر ثابت صحيح، ولولا عيد القيامة، لما عرفنا كيف أو ماذا نبشِّر. لذا فنحن نعبّر عن هذا الفرح بالقيامة بأنّنا نضيف دائما كلمة هلّليلويا، أي إفرحوا، وهلّلوا، لأن يسوع قد قام من الموت.
لقد رأينا الرّب! بهذه الجملة القصيرة، فاجأ الرّسلُ توما، الذي ما كان في العلّية معهم، حينما ظهر لهم سيدهم القائم من الموت، بهذا الخبر السّار، معبّرين فيه عن فرحتهم، التي ما قدِروا إخفاءها. فإمّا أن هذ الخبر صحيح، وسيشجِّعهم على الخروج من مخبئهم السرّي، ومن الخوف الذي كان يسيطر عليهم، من ساعة القبض على سيِّدِهم، حيث هرب منهم من هرب، لأنهم افتكروا أن موته، دلالة على فشله في تتميم ما جاء ليفعله في هذا العالم. والباقون اختبأوا في عليّة صهيون، يتباحثون مع بعضهم البعض، كيف ستسير الأمور، بدون سيِّدهم بينهم. وبينما هم في هذا الإرتباك، إذا بخبر قيامته يُدهِشهم، بل إذا به هو نفسه، يباغتهم ويظهر لهم. فلنتصور الفرح الذي ملأ قلوبهم. ألا نقارنه بفرح الأب، الذي فرح بمشاهدة ابنه حينما عاد: إنَّ ابني هذا كان ضائعا فَوُجِد، وكان ميتاً فعاش.
هذا الخبر، بل لنقل هذا الظهور الغير منتظر للتلاميذ، الذين كانوا مُغلِقين باب البيت المقيمين فيه، يُصلّون ويتشاورون فيما بينهم بأصوات خفيّة، خوفاً من أن يكتشفهم أي متجسس من روؤساء الكهنة والفريسيين، فيعاقبونهم لانتمائهم لذاك الذي صلبوه، وافتكروا أنهم استراحوا من معارضته لهم، وانتقاداته اللاذعة لهم في تعليمهم، فهو كان حجر عثرة لهم، أمام الجماهير. لكن السًّؤال: من أي باب أو شباك دخل عليهم يسوع، وطمأنهم عن قيامته، ثم توارى بنفس الطّريقة عن أنظارهم؟ فهذا ما يُفسِّره لنا اللاهوت: أنّ جسد الأموات القائمة، لا تعود خاضعة لقوانين الطبيعة، فلا تحتاج لمفتاح باب، كي تعبر وتخرج، بل هي أصبحت روحا من روح الله يحملها الجسد فقط منظراً.
في هذا الظهور الأوّل والمهم، من سبعة الظهورات المذكورة عن القائم من الموت لتلاميذه، كان أحد هم، واسمه توما، غيرَ موجودٍ معهم في البيت، عند الظهور الأوّل. فلمّا عاد، فاجأؤوه كلهم بهذا الخبر المفرح: لقد رأينا الرّب. ولأنّ الخبر كان غيرَ مُنتَظَرٍ، وفي تلك اللحظة بالذّات، حيث كانت أفكاره مشغولةً بمواضيع أخرى، إذ كان في جولة خارجاً، وغير مُركّز لسماع خبر غريب، لا يمت بصلة لما كان يدور في رأسه، أصابه الدَّهش، فكانت ردّة الفعل عنده، مفاجِأة لهم هم، أكثر ممّا هي له. نقول اليوم، ردّةُ فِعلٍ طبيعيّة، على خبرٍ مفاجِئ. أتصوّر أن ردة الفعل عنده كانت إستفسارا وليس نكرانا. نعم، هو باستغرابه يستوضح ولا يُنكر، كما تكون ردة الفعل عندنا إلى اليوم، عندما لا نفهم صحيحا فنستفسر قائلين: إيش يش؟ وبشروطه، يبدو أنه يطلب أكثر ممّا سمع. فهو يريد أيضا أن يكون شاهدا حقيقيا بمستواهم، أي أن يكون قد رأى بعيونه مثلهم. يمكن تبدو شروطه سلبيّة لآذانهم، فكأنه يترحّم فيها على تلك المناسبة، التي فاتته: هم شاهدوه حيّاً وهو لا؟ لذا فهو يشتاق لمشاهدة سيّده، كيف يبدو الآن بعلامات الصّلب التي شاهدها، وهي: أثر المسامير في يديه وجنبه المفتوح (يو 19.19). إذن هو يعرف ماذا حدث لسيّده، وشاهد وحشية الجنود الّذين سمّروه، وقساوة القائد، الّذي طعن قلبه بالحربة. هذا وسنسمع في الأحد القادم، أن التلاميذ كلَّهم ، عندما يظهر لهم في أماكن أُخرى، يضطربون ويشكّون بأمره، فيقدِّم لهم نفس ما طلب توما من براهين. قال لهم: ما بالكم مضطربين؟ ولمَ ثارت الشّكوك في قلوبكم؟ أنظروا إلى يديَّ ورجليَّ. أنا هو بنفسي، إلمسوني! غير أنهم لم يُصدِّقوا من الفرح (لو 39:20). أفليست هذه علامات التأكيد لنا نحن، لو، نعم لو ظهر لنا القائم في ساعة رحمانيّة؟!
أفلا يجول في بالنا نحن، عندما نسمع هذا الخبر، ونقول: آهِ يا ليتنا نعيش هذه المناسبة التي عاشها هؤلاء، الّذين شاهدوا يسوع بعد قيامته! شاهَدُوه وسمعوه، وأمضوا معه ساعات جميلة. فيا لهم من قومٍ سعداء! لكننا بالتالي نفتخر، أنَّ إيماننا مُؤسسٌ على إيمانهم. والإيمان لا يحتاج دائما إلى براهين محسوسة ومنظورة، إذ الطوبى لمن يؤمن وهو لا يرى!
إني لا أدري لماذا ألْصَقَه التّاريخ بصفة توما الغير مؤمن، خاصة في زمان غيرِ زماننا، حيث كان الإيمان بديهيا وراثيّاً، بلا سؤال ولا جواب. لكن لنقل هي المفاجأة التي ألْبكّتْه من جهة، وهيبة الخبر الغير مُنتظرٍ من جهة ثانية، هي الّتي جعلته يتّخذ هذا الموقف. هو كان يعرف بقيّةَ التّلاميذ جيِّدا، فكلّهم كانوا في شكّ، كيف ومتى يا تُرى ستحدث قيامته، إن كانت ستحدث، إذ الأناجيل تذكر في عدّة مواقع، أنهم ما فهموها إلا بعد ما حدثت. وقد أوصاهم، ألّا تذكروا شيئا لأحد، إلا متى قام ابن البشر من الأموات. فكانو يتساءلون ما معنى القيام من الأموات" (مر 10:9). تذكّروا ما قلت لكم، لمّا كنت معكم (لو 44:20)
موقف توما هذا يدفعنا إلى التّطرُّق إلى الإيمان ودوره في حياتنا. إن الإيمان في وقتنا الحاضر في مأزق كبير. فالعلم والتكنولوجيا، قد أدخلا في العالم روح العلمانية، أي باختراعاتهما الفائقة، قد خلقا روح العلمنة في البشر، فصار الإيمان كأنّه غير ضروري لحياتهم، بل هما أصبحا أكبر عائق، للقبول بالإيمان بديهيا، كما كان عند الشعوب الماضية. التّاريخ كلُّه تحامَلَ على التلميذ توما، ولم يغفر له، لا لعدم إيمانه، لكن لاستفساره من التّلاىميذ، إن هم كانوا فعلا صادقين معه. توما كان مؤمنا وبقي مؤمنا، بعكس المدّعين اليوم بأنّهم مؤمنون، لكنهم لا يرون ضرورة لوجود الله في حياتهم. الإسم الله، هو الكلمة التي كان يعرفها البشر ويؤمنون به، قبل تغلغل التكنولوجيا والعلم في العالم، إذ من يوم إلى يوم، مع هذين العامِلَين، يكتشف الإنسان قوىً خفيّةً فيه، تَحِلُّ له مشاكله بنفسه، دون الحاجة إلى الرّجوع إلى الله لحلِّها. فعليه فقط أن يكتشف في نفسه ما يفتح له العلمُ من أسرار، والتكنولوجيا من إمكانيات، إذ هذه ما عاد لها من حدود، فينسى دور الله في الحياة.
هذا التفكير هو ليس شواذ، بل إن الكثيرين، حتّى وإن كانوا لا يُعِلنون رسميا تخلِّيَهم عن الإيمان، حتى لا نقول إعلانهم ترك الدّين رسميّأ، بشهادة من الدوائر الرسميّة، إلا أن عددهم بازدياد. ففي الحياة اليومية، نلاحظ كمؤمنين، الفرق بين حياة المؤمن وغير المؤمن، أي بين عالَم الإيمان وعالَم العِلم، بين وصايا الإيمان ووصايا الرأي العام. فالمؤمن مثلا أصبح عُرضة للضّحك والإستهزاء، عندما يُظهر أيَّ تصرُّفٍ منه، نابعٍ من الإيمان، مثلاً المواظبة على حضور قداس الآحاد والأعياد، فيراه زملاؤه، الّذين معه في العمل. ويدّعون جهرا قدامه: نحن لآ نؤمن إلاّ بما نرى! فهل بوسعه هو المؤمن، أن يعطي الآن جواباً معاكساً مُقنعا؟
لا نُنكِرُ أن الإيمان يمرّ دائما وأبدا في أزمات، يجب التّطرُّق إليها. لكن وقبل الّتطرّق إليها، لا بدَّ من السؤال من جديد: ما هو الإيمان؟ من قال إنّه لا يؤمن إلاّ بما يرى أو يلمس، هو لا يعني الإيمان فعلا، إذ الإيمان لا يُرى بالعين إنما بالشهادة له في الحياة اليومية. نعم، من يدّعي انّه لا يؤمن إلا بما يرى، فهو يعني العلم والمعرفة. الإيمان يعني، القبول بما لا أرى وبما لا أستطيع إثباتَه. هو القبول بما أوحاه الله دون مقدرتنا على فهمه: إذ كما يقول توما الأكويني: الإيمان وحده يكفي(بالحقائق الإلهية).
جواب كتاب التعليم المسيحي القديم، الّذي كان عبارةً عن سؤال وجواب، على السُّؤال: ما هو الإيمان، كان: الإيمان هو القبول بما علّمه الله وتُبشّره الكنيسة. نقول: هذا صحيح، ولكنه غير وافٍ، إذ الإيمان هو ليس فقط، القبول بعبارات، بل قبل كل شيء، هو حمل المسؤولية الكاملة لحياتي، أمام ذاك الّذي خلقني وأوحي بنفسه أنه المخلِّص. أما كان يسوع يطلب ذلك من الّذين كانوا يسـألونه أن يشفِيَهم: هل تؤمن؟
الإنسان لا يقدر من تِلقاء نفسه لا أن يفهم الله، ولا أن يفسِّر من هو الله، إذ الله ليس صنفاً من المخلوقات يمكن اكتشافه أو إيجاد الطريق إليه. الطريق إلى الله والإيمان به لا يأتي من علمٍ بشري وإنما منه هو تعالى، الّذي كشف لنا عن نفسه، وإنّنا لنجد آثارَه في الخليقة، إذ هي تَحمِل ختم يده، كما وقد وضع شوقا وحنيناً في قلب الإنسان، للحياة والحب والسّعادة، التي لا يجدُها على الأرض. على قول القديس أغسطينوس "لقد خلقتنا لك يارب، ولن يستريج قلبنا إلا فيك". من وحيه هو، نكتشف أنه ليس فقط مشابهًا لنا في كلِّ شيء ما عدا الخطيئة، بل صار واحدا منا، وسكن بيننا، لأنّه يحبّنا ويريد أن نصير سعداء بقربه. فهذي هي بشرى الخلاص، التي بها دخل يسوع إلى العالم مبشِّرا: "توبوا وآمنوا بالإنجيل (مر 14:1).
هذا ويسوع يفهم بالتالي أنَّ الإيمان هو جواب الإنسان، على ما عمل الله له عن طريق ابنه ليخلِّصه. فالإيمان ليس شعوراً سطحيّا بوجود الله. لا وليس شعورًا، بضرورة ممارسة طقس ديني مُلْزِم، كالذّهاب لحصور قدّاس الأحد. الإيمان ليس بديلا أو مَلْؤُ فجوةٍ علمية. الإيمان يعني بكلِّ بساطة: أن يفتح الإنسان قلبه لكلمة الله، الّتي نشرها يسوع في سنين التبشير الثلاثة. أن نتوجّه في حياتنا إلى الله كي يُغيِّرها إلى الأفضل. فالمقتنع من يسوع ورسالته، يشعر بأن رسالته تعنيه شخصيا، وما عليه إلاّ أن يوجِّه أعماله بحسب تعاليمها.
الإنسان يستطيع أن يؤمن فقط عندما يعرف أنَّ إيمانه مقرونٌ بالمحبة. الإيمان هو جواب على محبّة الله. عندها لا بحتاج الإيمان إلى مشاهدة، إذ المحبة برهان قاطع للإيمان بدون المشاهدة. فالطوبى يا توما لمن يُؤمن وهو لا يرى.