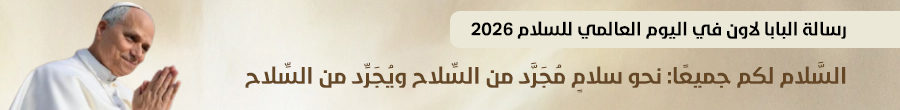موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
أخلى الله ذاته لنا ولأجلنا

نبيل جميل سليمان - كندا
تمهيد
يتمحور فهمنا عن الله في محاولتنا اللاهوتية هذه، حول نظرة شاملة إلى "سر" الله : (أحداً في جوهره / ثلاثة في أقانيمه)، في علاقة جدلية بتمام معنى الكلمة. فالله الثالوث الأحد هو "سر الأسرار المسيحية"، وهو أصلها وغايتها، بل محورها وإتجاهها. فلا يمكن حصر "سر الأسرار" في حديث واحد عنه، بل ثمة أحاديث وكتابات تسعى الى توضيح جانب من جوانبه، وإلى عرض زاوية من زواياه بعملية مستمرة منذ نشأة المسيحية عبر الكنائس والأجيال والثقافات. فليست حقيقة الله كامنة في كونه أحداً ولا في كونه ثلاثة، بل في كونه (أحداً / ثلاثة) معًا، (أحدًا - في ثلاثة / ثلاثة - في - أحد). أي التوفيق بين (وحدانية الله / التمييز في الله). لذا فإن المعنى الأخير للوجود البشري هو إننا مدعوون إلى ما نصبح "الله". فالمسيح، بحسب القديس إيريناوس (أسقف ليون، 185+): "الذي صار إنسانًا ليصير الإنسان الله"، هو الذي كشف لنا من هو الإنسان ومن هو الله. وهذا معناه إننا لا نصير بشراً كاملين إلا حين نؤلَّه، وهذا ما يحققه الله لنا عندما: "أخلى ذاته وأتخذ صورة العبد..." (التجسد)، "تواضع، أطاع حتى الموت، الموت على الصليب..." (الفداء)، "فرفعه الله، أعطاه إسماً فوق كل إسم..." (القيامة والصعود).
هذا ما جاء في نشيد الإشادة بالمسيح، العبد المتألم الذي مات وأقامه الله رب العالمين، الوارد في الرسالة إلى أهل فيلبي (2: 6-11). ومن نشيد التسبحة هذا، سنركز الاهتمام على الإنسان المسيحي اليوم ودوره في "إفراغ أو إخلاء ذاته"، وإمكانية مشاركته الفعالة في خطة الله الخلاصية: التجسد، الفداء، القيامة والصعود. إقتداءً وتمثلاً بالرب يسوع: الذي أخذ إنسانيتنا، وهو (المقياس المطلق ومثال التأنس التام).. تألم ومات من أجلنا، وهو (المشارك في قدرة الله المطلقة في المحبة والغفران).. قام وصعد إلى السماء ليهبنا الحياة، وهو (أساس الخلود والحياة الأبدية).
بــ"التجسد".. أخلى الله ذاته لنا
بالتجسد، أصبح المستحيل ممكنًا، الذي أظهر للبشر "إنسانية" الله، لأن الله: "ليس هو إلا محبة". فيسوع "الكلمة" المتجسد، قد كشف لنا: "حنان الله مخلصنا ومحبته للبشر" (تيطس 3: 4). فالكلمة أتحد بيسوع منذ البداية، والكلمة تأنسن أي صار إنسانًا، شاركنا: "في اللحم والدم" (عبرانيين 2: 14). فتأنسنْ الكلمة هو "الإفراغ Kenosis" الذي يتحدث عنه نشيد فيلبي، فالتجرد الإلهي يكمن إذًا في إن الله "الابن" أصبح إنسانًا ليكشف الله "الآب" للإنسان: "الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه" (يوحنا 1: 18)، فيسوع قد أتى ليعلن للإنسان من هو الله في سره وحقيقته.
إن الفكرة الفلسفية الموضوعة عن الله هو إنه لا يتغير Immuable ولا يتأثر Impassible، في حين إن النظرة المسيحية هي إن الله "الكلمة" قد تغيّر وتأثر من خلال "إنسانيته" بـ"إنسانيتنا". إذ أخذ جسدًا بشريًا، تأثر بالفرح والألم وبالعلاقات البشرية. وهنا أصبح تاريخ يسوع تاريخ الله نفسه وبذلك دخل تاريخ البشرية داخل الله، فأصبح الله اللامتغير "متغيرًا" بموجب التجسد واللامتأثر "متأثرًا" بالأوضاع البشرية ولاسيما الألم والموت. وربَّ سائل يقول: كيف يظل الله هو "نفسه"، وهو يأخذ جسدًا، أي "يتغير"..!؟ يجيبنا عن ذلك الآب د. فاضل سيداروس اليسوعي: "إن السر المسيحي هو سر "الهوية Identite / الغيرية Alterite" معًا، أي إن الله يصبح إنسانًا (الغيرية) دون أن تتلاشى إنسانيته في ألوهيته (الهوية)...". بما معناه إن سر التجسد يحافظ على كلتا الألوهية والإنسانية بدون أي إمتصاص أو تلاشي أو ذوبان. أي أن الله يظل هو نفسه "هويته" عندما يأخذ جسداً عن طريق "الغيرية" أي بالتبادل مع الغير.
فمع إهتمامنا اليوم بناسوت المسيح وتشديدنا على حياته الأرضية (التجسد)، وما يظهره لنا من عظمة "المبادرة الإلهية" وقدسية هذا الحدث، كما يهتف الرسول بولس: "أن سر التقوى عظيم: الذي ظهر في الجسد وتبرر بالروح" (1 طيمثاوس 3: 16)، نؤكد على "نتيجة" التجسد أي على تقديس الإنسان وتأليهه. لذا فعلى المسيحي أن يتقبل "المبادرة الإلهية"، كما تقبّل الأبن "ذاته" من أبيه عندما أخلى الآب "ذاته" لإبنه الوحيد بفعل "المحبة"، والتي هي: (هبة مطلقة وبذل كامل، فالآب يهب ذاته وكيانه ومحبته لإبنه. لذا فأن الآب هو (خروج من ذاته Extasis وإنفتاح على أبنه)، على حد قول الآب د. فاضل سيداروس. فالإختبار لذواتنا يعلمنا إن الإنسان لا يبلغ نضجه وكمال صورته، إلا بقدر ما "يخرج من ذاته" إلى العالم الفسيح ويواجه الأشياء في حقيقتها. وهي في أكثرها ظروف تعاكس رغباته الذاتية المباشرة. فالخروج من الذات هو عدم التفكير الأناني في الذات وعدم الإنطواء على الذات وعدم الإنكماش على الذات، كما تجسد الله الكلمة، وبالتالي "يتأله الإنسان" كنتيجة للتجسد، أي ينتقل إلى الحياة الإلهية.. إلى حياة الله نفسها، وهذه هي السعادة السماوية.
في "الفداء".. أخلى الله ذاته لأجلنا
لقد توصلنا إلى إن الهدف من التجسد هو "تأليه الإنسان". لكن التأليه لا يعني أبداً ذوبانه في الله أو فقدان ذاتيته فيه أو الإستعاضة عن عمل الإنسان بعمل الله، ولا عن حرية الإنسان بحرية الله، ولا عن إرادة الإنسان بإرادة الله. بيد إن تأليه الإنسان يتماشى وأنسنته، بمعنى أنه كلما أتحد الإنسان بالله أصبح أكثر إنسانية، أصبح إنساناً حقيقياً كاملاً، كما أراده الله منذ البدء وكما عاشه يسوع المسيح الإله المتأنس. حينما كشف للإنسانية جمعاء (لا للمسيحيين فقط) بعداً إنسانياً في منتهى العمق، وهو إن الحياة الإنسانية الحقيقية (لا المثالية، بل الواقعية) هي عطاء وبذل إلى الغاية، أي إلى الموت. ومن هنا ضرورة إسهام الطبيعة الإنسانية بكل ما فيها من قوى (العقل، الحرية، الإرادة) في "الفداء". لذا فإن التجسد ذهب بيسوع إلى أقصى حدود المحبة حتى الموت. إذ إن الإنسان يولد ويموت، فأراد المسيح أن يشاركنا في كل واقعنا البشري بما فيه الموت و"ما عدا الخطيئة". أي إنه "أخلى ذاته" حتى الموت على الصليب: "أحبهم منتهى الحب" (يوحنا 13: 1). وبذلك أكتملت "إنسانية" يسوع على الصليب حيث سلم كل شئ إلى الآب، مطيعاً إياه، وبطاعته التامة هذه صار هو: "الرب" (فيلبي 2: 11).
إن دستور الخروج عن الذات والموت عنها هو دستور الموجودات كلها، فالمسيح خرج عن ذاته ومات لا ليجد ذاته طبعاً، بل لينقل هذا الدستور إلى مستوى المحبة بين البشر. يريد أن يرفعنا إلى مستوى "الحياة"، كما هي في الأساس، في حياة الثالوث الإلهي: فالإبن لم يحتفظ بما وهبه الآب، بل "أخلى ذاته"، أي أعاد إلى الآب ما أقتبله منه. فكما إن الآب هو "خروج من" ذاته و"إنفتاح على" إبنه، كذلك الإبن هو "خروج من" ذاته و "إنفتاح على" أبيه. فحركة خروج الإبن من الآب، وعودته إليه بموته وقيامته، هي حركة صعود البشرية إلى أحضان الآب وأكتمالها. فالبشر الذين أقتبلهم الإبن من الآب يعيدهم إلى الآب بتبادله إياهم مع الآب، لأن الآب: "أحب العالم حتى وهب إبنه الوحيد" (يوحنا 3: 16)، والإبن أحب البشرية لأن الآب أحبهم: "أنا أحبكم مثلما أحبني الآب" (يوحنا 15: 9). وبهذه الحركة نستشف إن هدف الله المطلق وقصده، بل ومشيئته الأزلية، هي أن "يجمع ويدمج" البشرية في شخص إبنه الوحيد وجسمه المجيد وهو في أحضان الآب لتكون عن يمين الآب. ويتحقق ذلك كله بعد قيامته وصعوده إلى الآب حيث يجذب الجميع إليه (يوحنا 12: 32). بمعنى أنه يخضع لنفسه جميع البشر ليخضعهم بدوره للآب (فيلبي 3: 21 و1كورنتس 15: 27)، وهكذا يصبح الآب: "كل شيء في كل شيء" (1كورنتس 15: 28). فالمسيح في مجده يحوي كل آلام البشرية وآمالها، أفراحها وأتراحها.. وهي حاضرة بفضله داخل الثالوث. أي إن قمة الكائن البشري تكمن، لا في أن يكون واحداً وحيداً، بل في أن يكون في علاقة مع الآخرين: فذاتية الشخص أو هويته تتكون وتنمو عن طريق الغيرية، أي بالتبادل مع الغير. فليس الشخص شخصاً إلا بقدر ما هو "كائن - في - علاقة"، أي نظرة نحو الآخر وحوار مع الآخر، يندفع بالحب نحو الآخر. فكما يندفع الآب بالروح نحو إبنه الحبيب (بالإقتبال والتبادل، الواحد بإتجاه الآخر)، هكذا ينبغي أن يندفع إنسان (الأمس واليوم وغداً ...) بالحب نحو الآخر، لأنه: "على صورة الله ومثاله" (تكوين 1: 26).
الخاتمة
وهنا نصل إلى جوهر قضيتنا، من إن "الرغبة" تجعل الشخص لا يتمركز على ذاته بل على الشخص المرغوب فيه، أي على الآخر. فإن "الرغبة" الحقيقية هي تحويل من "الأنانية" إلى "الغيرية"، هي تبديل من الإنطلاق من الذات حتى الإنفتاح على الآخر لتكتمل الرغبة في الحب والعطاء المتبادلين. لذا فإن الإنسان أصبح لا يحتاج إلى الله بتمام معنى الكلمة، وإنما أصبح يرغب في الله: رغبة مجانية لا نفعية، حرة لا ضرورية، مختارة لا حتمية، لا من أجل الحاجة إليه وإنما من أجل العلاقة المجردة معه، من أجل الحب له، من أجل الرغبة فيه.
فالرغبة الحقيقية هي التي تصل بالإنسان في علاقته بالله إلى الإتحاد بفضل: التجسد والفداء، ولكن بغير إختلاط ولا إمتزاج، بغير إمتصاص أحدهما للآخر ولا تلاشي أحدهما في الآخر. وفي هذه العلاقة الإنسان / الله، يظهر الله في تواضعه وعظمته معاً، في ناسوته ولاهوته معاً، في "إفراغه" و"رفعه" (فيلبي 2: 6-11) معًا. لأن الإنسان / الله أصبحا واحداً في يسوع المسيح، فمنذ الصعود يصبح كل ما يتعلق بالإنسان يمس الله، وكل ما هو إنساني إلهي، بحسب العبارة الشهيرة للقديس إيريناوس: "مجد الله هو الإنسان الحي، وحياة الإنسان هي رؤية الله". فشخص المسيح الممجد أصبح بعد قيامته يمثل البشرية حيث يدمجها ويجمعها في شخصه، ليقودهم نحو الآب، إذ إنه "الطريق" إليه (يوحنا 14: 6). وأصبحت الإنسانية بشموليتها محتجبة في الله مع يسوع المسيح (كولسي 3: 3).