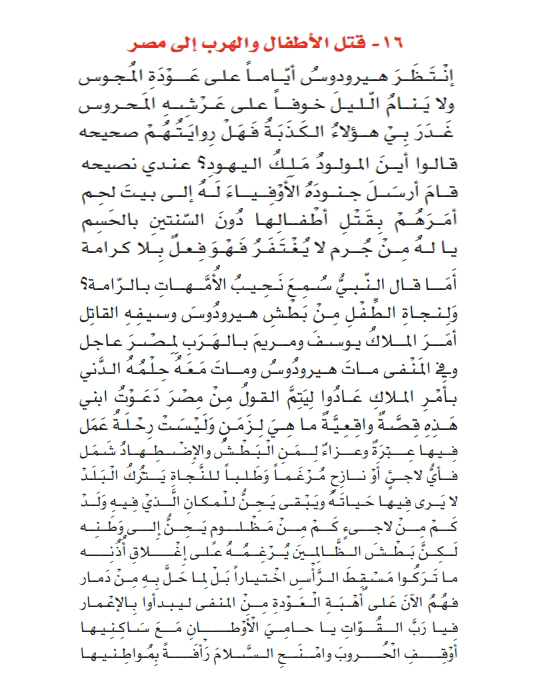موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
بعد ثلاثة أيام وجداه في الهيكل!

الأب منويل بدر - الأردن
كرزة عيد العائلة المُقدّسة (الإنجيل لو 2: 41-52)
قال أحدهم: أمام شخصين، يجب أن نثني رُكَبنا ونُحبّهما: أمام الله لأنه كبير، وأمام الطفل، لأنّه صغير. برأيي أنّه لا بديل ولا مثيل لمحبة الأهل لأولادهم. فهذه المحبّة تعلو على كلِّ محبة. وهي متأصِّلة وبديهيّة ودائمة، لا مُؤقّتة. لكن هل نتصوّر نتيجة فُقدان المحبّة، لِما يُقارب المئة ألف طفل في السنة وفي ألمانيا لوحدِها، وذلك نتيجة طلاق ما يُقارب المئة وخمسين ألف عائلة؟ لا أنسى جواب طالب المناولة الأولى، الذي كان عليه أن يعبّئ نموذج القبول للمناولة، ومذكور عليه خانة لذكر إسم الأب، فاستفسر: لكن أيَّ أبٍ أذكر؟ الأب العائش معنا أو الّذي يزورنا مرّة في الشهر؟ ماذا نقول عن هذه الكارثة؟ إنّ دُولاً وحكوماتٍ كثيرة في التاريخ، حاولت إلغاء الزّواج المعروف، وسمحت بـأي علاقة أُخرى، واهتمّت هي بتربية الأولاد في معسكرات خاصة، ولكنّها نظراً للكوارث الغير مُتوقّعة والتي أشغلت هذه الحكومات، أعلنت فشلها وعادت بعد سنين إلى القوانين المألوفة. إذ لا يديل للحياة العائليّة، والتربية بدون محبَّةِ الأهل فاشلة.
تحتفل الكنيسة اليوم بعيد العائلة المُقدّسة، مباشرة يوم الأحد الأوّل بعد عيد الميلاد، حتى ولو كان ثاني يوم، مثل هذه السنة. وهو البابا بندكتوس الخامس عشر في منتصف القرن التاسع عشر، أي عام (1854)، الذي أهدى الكنيسة هذا العيد المهم، وذلك ليلفت انتباه جميع العائلات، على فضائل العائلة المُقدّسة، ليقتدوا بها. وللمنفعه الأخلاقية والدّينية والنفسيّة، فقد عمّم البابا ليون الثالث عشر هذا العيد عام 1920 على كل الكنيسة، وذلك في بداية الثورة الصناعية، حيث راحت العائلات تتفكك عن بعضها، بسبب ظروف العمل، التي راحت تُبعد العائلات عن بعضها البعض، فكان مقصد الكنيسة حماية العائلة من المخاطر الجديدة.
ففي عيد اليوم، أي زيارة يسوع الرسميّة الأولى إلى الهيكل، كما تطلب الشريعة، من كلِّ من بلغ سنَّ الثانية عشرة، أن يزور الهيكل رسميّاً، ليشكر الله مع باقي الشعب في ذكرى تحريره من يد فرعون، دروسٌ وعِبَرٌ كثيرة لعائلاتنا اليوم.
زيارة البالغين المُتعبة إلى مدينة أورشليم، نقدر أن نقول، كانت بداية الحج القديم، التي تأسس عليها حجُّنا الجديد، المُرتّب والمريح اليوم، إلى الأماكن المُقدّسة. فها لوقا، يذكر مراراً، أن وُجهة سفر يسوع، كانت أورشليم. لذا فأهل السامرة لم يقبلوه "لأنّ وجهه كان مُتّجهاً نحو أورشليم" (لو 53.9). أليس حقّاً أن نقول: الكنيسة يجب أن تكون وُجهتَنا ومكان لقائنا المُحبّذ. لكن هيهات! أين هي وجهتنا؟ أين هو مكان لقاء الأولاد عامّة والشبيبة خاصّة؟ أما عادت هي الملاعب الرّياضيّة ومسارح الرّقص في آخر الأسبوع؟ المُلامون في الدّرجة الأولى، هم ليسوا الأولاد، لكن الأهل، الّذين ما اهتمّوا ولا اعتنوا بتربيتهم الدّينية. فكما الأهل، كذلك الأولاد، في هذا المجال.
وبعد هذه الزيارة، حدث ما سمعناه، أن يسوع، بقي وحدهَ في الهيكل، دون عِلم والديه، لأنه ما عاد مُلزَماً أن بسير معهما جنباً إلى جنب، بل مع زملائه وأبناءِ جيله. وأما في المساء فتجتمع العائلات من جديد مع بعضها البعض. لكن يا للعجب، كلُّ شابٍ أو شابّةٍ التقى بأهله، إلا يسوع، ما كان له أثر. فيا للوهلة! أظنّ أن شعورهما ما اختلف عن شعورِ أهلٍ اليوم، بعد حادث اختطاف أحد أبنائهم مثلا، فهو أمرٌ مُفجِعٌ ومُقلِق في نفس الوقت، لا يفيه أيُّ وصفٍ حقّه. فهل ذا حقيقةٌ أم حُلُم؟ "هوذا أبوك وأنا كنّا نطلبكَ مُعذّبَيْن" (لو 48:2). بالاختصار، حدث ما حدث، وعادت المياه إلى مجاريها. قصّة مِن واقع الحياة، وفيها الدّروس والعِبَر، ولأنّها حدثت مع العائلة المقدّسة، عائلة يسوع مع والديه مريم ويوسف، تقدّمها الكنيسة كعائلة مثالية لعائلاتنا ، هي الّتي، رغم ما مرَّ عليها من مصائب وصعوبات، عاشت ثلاثين سنة، متلاحمة متماسكة في بيت صغير في النّاصرة. فالقليل المذكور في الأناجيل عن هذه العائلة، هو كافٍ ليشرح للعائلات، أساس الصّفات، التي تُبني عليها حياةُ العائلة، كي تُصبِح مِثاليّة ، قلباً وقالِباً. أوّلها العيشة المشتركة تحت سقف واحد، بلا أنانيّة، الحقوق والاحترام والواجبات متساوية في الحياة والعلاقة اليومية.
على طلب من الكنيسة أعلنت هيأة الأمم منذ عام 2004 الاحتفال عالميا وسنويَاً بسنة العائلة: هذا وقد احتفظت الكنيسة بالحق، لاختيار الشعار السنوي. أول شعار كان عام 2004 هو: البشر يحتاجون العائلة، والأولاد يحتاجون الكنيسة. وشعار هذه السنة 2021 هو عنوان رسابة البابا فرنسيس في منشوره عن العائلة، قبل خمس سنوات، وهو: فرح الحب في العائلة. إنَّ العائلة هي أول مؤسّسة بشرية، انعرفت على وحه الأرض، وهي مؤسّسة إلهية. وهذا يعني، أن نجاح هذه المؤسّسة قائم في صُلبها، إذ يد الله فيها. عمرُها إذن عمرُ البشريّة، وأهدافها تصفها التوراة باختصار على أوّل صفحاتها، مفادها: شريك حياة جنباً إلى جنب، وذلك للمُعاونة المُتبادَلة. أمّا الغاية فهي إنجاب البنين، لديمومة الخليقة البشرية، المربوط بها واجب التربية. الطفل يتلقّى التربية الحقيقية لا في روضة الأطفال ولا في المدرسة، لكن على حضن أمه، فهي كالحليب الذي يرضُعه من ثدييها. متى تبدأ تربية الطّفل؟ سُؤِل نابليون مرّةً، فأجاب: تربية الطفل تبدأ عشرون عاما قبل مولِده، أي بتربية والديه. وهذا هو الصّحيح. إذ العائلة كالعش للعصفور، فيه يجد الحرارة والأمانة، فلا يتركه إلاّ وقد وصل درجة عالية من الثقة والاعتماد على نفسه بنفسه.
واسمحوا لي أن أُوضح هذا القول باللجوء إلى قول الباحث الألماني Vitus Drösscher في علم الحيوان، في إحدى محاضراته بعنوان: "العش الدافئ: كيف أن الحيوانات تَحُلُّ مشاكل التربية في العائلة". فهو يقارن ،بين لطافة الحيوانات وشراستها، مع لطافة الأولاد وشراستهم، ويوعز ذلك للسبب التالي: أول ستين دقيقة من ولادة الحيوان أو الولد تُقرَّرُ لطافتُهم أو شراستُهم، عن طريق ملامستهم لجسم الأم، الذي يُنتج فقط في هذه الساعة هورمون تخدير، يسمّيه العالِم، يتغلغل في جسم الطفل أو الحيوان، ويُقرِّر له طبيعة فرحه أو شراستِها. ويتابع المحاضر: إن الأولاد، الّذين يوضعون حالا في صناديق العناية الخاصة، بدون ملامسة أو الاتصال مع اُمَّهاتهم في أوّل ساعة من حياتهم، يبقون ميّالين إلى العنف، على جميع أنواعه. أعتقد أنّ هذي هي الحقيقة. إذ لا بديل لمحبة الأهل وحنانهم منذ البداية. فكل إنسان يحتاج إلى المحبّة، ليصبح إنسانا. وإن الطّفل الذي يغمره أهله بالمحبّة، ينضج ويتطوّر، بمرونة وسهولة، أسرع من ولد محروم منها. أمّا الولد الذي ينقصه الحنان البيتي والأمان، فينقصه الكثير، ولا يمكن أن يعيش سعيداً. أمّا أتعس تربية، فهي تلك الّتي تتمُّ، بدون مشاركة الأهل، كما كانت الحال أثناء الشيوعية، فكانت الحكومة ومؤسّساتها التّربويّة، هي التي تتولّى مهمّة تربية الأولاد منذ ولادتهم، وذلك لكي يبقى الأهل في وظائفهم، ولا تتأثر المصانع بإنتاجها، وثانيا لتوجيه الأجيال، إلى محبة الحزب وسياسته منذ صغرهم. أما تربية الأخلاق والدّيانة، فما كان لها، لا ذكرٌ ولا مكان.
فمُؤسّسةُ العائلة هي هديّة كبيرة من الله لنا، إذ لا تحلو لنا الحياة، إلاّ مع وفي عائلة. وإنّه لا يوجد مكان على الأرض، فيه تتفتّح شخصيّة الطفل وتتكيّف، مثلُ في حضن العائلة. يدور الميول والمُؤهّلات الاجتماعية ، مثل المحبّة والتّسامح والسلام والمشاركة في الحياة والمقاسمة واحترام الحق، تبدأ في العائلة. حتى يسوع في الناصرة "كان خاضعا لهما" (لو51.2). وكما قال البابا القديس يوحنا بولس الثاني أيضا، في مرسوم عن العائلة عام 1984 "العائلة ، هي وتبقى المدرسة الأولى للعلاقات الاجتماعية". إنَّ حياةَ الأهل هي مرآة للطفل، هم مثالُه الأوّل في سن الطّفولة. وبهذا الصّدد، إليكم هذه القصة: لمّا خرج الرّجل وزوجته من ملجأ العجزة، حيث كان الجدُّ يقيم منذ وفاة زوجته، قال الزوج لزوجته، وابنهما الصغير ماسكا بيديهما: هذا الواجب انتهينا منه، فلا يظنّن والِدُكِ أننا سنزوره كل آخر أسبوع، إذ نريد أيضا استغلال وقتنا لأشغالِنا وحياتِنا! فلم تُجبه زوجته بكلمة. لكن حينما رأى ابنهُما البالغ من العمر خمس سنوات السيارة، قال: والآن تأخذاني إلى ملعب الأطفال لألتقي بأصحابي. هكذا وكانت فرحته لا توصف حينما راح يُلملِمُ الرمال، حتّى جعل منها قُبَّةً عالية، فاقتربت منه أمُّه وقالت: ما أجمل هذا البرج! فأجاب: هذا ليس بُرجا! إذن ماذا؟ تابعت الأم. قال: هذا ملجأ عجزة، بَنَيْتُه لكما. فحينما أكبر ستسكنان فيه. لكنّني لن أستطيع أن أزوركما كلَّ آخر أسبوع! فنظر الزّوج بوجه زوجتِه مُندهِشَيْن ممّا سمِعا. نعم الأهل هم مرأة لطفلهما، وهو كالمسجّل، يلتقط كلَّ ما يسمع منهما ويحتفظ به في رأسه كفي جهاز تسجيل، ويقوله في أوانه! دار سؤال في جميع أنحاء العالم حول: من هو أحسن مربي للطفل؟ فكان الجواب تقريبا واحدا أيضا في جميع أنحاء العالم، وهو الأهل. فتربية الطفل هي مبدئيّاً تربية الّذات للأهل. فإنِ كان الأهل قد نشأوا وتلقّوا تربية صالحة، فما عليهم إلاّ إظهارَ هذه التربية بمَثَلهم، وتصرُّفِهم قدّام أبنائهم، فيكون النّجاحُ حليفَهم. وهنا صدق عِلمُ النّفسِ الّذي يقول: التربية ليستْ مبادئ نظريّة، لكن عمليّة.
فمن يدخل في حديث مع الأطفال، كثيرا ما يتعجّب من أجوبتهم، التي كثيرا ما يتردد فيها: بابا يقول كذا، ماما تقول كذا....هذا ولا ننسى دور الأهل المُهم، للتربية الدّينية، وذلك أيضاً بمثلهم، وطريقةِ مُمارستِهم للشعائر الدّينيّة، إذ هم أوّل المبشّرين. فالديانة هي سند العائلة "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فأنا بينهم" (متى 20.18). وهنا نقول: إنّه لا بديل عنهم، إذ هم الكِتابُ العَمَلي لا العِلمي، لغرس الدّين في نفس الطفل. عُلَماءُ النّفس يقولون: في السنة الأولى والثانية نلاحظ موقف الأطفال الهادئ، حينما يبدؤون يسمعون صلاة معيّنة أو ترنيمة تتكرّر على مسامعهم، فهم يحفظونها بسهولة ويبدؤون بتمتمتها عندما يبدأ احد قدامهم بتلاوتها، خاصّة إذا كانت قصيرة وفي أوقات ثابتة، قبل النوم مثلا أو قبل تناول الطعام. فتَبني هذه اللحظة أوّل علاقة مع الله. ومنذ السنة الثالثة، هم يُظهرون تفاعُلا عجيبا، عندما يسمعون قصصا، وأيضا الدينية منها، فيُصغون لها بانتباه عجيب. إذ الأولاد من طبيعتهم متديّنين، وما على الأهل إلاّ تنمية َهذا الشعور، وتوجيهَه وتقويتَه في أولادهم.
البشر يحتاجون العائلة. الأطفال يحتاجون الأهل. إذن لا بديل عن العائلة. إذا كنّا نُريد عالَماً مِثاليّاً، يجب حمايةُ العائلة من كلِّ التّيارات الحديثة التي راحت تُعزِّز وتُمارِسُ أنواع أُخرى، بديلة للعائلة، كالطلاق، أو الزواج المُؤقت، الّذي رفضه البابا يوحنا بولس الثاني، بكلمته المشهورة: لا يوجد زواج مؤقّت، او زواج المثليّين، الذي أصبح شعبيّاً، مع المطالبة ببركته والاعتراف به، كمؤسّسة زواجيّة رسميّة، بكامل حقوقها وواجباتها، كالعائلة التي أسّسها الله في الجنة. فهذا كلُّه مستحيل. العائلة، قال الله عنها: علاقة رجل بأُنثى، لذلك يترك الرّجل أباه وأمّه ويلزم امرأتَه. كل التّجارب الجديدة، لم تكن في البدء هكذا، حتّى وإن سمح موسى بممارسة الطّلاق، فهو رضخ لمطالب الشعب، لأجل قساوة قلوبهم. وأمّا يسوع فأعاد النّصاب إلى موضعه: لا طلاقُ ولا بديلُ لما أسّسه في الجنّة. عيد العائلة المقدّسة اليوم، يعطينا الصّورة الحقيقيّة، لما هي العائلة وما هي مُقوِّماتُها الأساسية، وهي كالمِرْآة لعائلاتنا. إنِ اقتدَتْ بها، صارت عائلاتنا كلُّها عائلاتٍ مُقدّسة.