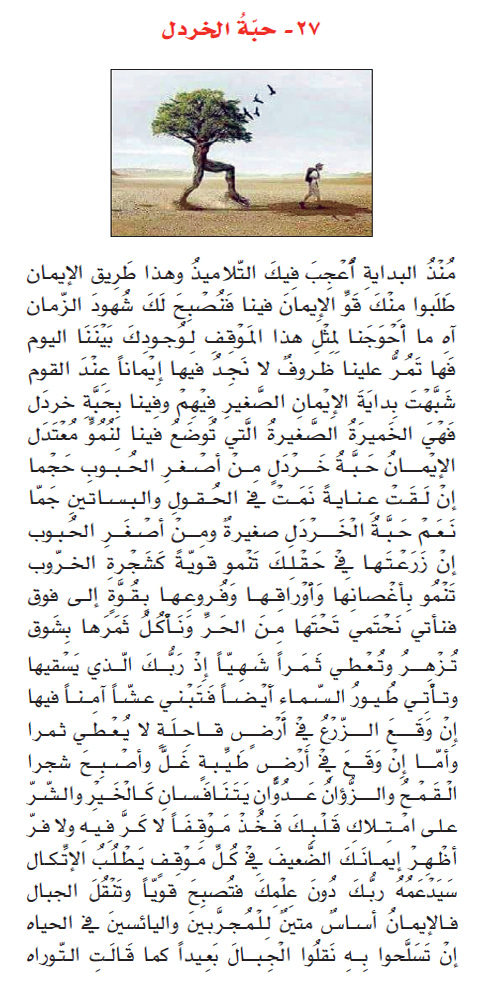موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
أجعلكما صيادي بشر

الأب منويل بدر - الأردن
الأحد الثالث (الإنجيل مر 1: 14-20)
مهنة الصّيد على أيام يسوع في فلسطين، كانت من اختصاصيات طبقة الشعب العالية والأغنياء، بين الرّومان، مستعمريِّ البلاد في ذلك الزّمان. وممارستُها كانت كأنها ممارسة الرّياضة البدنية اليوم. هذا ولا ننسى أن امتلاك مُعِدّات الصيد لم تكن متوفِّرة إلاّ عند هذه الطبقة من النّاس، مثل امتلاك قارب وشباك صيد. أمّا عند الفلاحين إجمالا وعامة الشعب خاصة، فما كانت هذه المهنة معروفة. بينما صيد السّمك، فكان مُنتشرا، يعرفه الصّغير والكبير وما كانت ممارسته ممنوعة، سواء كمهنةٍ تجاريّةٍ عامة، أو كهواية خاصة، والعيش منها. صيد السمك يحتاج وقتاً، والنّاس إجمالا كان لديهم الوقت، إذ ما كانوا مرتبطين بوظائف وأشغال مُلزِمة مثلنا اليوم, لذا فهم كانوا يمضون وقتهم مع بعض، يراقبون أشغال بعضهم البعض، ويتعلّمون مهنة الآخرين، لا بزيارة دورات عملية مثلنا اليوم، وإنّما بمخالطة أصحاب المهن المعروفة، وكانت أكثرها مهنة الفلاحة ورعاية المواشي واصطياد السمك.
الإنجيل يذكر لنا أن يسوع عاش طفولته في بيت المدعو يوسف، مربّي طفولته، وخطّيب والدته مريم. يوسف كان نجّارا معروفا في الناصرة، فتعلّم منه يسوع هذه المهنة النادرة الراقية، أي مهنة النّجارة، دون أن يجهل وظيفة اصطياد السمك، وإلا لما قال للتلاميذ الأولين، وكانوا كلهم صيادي أسماك، تعالوا اتبعوني وسأجعل منكم صيادي بشر. وهذه وظيفة أرقى. أمّا بقوله صيادي بشر، فهو ما عنى نُخبة معيّنة من سكان ضواحي الجليل والنّاصرة، بل من كلّ البشر، الّذين أتى ليبشرهم هو، وهم جميع البشر، المرضى والمقعدين والجياع والحزانى قبل غيرهم، إذ هوقال: إني لمثل هؤلاء أتيت، إذ الأصحّاء لا يحتاجون إلى طبيب.
وعندما راح يُبشِّر، ويُقدِّمُ رسالته للنّاس، بأمثال بسيطة، ما كان يأخذ الأصحاء والأغنياء والعلماء، الممثِّلين الرّئيسيِّين لتعليمه، لكن البسطاء كانوا نموذجا لقصصه وامثاله. من هنا جاءت أمثال الصيد والصّيادين مرارا على لسانه.
متى ومرقس ولوقا، ثلاثتهم يذكرون دعوة أول الرّسل، ومنهم أندراوس وشقيقه الأكبر بطرس، المعروفين على شواطئ بحيرة طبريّا، كصيّادي أسماك، بالكلمة البسيطة: تعالوا اتبعوني وسأجعل منكم صيادي بشر. وكباقي الشعب وجدت هذه الكلمات استحسانا عندهم، لأنّ السّمك كان للشعب، الحيوانَ المبارَكَ الوحيد، الّذي ما أفناه الطّوفان، فما كان خِزياً، نَعتُهما بصيادي سمك، يل هم شعروا بأنفُسِهم محظوظين، أن يكونوا صيّادي سمك في مستنقع الله.
هذا وقد صارت كلمة سمكة أو بالجمع سمك، منفذ نجاة للمسيحيين الأوّلين، تحت وابل الإضطهادات التي قامت عليهم، وكلّفتهم آلاف الشهداء. فمن كان يعترف بمسيحيّته، كان ينال جُلَّ العذاب، الّذي نقرأ عنه: من قطع الرأس إلى صب الزيت الحارق أو تغريق الشخص في برميل يغلي، إلى الرمي في النار، كما في كتاب النبي دانسال، إلى قطع الأعضاء أوّلاً بأوّل، حتى يتم النّزيف. هذا ولا ننسى الرمي مكبّلين، قدام الحيوانات الجائعة المفترسة. فكان محظوظا كلُّ ئمسيحي لم يُكتَشف أمرُه، أو لم يُسأل عن هُوِيّتهِ. لكن إلى متى، سيبقون عائشين تحت هذه الضغوط، وفي الخفاء؟ لذا فكما يذكر التاريخ، وانطلاقا من كلمات يسوع، بأنّ التلاميذ هم صيادو بشر، أنّهم إتفقوا أن يأخذوا هذا اللقب، كشعارٍ سرّيٍّ لهم، وتفنّنوا بنحت وتقديم رموز السمك في الحياة العامة. بل وجدوا أنفسهم مضطرّين، كي يتعرّفوا على بعضهم البعض، أنهم أخذوا أوّل أحرف من كلمات يونانية وركّبوها ببعضها حتى صارت تدل بما معناه: أتباع يسوع ابن الله المخلِّص: IKTUS فصارت هذه الكلمة لهم كجنسية خاصة. فإن
ΙΗΣΟΥΣ – Iēsoûs (neugriechisch Ιησούς Iisoús) „Jesus“
ΧΡΙΣΤΟΣ – Christós „der Gesalbte“
ΘΕΟΥ – Theoû (neugriechisch Θεού Theoú) „Gottes“
ΥΙΟΣ – Hyiós (neugriechisch Υιός Yiós) „Sohn“
ΣΩΤΗΡ – Sōtér (neugriechisch Σωτήρας Sotíras) „Retter“/„Erlöser“
عرّفوا على بعضهم كانوا يحتاجون فقط للفظ الكلمة (إختوس)، ومن جهة ثانية كانت هذه الكلمات أو الجملة فعل إيمانهم القصير: يسوع ابنُ الله المخلِّص. فجرت العادة، خاصة في القرنين السابع والثامن عشر، أن تُبنى للمُبشّرين منابر، نجد أكثرها إلى اليوم في كنائس لا تُعد ولا تُحصى، وقد عرفت هذه المنابر اعتبارا خاصا من الفنّانين، الّذين أبدعوا في تخطيطها وتوجيهها، أن يُدعى البابا ومعاونوه الأساقفة والكهنة، صّيادين، بينما الشعب الّذي يسمعهم، والذي يحرِّك رؤوسه من تجت المنبر، كالسمك المتنقل في الماء، السّمك. فكما أنَّ السّمك لا يعيش إلا في الماء، كذلك المسيحي لا يُعدُّ مسيحيا، إلاّ إذا أمضى حياته في إطار تعليم يسوع والتّجوّل في محتواه.
لكن هنا السّؤال، وهذا هو ما فكّر به يسوع أيضا، حينما افتكر في تأسيس الكنيسة، فابتدأ طبعا بدعوة أول الرسل، وجعل منهم صيادي بشر، بلغة اليوم نقول: اختار مُعاونيه لدفع عجلة التبشير، بعدما يُدرِّبهم عليها ويضع لهم رؤوس النّقاط الدّائمة والمُتكرِّرة، إلى أن يسمع بها كل مولود بشر. الله بغنى عن عمل يد الإنسان، لكنّه يُريد أن يتعرّف البشر عليه، ليس فقط عن طريق العجائب: كن فيكون. لكن هو نفسه جعل من خليقته الإنسان، معاونا له. هو وكّله حماية الأرض: وضعه في جنّة عدن ليعملها ويحفظها" (تكو 2: 15). الله خلق العمل ولكن على الإنسان أن يقوم به. كمن يريد أن يبني بيتا، فهو يُجمِّع ما يحتاج إليه من مواد البناء: حديد، إسمنت، حجارة، ماء.... لكنه يحتاج إلى من يقوم بالبناء، وهذا يحتاج إلى عدّة عمال. من هنا فكرة يسوع منذ البداية، أن يبدأ بتجميع عمال حوله. وكما نعرف أنه منذ كان معهم قد نبّههم: “إن العمل كثير لكن العمّال قليلون"(متى 9: 37).
نعم منذ البداية، أفهمهم يسوع أفكاَره: هو جاء ليؤسس ملكوت الله على الأرض، وبما أنّ انضمام البشر إلى هذا الملكوت هو الأساس، فهو بحاجة لعمل البشر وسواعدِهم فيه. هو بحاجة لربطهم وإشراكِهِم معه في العمل. فبواسطة يسوع، دخل الله في عالمنا. وهذا يعني أن زمانا جديدا قد دخل معه، لذا قال: لقد حان الوقت واقترب ملكوت الله (مر 1: 15). ويدعو البشر إلى الإشتراك ببناء وتحقيق هذا الملكوت.
يسوع، تقول الإحصائيات، هو ليس فقط، شخصية بارزة، بين شخصيات العالم، بل هو أبرز شخصية معروفة في كل تاريخ العالم. هو لا يُقارن بشخصية أخرى تنافسه، كما الحال مثلا في مجال السياسة أو رجل أعمال، حيث يهتم العالم سنويا باختار أعظم شخصية العام. فكل سنة نلتقي بوجهٍ جديد، كما الحال مثلا مَن يحوز، بل من يستحق أن يحوز بجائزة السّلام السّنوية. الشخصياتٌ من كل المجالات، تتغيّر وتتبدّل على مسرح العالم سنويّاً، وأمّا شخصية العالم الثابتة، فهي المُسمّى يسوع ابنُ الله، الّذي لا مثيل له، بكل ما قال وعَمِل. إذ كلَّ ما قال وعمل، هو للعالم كله، وليس كالشخصيات التي تمرُّ على أرضنا، فهي معروفة فقط، إما لمنطقة معيّنة أو لجيل معيّن، او في حقل خاص، وأما يسوع فمعروف عند الكل، في كلِّ منطقة وفي كل حقل. يكفي أن الكنيسة هي مِن تفكيره: إن ملكوت الله قريب (مر 1: 14) وهي منتشرة في كل العالم. مُهمَّتُها، أنّها عرَّفت وتُعرِّف وستُعرِّف عليه في كلِّ أنحاء العالم. وهكذا صارت أكبر مُجمّعٍ دينيٍّ حتى اليوم، عِلما بأنها ابتدأت، كما سمّاها هو، كحبّة خردل، وهي أصغر الحبوب كلِّها، ولكن مَتى زُرِعت، تطلع وتصيرُ أكبر جميع البقول، وتصنع أغصاناً كثيرة، حتى تستطيع طيور السّماء أنْ تتأوّى تحت ظلِّها"(مر 4: 31).
فكيف حدث ذلك؟ ذلك حدث كما سمعنا بكلمة يسوع: لمّا تمَّ ىالزمان، للبداية بمشروعه الخلاصي على الأرض، خرج في رحلة عمل على شاطئ بحرية طبريا، يُفتِّش عن معاونين. هذا المثل سيستعمله مرارا في كرازته: خرج الزارع ليزرع... خرج رب عمل يُفتِّش عن عمال لكرمه. إذن في ذات صباح خرج يسوع، وفي باله ما في باله، و التقي مع شابَّيْن، منهمكين بصيد السمك، هما بطرس وأخاه أندراوس(أندراوس تعني شجاع)، وبدون سابق معرفة، أقلَّه من طرفِهما، يدعوهما: تعالا واتبعاني، وسأجعلُكُما صيادَيِّ بشر. فبدون سؤالٍ ولا جواب، تركا شباكهما بل وقارب الصيد، الذي كان مصدر رِزقهِما، وانضمّا إليه حالا، دون علمٍ أو معرفة سابقة لمستقبلهما، بل بالأحرى بدون معرفه لهذا الغريب، الّذي كلّمهما ووعدهما بعمل مُهم. هذا وليس بعيدا من هناك، كان أيضا ألأخَوان، يعقوب ويوحنا، مع أبيهما زبدى، منهمكَين أيضاً باصطياد السمك، وبنفس الأسلوب دعاهما، فتركا أباهما وعمّاله وتبعاه.
أما يقول المثل: الحب من أول نظرة؟ هذا هو يسوع. من رآه إلاّ ينجذب لمرآه. من سمعه إلاّ يتجاوب لحديثه. من ناده إلا ويتبعه. هؤلاء التلاميذ، فَتَنَهُم بصوته، قبل أن يجلسوا معه. نعم شعروا في قعر أنفسهم: إنه لشرف كبير، ترك كل شيء وأتّباعه، وإهداءه كلَّ الثِّقة. وهكذا تبعوه، وشعروا أنهم أحسنوا القرار والإختيار. فيسوع ما اكتفى بالوعظ أمامهم، عن سماءٍ جديدٍ وأرضٍ جديدة، بل أراهم عجائب، بشَّرْتهم، كيف سيكون السّماءُ الجديد والأرضُ الجديدة. فيهما سيحدث الكثير الجديد: العمي يبصرون والصم ينطقون والعرج يمشون والصمُّ يسمعون والمساكين يُبشّرون. وطوبى لمن لا يشك بهذا.
ممّا لا شكّ فيه أن السّماء الجديدة والأرض الجديدة، هما أيضا عالمنا نحن، وليس فقط عالم التّلاميذ الأوائل، فالعالم الذي دخله يسوع ومشى عليه بأقدامه المقدّسة، هو نفسه، الذي نعيش فيه نحن اليوم، إذ نحن هم خُلفاء التلاميذ، الّذين دعاهم، وأعطاهم كل سلطان في أن يبشروا ويجعلوا من كل أبناء العالم تلاميذا له. فعمل التبشير هو العمل الرئيسي في الكنيسة، الذي لا ينتهي، ما دام هناك إنسانٌ واحدٌ، لم يسمع بالمسيح أو لم يعرفه بعد. والمبشّرون هم المؤمنون، جيلا بعد جيل.
في نهاية السنة المقدّسة عام 1975 أصدر البابا بولس السادس منشورا بابويا بعنوان: التبشير بالإنجيل. يحمل عادة المنشور البابوي عنوانه من أول كلمة المنشور. قال البابا: إن التبشير بالإنجيل هو بالنسبة للكنيسة، موضوع عمل على برنامجها، لا تقوم به فقط على فضاوتها، بل هو واجبها الأساسي، موكَلٌ لها من قِبَلِ مؤسسها يسوع، حتى يصل البشر إلى الإيمان والخلاص(يند 5). وإنه لَخطأٌ، الإعتقاد أن المُبشِّر هو فقط، مَن درس اللاهوت وتعمّق فيه، أو الكاهن الذي تلقّى دراسة خاصة في التوراة، بحسب الإعتقاد السّاذج القديم، أنّ المبشِّر هو فقط رجل الله، الذي تُكلِّفُه الكنيسة رسميّا بمُهمَّةِ التبشير عن المنبر. بل المبشّرُ هو كلُّ مسيحي، مُعمَّد ومُثبَّت، هو مبشِّرٌ حقيقي في مُجيطه العائش فيه وعلى مقدرته. كما تخبر القصّة مع القديس فرنسيس الأسيزي، أنه كلّما طاب له أن يبشّر، كان يأخذ زميلا معه قائلا: لنذهب إلى السّوق ونبشّر. خرجا يوماً وراحا يتجولان في الأسواق المحتشدة ويُصَلٍّيان. هذا وكان المرافق يفتكر أن فرنسيس سيصعد على منصة ويلقي درسا دينيا. لكن فجأة إذا بهما يقفان باب الدير من جديد دون أن ينطق فرنسيس بكلمة تبشير واحدة. فاستغرب المرافق وسأل: لكن يا أخي فرنسيس، متى تُلقي وعظة التبشير؟ فابتسم فرنسيس وقال: التبشير ليس كلاما فقط بل وقبل كلِّ شيء هو مثل. هو الشهادة الحية في الحياة، كما ورد في إنجيل متّى فصل 25. كلّما فعلتموه وقلتموه... إذن للتّبشير وجوه عديدة. منها أيضا الصّلاة.
أساس التبشير واضح: بشّروهم وعلِّموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، علما وعملاً. فهذا يعني أن نتبعه على أقدامنا: "اتبعاني أجعلكما صيادي بشر". وطبعاً بداية التبشير، هي المناداة بتغيير الإتّجاه: توبوا! فقد اقترب ملكوت الله. فلا بدّ أن نسعى لتوسيع ملكوت الله على الأرض، كلٌّ بدوره وزمانه. فكلمات يسوع حيّة دائما، ومن يسمعها، لا يسعه أن يبقى جالسا وغير مكترث، بل يهبُّ للعمل فيها. فهذا هو معنى الحياة. من يسمع كلمات بولس: الويل لي إن لم أُبشِّر، ولا يسعى هو أيضا بطريقة وأُخرى لعمل الخير من أجل تحسين وانتشار وتوسيع ملكوت الله على هذه الأرض. نحن نصلِّي: ليأتِ ملكوتُك. لكن هذا لن يأتي بدون مشاركتي الفعليّة. نعم التبشير ليس بالهيّن. حتى الأنبياء الّذين اختارهم الله لإنذار شعبهم، حاولوا التّملّص من هذه المُهمّة الثقيلة. فها إرميا يحاول التّملّص معتذرا: "آه يا سيّد! إنّي لا أعرف أن أتكلّم لأني ولد" (إرم 1: 6) وعاموس (1: 8) حاول أيضا التّملًص، إلاّ أن الله شجعهم وأمرهم للنتيجة التي تأتي لا بالصمت لكن بالإنذار. وماذا نقول عن يوناس، أليس هذا أيضا إنذار لنا، أنه في كثير من المواقف، الأفضل هو ليس الصّمت وإنّما الإنتقاد البنّاء، فهذا يأتي بنتيجة أفضل. الشجاعة هي علامة المسيحي. من اعترف بي قدام الناس، أعترف أنا به قدام أبي الذي في السّموات. عِلماً بأنه ليس من يعترف بالحقيقة، ينال إعجاب وتصفيق السّامعين. لكن المسيحي لا يشهد للإيمان لينال الإعجاب والتّصفيق، ولكن ليعلّم الحقيقة. كما فعل بولس قدام أهل كورنتس فضحكوا منه ومن تبشيره. وقالوا مستهزئين: سنسمعك مرة أُخرى. فالمبشر يبشّر، لا لينال مكافأةً مِن السّامعين، أو نيل جائزة مادية كالرّياضي، بل غالباً إكليل العذاب والإضطهاد والشهادة، كما حدث مع شهداء كثيرين. لقد أصبح صعبا جدّا التكلّم علناً عن وصايا الله وموانعها، عن الإيمان ومتطلَّباته.
أفكار العالم هي غير أفكار الدّين. لماذا نصدّق أنَّ مشاكل العالم لا حلول لها إلا بالحروب والأسلحة ، وأمّا الحلول التي قدّمها يسوع وتنادي بها الكنيسة لا تلاقي صدى؟ "إن قدّمت قربانك إلى المذبح وهناك تذكّرت أنَّ لأخيك شيئاً عليك، فاترك هناك قربانك واذهب أوّلا اصطلح مع أخيك. كن مراضِياً لخصمك ما دمت معه في الطّريق، لئلا يُسلمك إلى القاضي فتٌلقى في السجن" (متى 5: 22 وتابع). "أردد سيفك إلى غمده. لأن من بالسيف يأخُذ، بالسيف يُؤخذ (متى 26: 52). لماذا لا نريد أن نفهم أنّ الطّرق السلميّة هي وحدها الّتي تقود إلى السّلام؟ آمين.