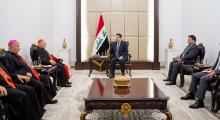موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر

كلما تقترب الأعياد يتساءل المسيحيون لماذا لا يحتفل بها في نفس المواعيد والتوقيتات. وينبري كثيرون يتحسرون على الأيام الخوالي حين كنا واحدًا، وتأتي التعليقات والتنديد والنصائح وأحيانًا الاتهامات. لكن، هل الوحدة هي بالعودة إلى ما كنا عليه في القرن الخامس والسادس أو ما بعد ذلك؟ ألا ينبغي أن نبحث عن صيغة جديدة وملائمة للوحدة، فهي ليست وراءنا وإنما أمامنا. هذا ما أحاول تقديمه في هذه الصفحات...
يشكل الانقسام هاجسًا في كل المؤسسات والتنظيمات البشرية منذ فجر التاريخ، وحاول كل منها أن يتوقع ذلك، فوضعوا له معالجات منها يستبق ومنها يعالج. مع ذلك، قلما سلم أحدها من الانقسام، بل كان الفشل نصيب أغلبها عبر التاريخ، فدخل التشنج بين الأطراف، وجرحت الذاكرة، ولم يعد للوحدة أي جاذبية أو إغراء. وما أكثر الذين لجأوا إلى الأسهل عن طريق فرض الوحدة بالقوة، أو بتذويب شخصية الآخر ومسح ثقافته وتاريخه وخصوصياته اللغوية. بعضهم مارس القطيعة بمسح السبورة وكتابة شيء جديد، وعدّوا الزمان الأول، حين كانوا واحدا، هو الوحيد المهم، أما زمن التباعد فهو بلا قيمة، فتولدت الشعارات وتكرّرت الأمنيات والحنين إلى الماضي بانفعال واعتبرت الأزمنة الغابرة حين كنّا واحدًا أزمنة مثالية. وشيئًا فشيئًا ساد التغافل عن الأسباب التي قسّمتنا، فقامت لغة آيديولوجية "خشبية" وتسميات فضفاضة وفارغة ودخلت "السياسة" أو "المصالح الشخصية". لكن كل شيء كان يعوم في سلبية التشخيص ويبتعد عن الموضوعية في إعطاء الحلول، هذا إلى جانب التسرّع في توزيع الاتهامات والأحكام المسبقة بنفس الضعف السلبي الذي سار قبله عليه كل الذين حاولوا من قبل، وتمر السنوات والكل يراوح في مكانه.
ما جاء أعلاه إذن يصح مع كل المجتمعات البشرية، ويصح أيضا في الكنيسة، فهي أيضا مكوّنة من بشر، أي نحن أمام جسم حي، وكل حي يمرض ويشيخ ويموت. لا نستسهل إذن إمكانية علاجه وشفائه وخلاصه. الخبرة الطبية والدوائية علمتنا التواضع والاصغاء والاعتراف بأن ما وصلنا إليه حتى اليوم ليس كاملا، وأن معلوماتنا ناقصة وتشخيصنا جزئي، وذلك لافتقارنا إلى الوسائل حتى الآن. بهذا التواضع صار العلماء نماذج يتميّزون بها على رجال الدين والسياسة بأن يتعلموا ولا يتسرعوا في أحكامهم، فأخطاء الذين سبقوهم لا داعي أن يكرّروها، أما الأحكام المسبقة والقاطعة فليحمنا الرب منها لأنها لم تقدّم بل أخّرتنا، وقد يصاب بسببها جسم المجتمع والكنيسة بما هو أسوأ!
فكرة الجسم الحي قديمة، طبّقها القديس بولس على الكنيسة على مرحلتين، في الأولى عندما اعتبر أننا جميعُنا إخوة، أعضاء في جسم واحد: "أنتم جسد المسيح وكل واحد عضو فيه" (1قور12/27)، "إذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء، وإذا أكرم عضو سرّت معه سائر الأعضاء" (1قور12/26). لكن بولس يكتشف أن وحدة المسيحيين تختلف عن أي مجتمع آخر فحدث تغيير في فهمه لهذه الحقيقة، عاد إلى يوم اهتدائه على طريق دمشق عندما ناداه المسيح: "شاول، شاول لماذا تضطهدني؟"، أي تضطهد أعضاء جسدي. فأصبحت الوحدة المسيحية أكثر من مجرد كتلة اجتماعية متماسكة، الأعضاء هم للمسيح متّحدون به من الأحياء والأموات، ونراه يقول عندما يتألم هو نفسه يقول: "يسرّني الآن ما أعاني لأجلكم فأتمّ في جسدي ما نقُص من آلام المسيح في سبيل جسده الذي هو الكنيسة" (قور1/24).
من هذه الحقيقة تطوّر لاهوت خاص سمّي "شركة القديسين"، حيث الروح القدس هو الذي يقود الكنيسة وهو صحّتها وشبابها يشدّها نحو المستقبل، فلا تعود السنوات الماضية سوى قطرة في بحر غناها وقوّتها بعكس ما يحدث للأجسام من تقادم وضعف، فضيلة الرجاء بحدّ ذاتها معجزة تجعل الكنيسة تقاوم ولا تستسلم لعوادي الزمن، لأن المسيح معها إلى انقضاء العالم.
هكذا كان التلاميذ الأولون في بدايتهم تسود تصوّراتهم "أفكار البشر"، كانوا منقسمين، ضعفاء محبّين لأنفسهم "من هو الأكبر!" (لو 22/24)، وعلى مدى ثلاث سنوات رافقوا يسوع ولم يفهموا مشروع "الملكوت" الذي أراده، بحيث قبل صعوده إلى السماء واختفائه عن أنظارهم سألوه: "يا رب الآن ستعيد المُلكَ لإسرائيل؟" (أع 1/6) لم يفهموا معنى كرازته. سوف يأتي شاؤول (بولس) ليكون أحد الأسس المهمة لبناء مفهوم الكنيسة، وفي رسائله كمّ كبير من النصوص القاسية على الذين يقسّمون الكنيسة، فيقول هذا: "أنا مع بولس، أو أنا مع بطرس" (1 قور 1/12).
مع الحرية التي جاءت مع بيان ميلانو في عام 313 م على يد الامبراطور الروماني قسطنطين دخل أتباع المسيح في تحدّ أكبر من زمن الرسل بالانتشار الأفقي بين الحضارات والشعوب، فاختلط معنى الوحدة على الكثيرين، لكن أتباع يسوع رأوا أن الوحدة هي مع المسيح بجهاد شخصي وانتماء إلى المسيح يحميهم من خطر "روح العالم".
كلمة "الانتماء" إذن، تبقى هي المفتاح لفهم الوحدة المسيحية، فالانتماء يختلف عن الهوية الاجتماعية، التي فيها يخلطون الماضي وأحداثه، بمولدهم وتبعيّاتهم، وعشائرهم... الفرق كبير بين الهوية المقفلة والانتماء المفتوح، الذي من دونه لا يرتفع مستوى خطاب الوحدة عن المجاملات. الهوية عادة تبنى على "منجزات الماضي" التي ورثتها مع حليب أمي، أما الانتماء فيسألني منذ اليوم: ماذا فعلتَ بالوزنات التي تسلمتَها مع ذلك الحليب؟ كثرة الوزنات أو قِلّتها غير مهمة (متى 25/14-30) الخطر يكمن في دفنها في أوهام القومية والأمة والشعارات التي أتعبَتنا وأصبحت ثقلا على أولادنا لأنها "ألغاز" مقفلة بلا مفتاح ولا تفسير ولا تأوين أو شرح.
مسار الوحدة لدى يسوع هو انتماء جدّي يبدأ بإخراج الخشبة من عيني لكي أرى القذى في عين أخي (متى 7/5)، الخشبة قلما أفطن إليها، لأنها تدينُني، تدين نظرتي المعوَجّة والأحادية على الآخر: من هو؟ كيف أراه؟ من أي زاوية؟ ما هو مستقبله؟ هل أعرفه حقا وأعرف ماذا يريد الله لحياته؟ هل أنا حر من مفعول تلك الخشبة؟ لأنها تعني اكتفائي ورضايَ عن نفسي، وما أعتبره وأنتقيه من الماضي، فأغطي هنا وأمسح هناك، وأسلط النور على جزء أو أسترسل في مونولوج (أحكي مع حالي)، والآخر لا يعنيني بشيء...
كان يسوع يعرف خطر الانقسام هذا، لذلك (في كل الفصل 17 من إنجيل يوحنا) يصلي من أجل وحدة تلاميذه، حين لم يكونوا بعدُ كنيسة، بل مجرّد شلة صغيرة مبعثرة، حتى إن واحدا منهم سيخونه بعد قليل. صلى الرب من أجل البعيدين الذين سيتتلمذون على يد هؤلاء المساكين الواجمين أمامه، الذين سيهربون في ذلك المساء، وبطرس زعيمهم سينكره. لكن صلاة يسوع ستبقى علامة تضيء المستقبل، للوحدة في الانتماء نحو هدف أوسع من ضعفنا وخطايانا وماضينا. وحدتُنا في المسيح هي قبول للتطوّر والتغيير الممكن بالروح القدس، بمثابة ولادات متتالية، بدأت مع التغيير الذي حدث للتلاميذ الأوائل عندما انفصلوا عن اليهودية، ثم انقسموا إلى تيارات مختلفة، منها من عاش ومنها من انقرض، وخير دليل هو ما قاله أحد كبارهم، غملائيل أمام أعضاء المجلس عن الرسل حين عزموا على قتلهم مثل يسوع: "أتركوهم وشأنهم، لئلا تصيروا أعداء الله" (أع 5/17-39).
ما نراه من انقسامات في زماننا ليس سوى ظواهر طبيعية، بعض منها يبقى وبعض يقاوم ومنها ما سينقرض من نفسه، وآخر جديد سيظهر، كل هذا تِبعًا لجوّ الحرية التي تتمتع بها الشعوب، والضغوط التي تمارس عليهم وغير ذلك من عوامل تتجاوز تحليلنا. إنها مسيرة بيولوجية واجتماعية، كل جيل يقوم هو ابن الحياة، ومن حقه أن يكون مختلفًا، لماذا نريد أن نلبسه ونطعمه على مزاجنا؟ من يقول إننا الأفضل؟ لا يمكن أن نبقى على أفكارنا في قراءتنا لنصوصنا والتشبّه ببعضنا، فالتغيير ليس سيئًا إنما هو سُنَة الحياة، وهذا ما دعا إليه يسوع منذ بدء الإنجيل: "إن لم تتوبوا (أي "تغيّروا عقليتكم" ميتانويا باليونانية) تهلكوا جميعًا" (لو 13/5). أما الذي "آمن بي سيعمل الأعمال التي أعمَلها، بل أعظم منها" (يو 14/12). هناك إذن فرق بين الوحدة الظاهرية التي يراها البعض في العادات وشكل الأصوام والأعياد والطقوس، وبين عمق الانتماء إلى المسيح، الذي يدفعنا لنراجع الموروث ونفحصه ونصفّيه ونجدّده ونقلمه كالشجرة التي تصبح على يد الخبير مليئة بالثمار، "من ثمارهم تعرفونهم" (متى 7/16) إذن، وليس من شعاراتهم!
+ المطران يوسف توما،
رئيس اساقفة كركوك والسليمانية للكلدان