موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
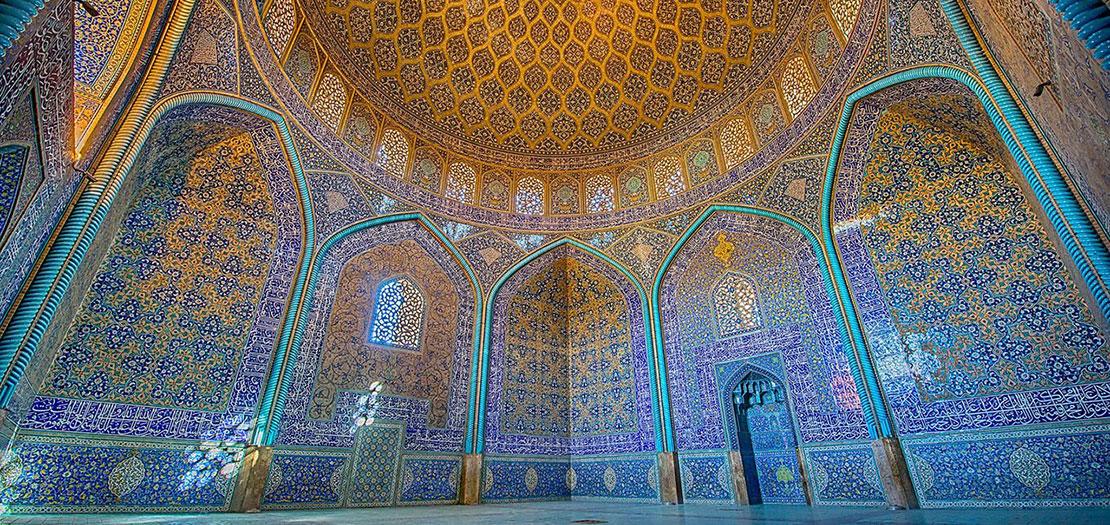
يُنسب إلى النبي محمد (عليه السلام) أنه قال عن وُلاة الأمر الظالمين: "إنما هم نقمة ينتقم الله بهم ممن يشاء؛ فلا تستقبلوا نقمة الله بالحَمِيَّة والغضب، واستقبِلوها بالاستكانة والتضرع” (كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف). أيضًا يُنسب إليه (عليه السلام) القول: "تَسمعُ وتطيع للأمير، وإنْ ضُرب ظهرُك وأُخذ مالُك" (صحيح مسلم).
غيْر مهم هنا، السؤال عن صحة نسبة هذه الأقوال إلى النبي، أو محاولة تأويلها بشكل يجعلها مقبولة لدينا اليوم. ما يهم هو كيف نتحرر اليوم من توظيف مثل هذه الأقوال التي ترسِّخ بُنيةً استبدادية باسم الدين، جاعلة الوعي الديني يتقبل صورة الإله المتحيز إلى الحاكم الجائر، ويتقبل إهدار كرامة الإنسان وإرادته. أتحدث هنا بالبُنية الاستبدادية بكل أبعادها، ليس السياسية فقط، بل الاجتماعية والفكرية أيضًا. ولربما تكون الأبعاد الفكرية هي أكثر أهمية، لكونها محفِّزة إلى الفعل.
لم يعد مُجْديًا الحديث في علاقات السببية في بُنية الاستبداد، أو البحث عن السبب الأول الذي نتج منه وضعنا الراهن، إذ من المهم هنا الوعي بأن الاستبداد صار ممارسة ذات أبعاد متعددة، تستقل عن القمع السياسي، ولا تَنتج منه بالضرورة. وأنا هنا أُحاجج ضد الطرح، الذي يرى أن مجرد إزاحة الحاكم المستبد وتغييره سوف ينهي مشكلة الاستبداد، ويأتي بِبُنية أخرى قائمة على الحرية والاستقلال. فالحاكم المستبد هو مجرد تَمظهُر، أو بُعد من أبعاد الاستبداد.
يعلِّمنا التاريخ أن تغيُّر البُنى السياسية والاجتماعية والفكرية سَيْرُورة متشعبة، تتحكم فيها عوامل كثيرة عصيَّة على الرصد. من المهم هنا، أن نسأل عن دور فهم الدين في تشكل بُنية مستبدة، أو أخرى يمكن أن نسميها “تحريرية”. وقبل الخوض في هذا التحليل لا بد من أن نكون على وعي، بأن الدين أيضًا مجرد عامل في معادلة شديدة التعقيد. فتغيير الفكر لا يكون بمجرد تغيير فهم الدين؛ إذ إن هذا الفهم ذاته هو أيضًا نتاج للفكر.
من أين سننطلق حين الحديث في دور الدين في تحرر الإنسان؟ عادة ما يجري التركيز على الفقه باعتباره مجال تحرُّكِ خطاب التجديد، غير أن قضية مركزية عن تحرر الإنسان، تستدعي الانطلاق من أسئلة وجودية عن دور الإنسان في هذا الكون. وأنطلق في عرضي من رؤية إيمانية تؤمن بأن الله هو مَن خلق الإنسان.
فما علاقة الله بالإنسان؟
يستطيع المسلم -كما المسيحي- أن يصف الله بصفات معينة، لأن الله أفصح فيها عن نفسه بتجلِّيه للإنسان. تؤمن المسيحية بتجلي الله من خلال المسيح عيسى (عليه السلام)، أما الإسلام فيؤمن بتجلي الله من خلال الوحي القرآني. تعني فكرة التجلي الإلهي أن الله أراد أن يعرِّف عن نفسه بطريقة يستطيع فيها الإنسان أن يستوعبها. إذن، فالتجلي الإلهي يستخدم البعد الإنساني التاريخي، كي يكون مدرَكًا من جهة الإنسان. لكن، لماذا أراد الله أن يُعرَف من طرف الإنسان؟ أَلِأَنَّ الله ينقصه شيء، ويريد أن يكمله من خلال عملية الخلق؟ إن كان الجواب بالإيجاب، فنحن نقف أمام معضلة دينية وفلسفية في الوقت ذاته. هي دينية، لأن الإسلام كما المسيحية ينظران إلى الله على اعتبار أنه كامل في ذاته مستغنٍ عن غيره، فحاشاه أن يوصف بعدم الكمال. وهي فلسفية، لأن العقل حين يتحدث بالله، فهو يتحدث بالمطلق الذي لا يمكن للنسبي (الإنسان) أن يحتويه، في حين يمكن للنسبي أن يقاربه ويحاول فهمه، دون أن يستطيع إدراكه في كماله المطلق.
لذلك، يبقى المطلق دومًا أكبر من قدرتنا على الوصف. فالإله الذي هو دائمًا "أكبر"، لا يحتاج إلى خلق الإنسان أو لعبادته له كي يكتمل. إذن، لنعد لسؤالنا عن سبب خلق الإنسان. لقد أجاب القرآن عن هذا السؤال بوضوح: {الرحمن، علَّم القرآنَ، خَلَق الإنسانَ} [الرحمن: 1-3]. إذن، رحمة الله بوصفها صفةَ ذاتِ لله، هي التي تعبِّر عن إرادة الله الأزلية لهذا الإنسان، أي أن الله يريد الإنسان، وأنه ما زال مريدًا له لذاته، لا لهدف آخر. وهذا هو مفهوم المحبة؛ فهي تعبير عن إرادة الآخر بلا شروط. لذلك، حدد القرآن علاقة الله بالإنسان على اعتبار أنها علاقة محبة متبادلة: {يحبُّهم ويحبونه} [المائدة: 54]. لكن قانون المحبة يتحدد بشرط الحرية، فلا معنى للمحبة إلا إنْ كانت عن اختيار حر. لذلك، حرية الإنسان التي منحه الله إياها، هي البعد الأنثروبولوجي المؤسس لكون الإنسان إنسانًا. وهذه قاعدة ستسمح لنا بتأسيس ما أسميه "لاهوت الرحمة الإسلامي"، الذي يسعى لتحرير الإنسان انطلاقًا من مفهوم علاقته بالله، التي تتأسس على "قانون المحبة".
وللحديث بقية…
(تعددية)












