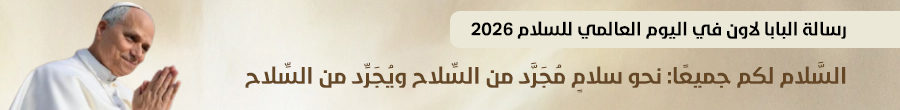موقع أبونا abouna.org - إعلام من أجل الإنسان | يصدر عن المركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام في الأردن - رئيس التحرير: الأب د.رفعت بدر
من لا يحمل صليبه كل يوم ويتبعني فلن يستحقني

الأب منويل بدر - الأردن
الأحد الثالث عشر من زمن السنة (متى 10: 37-42)
البطالة والفراغ بل وعدم الإلتزام بأي واجب هي أعداء السعادة. فكثيرون يجدون حياتهم اليوم فارغة لا معنى لها، لأنّ فرص العمل قليلة، فهم كالجالس قدام بستان جميل كل أشجارة مثمرة تلمع أمام عينيه لكنه لا يستطيع الدخول إليه، إذ يفصله شيك عالٍ، فيصيبه الملل، وبالطّبع الكسل والملل لا يجلبان السّعادة. نجد ذلك خصوصا عند الشبيبة العاطلة عن العمل، وهي نسبة كبيرة في كثير من البلدان الغير صناعية، فهي، وإن كانت في رفاهيةٍ ما لها سابق، إلاّ أنّها غير سعيدة، إذ ينقصها قدوةٌ نموذجيّة مثاليّة، تسير قدّامها، نعم ينقصها الإلتزام للوصول إلى هدف واضح، يُحمِّسها للإستفادة من حيويّةٍ فيها، ضائعة سدىً. وهي قادرة على تحدّي وتحمل مسؤولية للمستقبل. إذ بدون مسؤولية والتزام، يغيب الفرح عن الحياة. الشبيبة تحتاج إلى أي التزام، إلى قيم إيجابية تفهمُها، فتُضحّي بمؤهلاتها ومواهبها لحمايتها. إلى جانب البطالة، التي ليس لها مكان في الكنيسة، هناك وظائف تتطلّب الإلتزام والجدّية. هذه الإلتزامات هي ليست دائما عملا يدويّاً، وإنّما أيضا أدبيّاً. في إنجيل اليوم يعطينا يسوع حلاّ للإلتزام في حياتنا. فنحن نفهم من كلامه أنّ هناك شروطا، تبدو قاسية، وليست على ذوق من يريد أن يؤمن به ويتبعه. مثلا الوصية الرابعة تقول: أكرم أباك وأُمّك، كي يطول عمرُك. لكن ماذا يطلب منا يسوع اليوم؟ من أحبّ ابا أو أمّا أكثر مني فلن يستحقني. هل هو يا تٌرى رمى هذه الوصية بعرض الحائط وغيَّرها أو ألغاها، بعباراته القاسية، كما سمنعنا؟ هو الذي قال: ما أتيت لأنقض بل لأُتمّم(متى 5: 17). لكن مهلاً، فهو وإنْ ظهر لأوّل وهلة، أنه يلغي بعض الوصايا، كما نفهم، لكنّه في الواقع لا يُبطِلُ أيّةَ منها، بل يضع حدوداّ وأولوِيّات، لبعض التّصرُّفات المطلوبة، حينما يصير الحديث عن الواجبات المهمّة لملكوته. فهو يطلب المشاركة مئة بالمئة وليس فقط حصّة بسيطة 2 أو 3 بالمئة من وقتنا. أهم شيء لنا هو حمل الصّليب أي جميع ما تجلب لنا الحياة من معاكسات، والسَّيْر وراءه، لأن الصليب ما عاد قصاصاً، منذ قَبِلَ به هو ومات عليه. "إنّ كلمة الصّليب عند الهالكين جهالة، وأمّا عندنا نحن المُخلَّصين، فهي قوّة الله" (1 كور 1: 18).
من يمشي في الشّوارع، أيام العُطَلِ والأعياد أو خاصّة قبل الإنتخابات، فهو يتعجّب من كثرة الدِّعايات وبرامج المرشّحين، وهي كلُّها وعود وعروض غير ملزمة، أكثرُها مديح وتبجيل للمرشَّح، إن نجح، وما سيقوم به للمصلحة العامّة، كلُّ ذلك محدود وغيرُ مُلزِم. أمّا يسوع فيعطي في إنجيل اليوم مواصفاتٍ جدّيةً حازمةً ملزمة، لكلِّ من يُريد أن يتبعه. من يتبعها يصل سالما، كالسّائق إن حافظ على نظام السير فسيرجع سالما إلى البيت. يسوع، قال عنه سمعان: سيكون نورا ولكن أيضا حجر عثرة للكثيرين.
والسّؤال الآن: لماذا وصل يسوع لإقناع أتباع أكثر بكثير، من أي منافس أو سياسي أو ثائر آخر، رغم أن الإلتزامات التي يطلبها ليست بالهينة، بل جذرية؟ أعتقد للسبب التالي: في آخر الستّينات من القرن الماضي كانت ثورة فيدل كاسترو Fidel Castro في الأرجنتين من أشهر الثورات ضد منافسه تشي جيفارا. أمّا تشي جيفارا فلكي يكسب أتباعا بكونه مسيحيًا، وبلاده كلُّها مسيحيّة، فقد قدّم يسوع على اللّافطات الدِّعائيّة، بصورة ثائر، ببدلة عسكرية وبسلاح الثورة في يده. لكن ذلك لم ينفعه. وقد شوّه سمعة يسوع، إن صحّ التعبير، إذ قد فهم خطأً من هو يسوع. إذن ما من سياسي أو مُصلٍح، باستطاعه أن يُقدِّم مبادئ جذابه تفوق على ما فدّمه يسوع لتغيير العالم.
هذا أيضا لم يفهمه الشعب المختار في زمان يسوع في أرض الميعاد، التي كانت مستعمرة رومانية مُنهَكَة من كلِّ النّواحي، وكان الشعب بانتظار مُحرِّرٍ سياسيّ، بسلاح وثورة عسكرية، لكنّه خيّب أمالهم، بحيث تصرّف بعكس رغبتهم، بل وألزمهم بدفع الجزية للحاكم المستعمر، الّذي يُؤدّي لهم خدمات اجتماعية، وإذ لم يُعجبهم ذلك، ثاروا عليه وطلبوا موته، حتى من المستعمِر، الّذي كانوا راضخين تحت حكمه ، لأنه ما كان يحق لهم إصدارُ أيِّ حكم إعدام بأحد، لئلا تظنَّ السلطة الحاكمة أنهم سلطة ٌ داخل السلطة.
يسوع أفهمهم، أنه لا هو مَلِك ولا هو ثائر مٌقاوِم حزبٍ أو سياسة، إنّ أتباعكم كانوا في الهيكل وكانوا يسمعون ما كنت أتكلّم به، إنما مقاوم للشرّ المتسلّط على قلوب البشر. هو ليس ثائراً كثوّار هذا العالم، حيث يطلبون من أتباعهم أكثر ممّا يطلبون من أنفسهم. هم يعيشون في سراديب وخنادق محصّنة، بينما يرسلون أتباعهم إلى حيث تترقَّبُهم المخاطر والمجازفة بالحياة.، ليموتوا دفاعا عن مُرسِليهم، لا العكس. يسوع لم يطلب شيئا أخطر أو أثقل أو أكبر من أتباعه، ممّا طلبه من نفسه، بل حذّرهم ممّا سيحِلُّ بهم: كما اضطهدوني، فهم سيضطهدونكم. نعم هو يطلب من أتباعه أن يحملوا صليبهم، وإن لزمَ أن يُضحّوا بحياتهم عمّن يُحبّون، لكن مِن بعد ما هو حمل أثقل صليب على أكتافه، وضحّى بحياته عنّا جميعاً، "إذ ليس لأحدٍ حبٌّ أعظم من أن يموت لأجل أحبّائه". يسوع لم يفرض على أتباعه أكثر ممّا فرض على نفسه "إنه لا يُجرِّبنا فوق طاقتنا" يقول بولس وإن جرّبنا فهو يضع نعمته تحت تصرُّفنا لنقاوم بها الشرّ وننتصر.
ممّا نكتشفه في تعليم يسوع إذن هو أولويّات، لكن، من يفتكر اليوم بأولوية الحفاظ على وصايا الله في حياته؟ إنّ عالمنا وزماننا قد تودّعا من كل وصايا الدّين، وما عاد مكان في مجتمعنا للوعظ بالحرمان من أجل الله وملكوته. ومن يريد أن يحامي عن الإيمان والأخلاق، يصبح عرضة للضحك والإستهزاء والإتهام بالرجعية. الحياة العامة قائمة اليوم على الملذّات الدنوية واللامبالاة بالدّين، بل وغارقة في العولمة، كأنّ لا مكان فيها لله، هذا ما قاله مراراً البابا فرنسيس. هكذا عالم يسمّيه كتاب الإشتراع: القفر (أي الصحراء) العظيم المخيف (تثنية 8: 15).
إن البشر اليوم يعيشون في ازدهار ورفاهية ماديّة، لا مكان فيها لله. مَن يتجاسر منّا اليوم أن يقول علنا: الله والدّين هما كلُّ شيءٍ لي؟. ومن يسأل اليوم: ماذا علي أن أعمل لأرث الملكوت؟ بينما البشر، الّذين كانوا يسمعون أقوال وتعليم يسوع، فكانوا يهتمّون بهذه السّؤالات الدينية ويتجادلون فيها (ذكر الطلاق، الزنى، مغفرة الخطايا...) كان هَمُّ الكثيرين: ماذا علينا أن نعمل لنعود إلى الفردوس المفقود. كانوا يحافظون، ليس فقط على العشر وصايا بل وعلى ال 614 وصيّة إضافية، التي أوجدها رؤساء الدين، لمراقبة حياة الشّعب اليوميّة، كي يحصلوا بالتالي على كرسي مع أبيهم إبراهيم. كثيرون يفكّرون اليوم طويلا قبل أن يسألوا سؤالا عن الدّين بل ويعتريهُمُ الخجل حينما يسألون. آخَرون يفتكرون أن الإيمان هو فقط صوم وصلاة وحرمانات، وأنّ على الإنسان أن يعيش كملاك، بدون جنحان على الأرض.
هذه أفكار كلّها خاطئة. المسيحي كغير المسيحي، عليه واجبات، يجب فقط تأديتُها بإخلاص ونيّة صالحة، وأن يكون مسالما مسامحا مستعدّا للوقوف إلى جانب المتضايق والمريض والمسجون والحزين.... من يدخل إلى السّماء؟ كان أحد الأسئلة الموجّهة إلى يسوع، فكان جوابه: من يُعطي ولو كوب ماء لعطشان، ينال الحياة الأبدبة! يفهم هذا فقط، من يعيش في الصحراء، حيث لا وديان ولا نبع ماء متوفِّرة إلاّ نادراً، أو من يساعد محتاجا: الحقَّ أقول لكم، إنَّ أَجرهُ لن يضيع! إذهب واعمل كذلك. فكل عمل نقوم به كتلاميذ ليسوع، لن يضيع أجرُه. إعطاءُ حسنة لملجأ عجزة أو بيت يتامي، أو القبام بأيّة خدمةٍ اجتماعية، كلُّ ذلك له قيمته عند الله، إذ كل ما فعلتموه لأحدِ هؤلاءِ الصّغار، فلي فعلتموه، تعالوا، رثوا الملك المُعّدَّ لكم منذ إنشاء العالم.
أيها المسيحي! لا تظن أن هذه الأعمال التي يمكن أن تستحق فيها السّماء هي أعمال مستحيلة أو مُخجلة. فالعالم ليس قائما فقط على الأعمال الكبيرة المثيرة. متّى يحاول أن يُقنع سامعيه وقرّاءه، أن يسوع هو ابن الله، المخلّص المنتظر. هذا ويبرهن لهم عن ذلك، بجلب أنظارهم إلى صبغتين جديدتين مع يسوع: أوّلا عجائبه، إذ العجائب لا تتم إلاّ باصبع الله، وليس بقوة زبول رئيس الشياطين. وثانيا بالتعليم الجديد الذي يعلّم ."ما هذا؟ إنّه لتعليم جديد يُلقى بسلطان(مر 1: 27) بعكس رؤسائهم، الّذين كانوا فقط يحكمون الشعب بالوصايا والأوامر. لذا كان السامعون يتهافتون لسماعه من كل القرى والمدن وينسون أن يأكلوا ويشربوا، لانشغافهم بكلامه الشيّق. فهل نُحن معجبون بما نسمع عنه ومنه؟ تعليمه جديد إذ فيه الإلتزام بواجبات يوميّة: من أراد أن يكون لي تلميذاً، فليحملْ صليبَه كلَّ يوم ويتبعني". إحملوا نيري عليكم وتعلّموا منّي، لأنّي وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لأنفسكم. لأنّ نيري ليّن وحملي خفيف(متى 11. 28).
بهذا المعنى نقدر أن نصلي يوم الجمعة الحزينة بكلمات الكنيسة: يا صليب يسوع! أنت السّلم الأكيد، عليه نصعد إلى الحياة، التي يعطيها الله دائما. أنت الجسر القوي، الذي عليه يعبر سالما، مَن وقع في غرق. أنت عصاة الحاجّ، التي عليها نتوكأ ولا نسقط. أنت مفتاح السّلام، به تَفتح لنا الباب إلى الحياة، التي أنت تعطيها.
من يعطينا الصليب لنحمله يعطينا أيضا النعمة كي لا نقع تحته. ومهما كان ثقيلا فهو ما عاد يُخيف، إذ شرح لنا يسوع نفسه معناه.
يُحكى أنّ سائحا مرّ على نخلة لا تزال في بداية نُمُوِّها كانت مغروسة في نهر ماء، فحسدها عابرُ السبيل وصمّم أن يجعلها تموت، إذ وضع صخرة كبيرة بين فروعها جعلها ترزح تحت ثقلها وتميل، فقال فرِحاً لنفسه: لن يمضي عليها وقت طويل حتى تخور قواها تحت ثقل الصخرة فتخرج جذورها من الماء وتموت. قال هذا وتابع طريقه. أما شجرة النخيل، فلمّا شعرتْ بالحمل الثقيل بين أغصانها، قد شدّدتْ قِواها، وتمايلت يمينا ويسارا حتى تسقط الصخرة من بين فروعها، لكن الصخرة كانت أثقل ممّا افتَكَرت، وظلّت في مكانها، لذا قالت لنفسها: تشجعي يا نفسي ولا تيأسي. ثمَّ وضعت كلَّ قوّتِها في شروشها في الماء، فتعمّقت في الأرض وصارت قادرة على تحمل الصخرة وراحت تنمو ألى فوق وكثرت فروعها التي نمت في العلو وصارت شجرة كبيرة قوية.
بعد سنين مرّ عابر السبيل نفس الطّريق وفطن لِما عمله بالنخلة الضعيفة الصغيرة، فخطر على باله أن يشاهد، ماذا حدث لها، إن كانت لا تزال هناك. فتّش عنها لكنّه لم يعرفها، فافتكر أن صاحب البستان غرس نخلة جديدة مكانها، إذ ما كان يرى إلا شجر نخيل كبير. فنادته النخلة، التي ما زالت في مكانها وسألته: ألم تعد تعرفني بعد؟ إني شاكرة لك أن حملك من فوق قد قوّاني في أصولي.
نعم منذ حمل يسوع صليبه الثقيل على أكتافه، فقدْ فَقَدَ صليبُنا لا ثقله بل حماقته، أي ما عاد عارا، لأنّ الله بحكمته قد أراد أن يخلص البشر بعلامة الخزي والعار والجهالة، أي بالصّليب، فأصبح علامة الفخر لنا نحن أتباعه وتلاميذه. لقد أصبح فعلا سُلَّمَ النجاة، كسلّم يعقوب، الذي عليه نصعد إلى فوق، إلى السماء. نعم بالصّليب الّذي نموت مصلوبين عليه، صار خلاصنا أكيداً. بالصليب والتضحية يتأكد الخلاص: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فلن تأتي بثمر. على جبال كثيرة في أوروبا والعالم نلاقي مزارات كثيرة لصلبان يسوع مرتفعة أصبحت كإشارات اتجاه للمارّين من تحتها. نعم قوتنا هي في يسوع، الذي يقودنا من وديان حياتنا إلى القمّة حيث نرى الله في صليبنا. نعم بواسطة الصليب والألم وصل يسوع إلى مجد القيامة، التي إليها أيضا يقدر أن يقودنا. نسجد لك أيَّها المسيح ونباركك، لأنّك بصليبك المُقدّسَ قد خلَّصت العالم. آمين